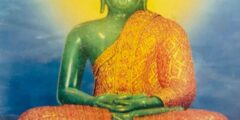ورقة سريعة مقدّمة للمؤتمر الدّوليّ حول تشريعات سنّ الزّواج في الدّول الإسلاميّة، أفضل الممارسات والتّوجه المستقبليّ لباكستان، 22-23 أبريل 2025م، تنظيم: منظمة بودا، إسلام أباد – باكستان.
التّعريف بعمان:
سلطنة عُمان دولة لها تأريخها العريق، وامتدادها قديما إلى شرق أفريقيا جنوبا، وإلى بعض الأجزاء الجنوبيّة في إيران شمالا، كما وصل البحارة والتّجّار العمانيون قديما إلى الصّين وشرق آسيا وبلاد السّند منذ فترة مبكرة، وكانت لهم علاقة تجاريّة مع حضارات بلاد السّند وما وراء النّهر والحضارة المصريّة القديمة، ولهذا اختلط العمانيون منذ فترة مبكرة بأجناس مختلفة، تعايشوا وتزاوجوا معها، ممّا شكّل لوحة ثقافيّة متباينة ومتعدّدة في عُمان، فهناك لغات مختلفة، من الكمزاريّة والشّحريّة والمهريّة والبطحريّة والحرسوسيّة والبلوشيّة والأورديّة والفارسيّة والهنديّة السّنديّة وغيرها، بجانب اللّغة العربيّة الأم، وهي اللّغة الجامعة بين الكل، وهناك أيضا لهجات متباينة ومتعدّدة في عمان داخل اللّغة العربيّة نفسها، لها جماليّتها الصّوتيّة، ولها خصوصيّاتها المعجميّة، كما شكّلت لوحة من التّعدّديّة الثّقافيّة في العادات والتّقاليد، بما فيها الفنون المختلفة، المرتبطة بالأفراح والأعراس والمواسم الدّينيّة وسفر البحر والحجّ ومواسم الأعياد وغناء الأطفال والرّكبان، فضلا عن التّعدّدية في الملبوسات والمطعومات وبعض طرق الحياة وتقاليدها.
كما “وجدت في عمان تيارات فقهيّة كالإباضيّة ثمّ المذاهب السّنيّة، وغالب السّنّة شوافع فقها، ثم بنسبة أقل الأحناف، يليهم بدرجات قليلة من الحنابلة، والأغلبيّة من السّنّة قديما غلب عليهم التّصوف، فكانت الزّوايا الصّوفيّة منتشرة عند الشّوافع خصوصا، إلا أنّها قلّت حاليا، ومال بعضّ السّنّة إلى السّلفيّة، كذلك يوجد الشّيعة الإماميّة وهم منتشرون كأقليّة على السّاحل كمطرح وبعض سواحل الباطنة، وهناك بسبب التّجارة كان البانيان (الهندوس) والزّرادشتيّة (المجوس) بنسب قليلة، كما وجد أيضا اليهود إلى فترات متأخرة جدا”[1]، وبسبب التّجارة حاليا وجد البوذيون والمسيحيون والسيخ وأفراد من البهائيّة والأحمديّة.
وعُمان ذات ساحل بحريّ، وامتداد جبليّ ضمن سلسلة جبال حجر عمان، بجانب صحراء الرّبع الخاليّ، وتمتد سواحلها على مسافة 3165 كلم، من مضيق هرمز شمالا، وحتّى حدود اليمن جنوبا، ومع هذا عمان قليلة عدد السّكان، ووصلوا حاليا مع المقيمين فيها من غيرها إلى حوالي خمسة ملايين نسمة، يشكل العمانيون حوالي ثلاثة ملايين نسمة، ونسبة الذّكور أعلى من نسبة الإناث، وعمان شعبها فتي، أغلب سكّانها أقل من أربعين سنة، وعاصمتها مسقط، وحكمها سلطانيّ وراثيّ، وبدأت نهضتها الإصلاحيّة الجديدة عام 1970م.
وضع المرأة في عُمان:
منذ عام 1970م حاولت الدّولة معالجة وضع المرأة في عمان، ابتداء من إشراكها في المجتمع، وحقّها في العمل، واستقلالها في قراراتها، واستقلالها المادي، ونصّ القانون الأساسيّ على المساواة بين المرأة والرّجل، في كلّ جوانب الحياة، بما في ذلك التّعليم والصّحة والعمل، وحقّها في مجلس الشّورى (البرلمان)، وقد استطاعت المرأة أن تتولى العديد من الحقائب الوزارية، فضلا عن إدارة الشّؤون الإداريّة والثّقافيّة وغيرها، كما أصبحت المرأة قادرة على أن تمثل بلدها كسفيرة، واليوم وبعد خمسين عاما تطبّع المجتمع بهذه المساواة، وإن كانت هناك لا زالت توجد بعض التّحدّيات بسبب بعض العادات الاجتماعيّة، والرّؤى الفقهيّة الظّرفيّة، لكنّها أقل من السّابق بكثير جدّا، كما أنّ عمان وقعت على اتّفاقيّة سيداو القائمة على القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة، والّتي أقرت في الأمم المتحدة في ديسمبر 1979م، وإن كان هناك تحفظ على بعض بنودها، لكنّها في الجملة مقرّة بما فيها من عناصر المساوة، وإقرار حقوق المرأة.
معالجة قضايا زواج المرأة في عُمان:
تنصّ المادّة (5) من قانون الأحوال الشّخصيّة في عُمان أنّ “الزّواج عقد شرعيّ بين رجل وامرأة، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزّوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة”[2]، وفي المادّة (15) أنّ الزّوجين “هما أيّ رجل وامرأة يصح أن يتزوّج كلّ منهما الآخر إذا انتفت الموانع الشرعيّة”[3]، وفي المادّة (17) تنصّ أنّه مع “مراعاة أحكام المادّة (۱۹) من هذا القانون ينعقد الزّواج بإيجاب من أحد المتعاقدين، وقبول من الآخر، صادرين عن رضا تام بألفاظ تفيد معناه لغة أو عرفا، وفي حال العجز عن النّطق، تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذّرت فبالإشارة المفهومة”[4]، والمادّة (19) تنصّ أنّه “يتولى ولي الأمر عقد زواجها برضاها”[5].
والحقيقة أنّ الوضع الفقهيّ من حيث أصالة النّصوص القرآنيّة، ووفق استقلاليّة المرأة، واعتبارها إنسانا كاملا مستقلّا؛ نجد في الأدبيات الفقهيّة ما يحفظ حقّ المرأة في الزّواج والحضانة والأمومة وغيرها، ومنها تقرير الفقهاء أنّه “حرام تزويج النّساء كرها”[6]، مع حرمة عضل المرأة، وتحريم العديد من أنكحة الجاهلية المضرّة بالمرأة.
لكن لا يعني هذا مع تقادم الزّمن عدم وجود اجتهادات فقهيّة قيّدت حقوق المرأة، كما وجدت من العادات الّتي أثرت سلبا على حقوق المرأة أيضا، ومنها في الزّواج، لهذا جاءت التّشريعات القانونيّة المعاصرة في عُمان في معالجة هذه القضايا الفقهيّة، وفي تقرير حقوق المرأة بسلطة القانون، لتتهذّب هذه العادات والقوانين، كما يتمّ مراجعة الجوانب الفقهيّة بما يتناسب مع الواقع المعاصر، ولهذا قنّنت موضوع الوليّ في الزّواج مثلا، وأنّه لا يتعدّى الجانب التّنظيميّ، وليس جانبا سلطويّا مطلقا، وفتحت للمرأة التّقاضي للمطالبة بحقوقها القانونيّة من خلال لجنة التّوفيق والمصالحة، واللّجنة نافذة قانونيّا كحكم القاضي، ولها قانونها المستقلّ الّذي صدر عام 2005م، ومن جوانب غاياته تنفيذ حقوق المرأة فيما يتعلّق بأحوالها الشّخصيّة والتّجاريّة والوظيفيّة.
مراجعة قانون سنّ الزّواج في عمان:
من المسائل الّتي تمّت مراجعتها والمتّعلّقة بالزّواج مراجعة سنّ الزّواج ذاته، وهي رؤية نادى بها حتّى الفقهاء والمفكرين المسلمين العرب منذ فترة مبكرة، ومن هؤلاء مثلا المفكّر والأديب المغربيّ علال الفاسيّ (ت: 1974م)، كما في كتابه “النّقد الذّاتيّ”، والّذي انطلق من “أنّ تحسين حالة المرأة وإسعادها يجب أن ينال حظّا مهمّا من تفكيرنا الاجتماعيّ؛ لأنّه شرط أساسي لإصلاح المجتمع”[7]، ويرى “أنّه من أشنع مظاهر الإجبار الّتي ما نزال نحتفظ بها في بعض بلداننا المتحضّرة … تزويج الصّغيرات، أو الوعد بتزويجهنّ، ثمّ إنجازه بعد أزمان، فلا تصل البنت لدرجة البلوغ حتّى تجد أولياءها قد سلّموها لخطيب أكبر منها بكثير في الغالب، ونحن نعتقد أنّه إذا كان للاعتبارات الّتي بنيت عليها هذه العادة محلّ في الأجيال الماضية، فإنّ من الواجب على الجيل الجديد أن يتحرّر منها، وأن لا يشجّعها؛ لأنّ هنالك فرقا عظيما بين البنت في سنيها الأولى من الحياة، وبينها حين تصبح امرأة قادرة على الاختيار”[8]، وخلص إلى أهميّة وجود قانون يحمي المرأة ولا يترك ذلك عائما بدون تقنين، لأنّه في نظره “إذا كنّا نستنكر تزويج الصّغيرات وإجبارهنّ فهل من المصلحة أن نكتفي في هذا الباب بمجرد الوعظ والتّنبيه معتمدين على ضمائر النّاس وامتثالهم، أو الأوفق أن نؤيد ذلك بتحديد قانونيّ يندرج تحت أصل شرعيّ هو مصلحة المرأة العامّة ومصلحة الأسرة من حيث هي، إنّ أغلب الأم المتمدنة تأخذ اليوم بالنّظرية الثّانية؛ لأنّ للقانون سلطانا ليس لغيره من وسائل الإقناع”[9].
وهذا ما عملت به عُمان، ومع أنّ الرّؤية الفقهيّة في عُمان أقرّت في التّراث العمانيّ مثلا “أنّ تزويج الصّبيان كلّه موقوف إلى بلوغ الصّبيّ من الزّوجين، كانا جميعا صبيين، أو أحدهما زوّج الصّبيّ أبوه، أو سائر أوليائه، فإن بلغ الصّبيّ من الزّوجين فأتمّ التّزويج تم، وإن كرهه انفسخ”[10]، ويوجد في التّراث الفقهيّ العمانيّ أيضا أنّه “يوجد في بعض القول: إنّ تزويج الصّبيان لا يثبت ولو أتمّوه بعد البلوغ، كان التّزويج من صبي بصبيّة، أو من بالغ بصبيّة، أو صبيّة ببالغ، أو بالغة بصبيّ، فذلك باطل، ولا يقع بتلك العقدة قبل البلوغ أحكام التّزويج، حتّى يكون التّزويج بعد بلوغهما”[11]، بيد أنّهم اختلفوا في البلوغ أهو بظهور علاماته، أو باشتهاء النّكاح، تقدّم السّنّ أم تأخر، أم بالسّنّ، ومال بعضهم إلى سنّ التّاسعة للمرأة.
وقد تركت عُمان في الابتداء وفق نهضتها الإصلاحيّة المعاصرة تقديرَ المصلحة في قضيّة التّزويج إلى ولي الأمر أو القاضي حتّى يتّم استيعاب تقبل جميع حقوق المرأة واستقلاليّتها -كما أسلفتُ-، ثمّ في بداية التّسعينات من القرن العشرين الميلاديّ وضعت لجنة من قبل الحكومة “ضمّت عدّة جهات رسميّة في الدّولة، متمثلة في وزارة العدل والأوقاف والشّؤون الإسلاميّة[12]، ووزارة الدّاخليّة، ووزارة الشّؤون الاجتماعيّة، ووزارة العمل، ووزارة الشّؤون القانونيّة”[13]، غايتها النّظر في موضوع الزّواج، ومنه سنّ الزّواج، خصوصا وأنّ عمان انضمّت لاحقا إلى اتّفاقيّة حقوق الطّفل في يونيو 1996م بموجب المرسوم السّلطانيّ رقم (45/96م)[14]، لهذا رأت أنّ الوقت حان لإصدار قانون يعنى بالأحوال الشّخصيّة، “وقد استغرق إعداد هذا القانون ثلاث سنوات متواصلة”[15]، “وانطلق في صياغة مواده من وثيقة مسقط للنّظام القانونيّ الاسترشاديّ الموحد للأحوال الشّخصيّة بدول مجلس التّعاون لدول الخليج العربيّة”[16]، ليصدر وفق “المرسوم السّلطانيّ رقم (32/97م) في 28 محرّم سنة 1418هـ، الموافق 4 من يونيو 1997م، والّذي يشتمل على (282) مادّة تعالج الأحكام المتعلّقة بالأسرة، وهي الّتي تبدأ برابطة الزّواج وما يسبقها من مقدّمات كالخطبة، وما يترتب عليها من أحكام كحقوق الزّوجين والأبناء ونحوها، وتنتهي بالفرقة وما يترتب عليها من آثار، وأحكام كالعدّة والحضانة والأهليّة والولاية والوصيّة والميراث”[17].
ومن هذه المسائل الّتي عالجها قانون الأحوال الشّخصيّة في عُمان قضيّة سنّ الزّواج، وقرّر في المادّة (7) أنّه “تكمن أهلية الزّواج بالعقل، وإتمام الثّامنة عشرة من العمر”[18]، وبيّن في المادّة (10) أنّه “لا يزوج من لم يكمل الثّامنة عشره من عمره إلّا بإذن القاضي، وبعد التّحقّق من المصلحة”[19]، ومن بلغت الثّامنة عشرة وأرادت الزّواج، لا يحقّ للوليّ عضلها، وفق المادّة نفسها “إذا طلب من أكمل الثّامنة عشرة من عمره الزّواج وامتنع وليه عن تزويجه؛ جاز له رفع الأمر إلى القاضي”[20]، ووفق قانون الأحوال المدنيّة في المادّة (41)”كلّ شخص يبلغ سنّ الرّشد متمتعا بقواه العقليّة، ولم يحجر عليه؛ يكون كامل الأهليّة لمباشرة حقوقه المدنيّة”[21]، بما في ذلك الزّواج، ونصّ القانون ذاته أنّ “سنّ الرّشد إتمام الثّامنة عشرة من العمر”[22].
وعليه حدّد سن الزواج بذات سنّ الرّشد أي الثّامنة عشرة، وربط الزّواج بكامل الأهليّة فيخرج فاقد الأهليّة، أي الّذي كان قبل سنّ التّمييز، وحدّده قانون الأحوال المدنيّة في المادّة (42) أنّ “سنّ التّمييز سبع سنين كاملة”[23]، ووفق المادّة نفسها أنّه “لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنيّة من كان فاقد التّمييز لصغر في السّن أو عته أو جنون”[24]، كما يخرج ناقص الأهليّة أيضا، وحدّد قانون الأحوال المدنيّة أيضا ذلك بما دون الثّامنة عشرة وفق المادّة (43) أنّه “كلّ من بلغ سنّ التّمييز ولم يبلغ سنّ الرّشد، وكلّ من بلغ سنّ الرّشد، وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهليّة وفقا لما يقرّره القانون”[25]، وبما أنّ الزّواج مرتبط بكامل الأهليّة فقد نصّ قانون الأحوال المدنيّة وفق المادّة (45) أنّه “ليس لأحد النّزول عن حرّيّته الشّخصيّة ولا عن أهليّته أو التّعديل في أحكامها”[26] وجودا أو عدما.
الزّواج وقانون الطّفولة:
بما أنّ سنّ الزّواج مرتبط أيضا بمسألة الطّفولة وحقوقها، وقد أقرّت عمان ميثاق حقوق الطّفل العربيّ عام 1983م[27]، وكما أسلفت سابقا أنّ عمان انضّمت إلى “اتّفاقيّة حقوق الطّفل في يونيو 1996م بموجب المرسوم السّلطانيّ رقم (45/96م)”[28]، وأصدرت لاحقا قانون الطّفل عام 2014م.
وبما أنّ اتّفاقيّة حقوق الطّفل لعام 1989م “هي الوثيقة الدّوليّة الأولى الّتي وضعت مفهوما عامّا وشاملا للطّفل، وللفترة الّتي يحتاج إليها للحماية والرّعاية، حيث نصّت في المادّة الأولى منها على أنّه لأغراض هذه الاتّفاقيّة يعنى الطّفل كلّ إنسان لم يتجاوز الثّامنة عشرة من عمره، ما لم يبلغ سنّ الرّشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”[29]؛ عليه نصّ قانون الطّفل وفق المادّة (1) أنّ “الطّفل كلّ إنسان لم يكمل الثّامنة عشرة من العمر بالتّقويم الميلاديّ”[30]، ونصّت المادّة (7) أنّ “للطّفل الحقّ في الحماية من العنف، والاستغلال، والإساءة، وفي معاملة إنسانيّة كريمة تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه، وتكفل له الدّولة التّمتع بهذا الحقّ بكلّ السّبل المتاحة”[31].
لهذا كانت القوانين متشدّدة فيما يتعلّق بحماية الطّفولة، فمثلا “إنّ جريمة هتك عرض طفل المؤثّمة بنصّ المادّة (۷۲) بدلالة المادة (٥٦ / ب) من قانون الطّفل تتكون من كلّ فعل مُناف للحشمة يرتكبه شخص ضدّ آخر ذكرا كان أو أنثى، ويلحق به عارا يؤذيه في كرامته وعفّته، وهو يعرف أيضا بأنّه الإخلال العمديّ الجسيم بحياء المجنيّ عليه بفعل يرتكب على جسمه، ويمسّ في الغالب عورة فيه وإن لم يترك هذا الفعل أثرًا على جسم المجني عليه، كما تستوجب تلك الجناية توافر قصد جنائي بعنصريه العلم والإرادة فيتحقق القصد الجنائي متى كان الجاني على علم بحقيقة فعله، وأنّه يقوم به بغرض الإخلال بعرض المجني عليه فتنصرف بذلك إرادته إلى الفعل وإحداث النّتيجة، كما أنّه لا يشترط لثبوت تلك الجريمة على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلّة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كلّ ما تطمئن إليه من ظروف الدّعوى وأدلتها وقرائنها”[32].
وبما أنّ قانون الطّفولة على كلّ من هو دون الثّامنة عشرة من العمر، وعليه ينطبق هذا على زواج من هما ذكرا أو أنثى دون هذا العمر، ويكون العمر محدّدا وفق ما ورد في البطاقة الشّخصيّة “إعمالا للمادّة (42) من قانون الأحوال المدنيّة رقم (66/1999) الّتي نصّت على أنّ البطاقة الشّخصيّة تعتبر دليلا على صحة البيانات الواردة بها، ولا يجوز لأيّ جهة حكوميّة أو غيرها علّة ذلك”[33]، وهذا منعا لأيّ دعوى أو تلاعب بمسألة العمر، ولأنّها منضبطة بشكل دقيق وفق قانون الأحوال المدنيّة.
تحدّيات قانون سنّ الزّواج في عمان:
مع أنّ قانون الأحوال الشّخصيّة بما فيه من تحديد سنّ الزّواج قد صدر عام 1997م كما أسلفتُ سلفا، إلّا أنّه لم يعمل ضجّة سلبيّة، ولم يلق اعتراضا في البلد، لا على المستوى الدّينيّ والفقهيّ، ولا على المستوى الاجتماعيّ من حيث القبيلة، ولا على مستوى العقل الجمعيّ، فكان الجميع مدركا للأضرار النّفسيّة والاجتماعيّة والصّحيّة المترتبة على الزّواج المبكر، وأهميّة التّأهل العقليّ والنّفسيّ والماديّ لإقامة أسرة ناضجة ومتكاملة.
وعلى المستوى الدّينيّ والفقهيّ، فقد كان الجميع حاضرا على مستوى المذاهب الفقهيّة في عمان لصياغة قانون الأحوال الشّخصيّة، “ولم يتقيّد القانون العمانيّ في أحكامه بمذهب فقهيّ معيّن، بل درج في اختيار الأقوال ما هو أيسر وأوفى بالحاجة ومقتضيات مصلحة المجتمع”[34].
وإذا جمعنا جميع ما سبق، خصوصا بين قانون الأحوال الشّخصيّة وقانون الطّفل من جهة، وبين قانون الأحوال المدنيّة، والقوانين المتعلّقة بالمرأة من جهة ثانيّة، الأصل أننا ندرك أنّه ينطبق على هذا المادّة رقم (46)والمتمثلة في “لكلّ من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حقّ من الحقوق اللّازمة لشخصيّته أن يطلب وقف هذا الاعتداء، وله التّعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر”[35]؛ ينطبق على من زوّج قبل السّنّ القانونيّة المقرّرة، أو أرغم على الزّواج بعدها دون اختيار ورغبة منه، أو أكره على زواج من لا يرغب له، ولا يسكن إليه، ونصّت المادّة رقم (154) من قانون الأحوال الشّخصيّة أنّ “للقاصر بعد رشده، أو ترشيده، أن يطلب تعويضا عن تصرّفات وصيّه الضّارة، الواقعة قبل ذلك كلّا أو بعضا ولو أبرأه إبراء عامّا، مع إمكان مساءلته جزائيّا عند الاقتضاء”[36]، وفي المادّة نفسها أنّه “يسقط هذا الحقّ بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده أو ترشيده”[37].
بيد أنّ المادّة (10) من قانون الأحوال الشّخصيّة والّتي تنصّ على أنّه “لا يزوج من لم يكمل الثّامنة عشره من عمره إلّا بإذن القاضي، وبعد التّحقّق من المصلحة”[38] تحدث شيئا من الفراغ غير المنضبط في ذاته حول عموميّة ترشيد القاضي، مع أنّ هذا الفراغ أحكم بالنّسبة للكاتب بالعدل، أو من يقوم بتوثيق العقود، فلا يمكن بحال أن يستثني أحدا أو يرشده، ويتحمل المساءلة القانونيّة، بيد أنّ تعليق المصلحة للقاضي بدون ضوابط تقنينيّة حال الاستثناءات، قد تتسع في جوانب يلحق ضررها بغير البالغ، وقد تكون استجابة غير البالغ لأسباب تغريريّة من الوليّ، مستغلّا ضعف رشده، ثمّ لا توجد هناك قوانين محدّدة كعقوبات متعلّقة بالوليّ حال تزويجه لمن لم يبلغ السّنّ القانونيّة، ولعلّ هذا الفراغ هي مرحلة لتدرج تقبل المجتمع حينها، وبما أنّ الواقع اليوم متقبل في جملته فينبغي تحديد ذلك بمواد واضحة ومقنّنة.
ومع هذا في نظري تحديد المادّة القانونيّة للزّواج بالثّامنة عشرة من قبل قانون الأحوال الشّخصيّة، واعتبار الرّشد مرتبطا بالسّنّ ذاته، وربط ذلك بقانون الأحوال المدنيّة، وقانون الطّفولة، حالة جيّدة ومتقدّمة جدّا، أمام وعيّ أصبح الجميع مدركا لأهميّة ذلك.
[1] العبريّ: بدر، إضاءة قلم: التّعايش تأملات ومذكرات؛ ط الجمعيّة العمانيّة للكتّاب والأدباء – سلطنة عمان، ودار مسعى – كندا، الطّبعة الأولى، 2019م، ص: 15. بتصرّف بسيط.
[2] مجموعة التّشريعات القضائيّة واللّوائح المنظمة لها، المجلّد الثّانيّ، الجزء الثّاني، ط مجلس الشّؤون الإداريّة للقضاء، المحكمة العليا، المكتب الفنيّ، 1437هـ/ 2016م، ص: 210.
[3] نفسه؛ ص: 213.
[4] نفسه؛ ص: 214.
[6] الشّقصيّ: خميس بن سعيد، منهج الطّالبين وبلاغ الرّاغبين؛ ط مكتبة مسقط، عمان – مسقط، الطّبعة الأولى، 1427هـ/ 2006م، ج: 7، ص: 432.
[7] الفاسي: علال، النّقد الذّاتيّ؛ المطبعة العالميّة، القاهرة – مصر، الطّبعة الأولى، 1951م، ص: 265.
[8] نفسه؛ ص: 265.
[9] نفسه؛ ص: 266 – 267.
[10] الشّقصيّ: خميس بن سعيد، منهج الطّالبين وبلاغ الرّاغبين؛ سابق، ج: 7، ص: 659.
[11] نفسه؛ ج: 7، ص: 659.
[12] في 1997م انفصلت وزارة العدل عن وزارة الأوقاف، وسميت الثّانية بوزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيّة.
[13] العزريّة: مريم بنت سعيد بن حمد، التّفريق القضائيّ بين الزّوجين للضّرر: دراسة فقهيّة مقارنة بقانون الأحوال الشّخصيّة العمانيّ؛ ط مكتبة الدّراسات العربيّة، سلطنة عمان، ط 2022م، ص: 58.
[14] الفزاريّ: محمّد بن عبد الله بن إسماعيل، ضمانات حماية حقوق الطّفل في ضوء قواعد القانون الدّوليّ والتّشريع الوطنيّ؛ ط اللّجنة العمانيّة لحقوق الإنسان، 2013م، ص: 102.
[15] العزريّة: مريم بنت سعيد بن حمد، التّفريق القضائيّ بين الزّوجين للضّرر؛ سابق، ص: 58.
[16] نفسه؛ ص: 58. بتصرّف بسيط.
[17] نفسه؛ ص: 57 – 58.
[18] مجموعة التّشريعات القضائيّة واللّوائح المنظمة لها؛ سابق، المجلّد الثّانيّ، الجزء الثّاني، ص: 210.
[19] نفسه؛ المجلّد الثّانيّ، الجزء الثّاني، ص: 211.
[20] نفسه؛ المجلّد الثّانيّ، الجزء الثّاني، ص: 211.
[21] نفسه؛ المجلّد الثّانيّ، الجزء الأول، ص: 44.
[22] نفسه؛ المجلّد الثّانيّ، الجزء الأول، ص: 44.
[23] نفسه؛ المجلّد الثّانيّ، الجزء الأول، ص: 44.
[24] نفسه؛ المجلّد الثّانيّ، الجزء الأول، ص: 44.
[25] نفسه؛ المجلّد الثّانيّ، الجزء الأول، ص: 44.
[26] نفسه؛ المجلّد الثّانيّ، الجزء الأول، ص: 45.
[27] الفزاريّ: محمّد بن عبد الله بن إسماعيل، ضمانات حماية حقوق الطّفل في ضوء قواعد القانون الدّوليّ والتّشريع الوطنيّ؛ سابق، ص: 102.
[28] نفسه؛ ص: 102.
[29] نفسه؛ ص: 16.
[30] موسوعة القوانين الجزائيّة؛ ط شرطة عمان السّلطانيّة، الطّبعة الثّانية، 1436هـ/ 2015م، ص: 405.
[31] نفسه؛ ص: 106.
[32] مجموعة المبادئ والقواعد القانونيّة الّتي قرّرتها المحكمة العليا من الفترة 2011م وحتّى 2020م: الدّائرة الجزائيّة؛ المجموعة التّشريعيّة الثّانية، ط المجلس الأعلى للقضاء – المكتب الفنيّ، سلطنة عمان، ص: 372.
[33] نفسه؛ ص: 206 – 207.
[34] العزريّة: مريم بنت سعيد بن حمد، التّفريق القضائيّ بين الزّوجين للضّرر؛ سابق، ص: 59.
[35] مجموعة التّشريعات القضائيّة واللّوائح المنظمة لها؛ سابق، المجلّد الثّانيّ، الجزء الأول، ص: 45.
[36] نفسه؛ المجلّد الثّانيّ، الجزء الثّاني، ص: 256.
[37] نفسه؛ المجلّد الثّانيّ، الجزء الثّاني، ص: 256.
[38] نفسه؛ المجلّد الثّانيّ، الجزء الثّاني، ص: 211.