سجل الحوار 29 رجب 1442هـ/ 13 مارس 2021م في الخامسة عصرا بتوقيت مسقط عن طريق برنامج zoom
أجرى الحوار: بدر العبريّ
ماذا يُقصد بالعقل
العبريّ: ماذا يُقصد بالعقل؟
صادق جواد: العقل يأتي بمعناه الواسع، والّذي يرادف كلمة Mind في اللّغة الإنجليزيّة، وقد يأتي مرادفا لكلمة Reason في اللّغة الإنجليزيّة، وهذا يعني المنطق العقليّ، فيكون العقل ملكة من ملكات التّفكير بشكل عام، والإشكاليّة عندما نبحث مسألة ما، هل نبحثها من رؤية مسبقة عندنا في فهم الأمور، أو نأتي إلى بحثها وطرحها على صاحب الفكر والمنطق والمعرفة [دون تقيّد برؤى سابقة]، مثلا جميعنا يعرف ماذا في الأديان أو الإسلام من رؤى، والعالم اليوم تجاوز العديد ممّا طرحته الأديان، فإذا نريد فهم الأمور الحاليّة بما استقرّ لدينا من رؤية دينيّة أو ثقافيّة سابقة؛ هذا شيء، وإذا أردنا أن نبحث الأمور بشكل مطلق حسب اللّحظة الّتي تعيشها معرفيّا؛ فهذا شيء آخر.
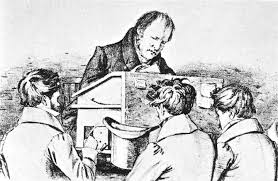
نظرة الفلسفة إلى المعارف الدّينيّة والرّؤى الماورائيّة
العبريّ: كيف تنظر الفلسفة إلى المعارف الدّينيّة، والرّؤى الماورائيّة؟
صادق جواد: في الواقع العنوان والموضوع الّذي ذكرتَه عريض جدّا، والحقيقة في أواخر عصر النّهضة ظهر على المسرح الفكريّ الأوروبيّ الفلسفة التّجريبيّة، متبلورة من فكر رائدها فرنسيس بيكون (ت: 1626م) في أوائل القرن السّابع عشر، ووفقها كلّ المعرفة تتحصّل في الذّهن البشريّ عن طريق واردات الحواسّ والخبرة المكتسبة بالملاحظة والتّجريب، بمعنى آخر لا يوجد في الذّهن البشريّ إلّا ما يدخله من هذين المدخلين، بالنّتيجة كل المتكوّنات في الذّهنيّة البشريّة عبر العصور من مبان دينيّة ماورائيّة، وأخرى علميّة عمليّة، وثالثة فكريّة فلسفيّة، جميعها من واردات الحواس والخبرة حسب هذه الفلسفة، ومنهجيّة هذه الفلسفة تتبع الجزئيّات للتّوصل إلى حكم كلّيّ تحت مسمّى الاستقراء.
وفي طور آخر أوسع ظهرت الفلسفة العقلانيّة من فكر رائدها ديكارت (ت: 1650م)، وترى إلى جانب الحواسّ والخبرة هناك في مكنون العقل مكنة تستورد المعرفة بشكل مستقلّ، وبالأخصّ حول كليّات الوجود أي الكون وسننه وظاهرة الحياة وظهور الإنسان وخبرته الحياتيّة ومآله بعد الموت، ومنهجيّة هذه الفلسفة هي إسقاط حكم كلّيّ مسبق على الجزئيّات تحت مسمّى الاستدلال.
من طور ثالث ظهرت الفلسفة المثاليّة القائمة على نظريّة أنّ الحقيقة المطلقة كامنة في عالم يتعدّى عالم الظّواهر، لذا لا تلامس إلّا بعد رجوع الظّواهر إلى علم ماورائيّ، بهذا المعنى هذه الفلسفة ترجع إلى أفكار سقراط (ت: 399 ق.م) وأفلاطون (ت: 340 ق.م) قديما، وأفكار كانت (ت: 1804م) وهيجل (ت: 1831م) وغيرهم من المحدثين، فهي تتماهى مع واردات الأديان، لكنّها في صميمها تبقى فلسفة إنسانيّة المحور والمحتوى غير معنيّة بالتّنظيرات اللّاهوتيّة أو البناءات الأخرويّة المعهودة في أدبيّات مختلف الأديان.
في الشّرق نجد الفلسفة الهنديّة قائلة إنّ الحقيقة المطلقة كامنة في عالم يتعدّى عالم الظّواهر، ومن ثم لا تستبان إلّا بعد عبور عالم الظّواهر إلى عالم ماورائيّ، وفي الصّين حيث لم تنشأ أديان أهليّة ذات نزعة ماورائيّة فنشأت هناك مدرستان في الفلسفة تقاسمتا السّاحة الفكريّة الصّينيّة، أحدهما المدرسة الكنفوشيّة، والأخرى المدرسة التّاويّة، وكلتا المدرستان لم تعبئا بالتّنظيرات اللّاهوتيّة، والبناءات الأخرويّة الواردة في سائر الأديان، وأرى إجمالا اليوم أنّ هاتين المدرستين لا تعنيان بالماورائيّات.
خلاصة ألمس اليوم نزوعا متناميا في الفكر الفلسفيّ المعاصر نحو مزيد من استكشاف قابليّات الإنسان للتّعرّف على طبيعة الوجود وسننه، للبحث عن سبل ارتقاء الإنسان في معارفه، مع التّنامي في المعرفة والخلق الكريم، وللمزيد حول قابليّات الإنسان في التّعرّف على طبيعة الوجود وسننه، هذا التّوجه أراه يميل إلى مهادنة الأديان، وإفساح المجال لوارداتها ضمن المعارف الإنسانيّة ككل دون احتضان المعطى الدّينيّ بالضّرورة كمصدر معرفيّ مستقلّ يعتدّ به، ويبنى عليه، وأرحبّ شخصيّا بهذا التّوجه.
عقلنة النّصّ أو التّراث
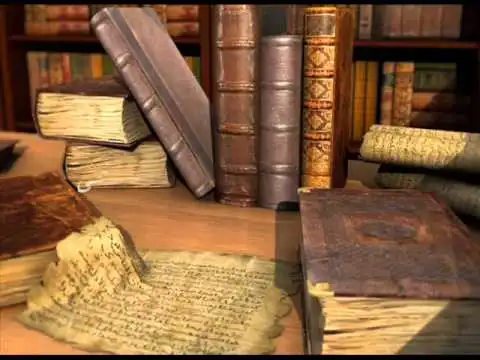
العبريّ: هل يمكن عقلنة النّصّ أو التّراث؟
صادق جواد: عقلنة النّصّ يعني أن توجد له مستقرّا في المعرفة العلميّة، وكلّ شيء في الواقع يعقلن، والعقل بمعنى المنطق العقليّ المتلازم مع المعرفة العلميّة هذا غير العقل الّذي هو عبارة عن وعي عام فيه ملكة المنطق العقليّ، وعلى الثّاني لا يعتبر عقلنة النّصّ أو التّراث أمرا سلبيّا، ولكن أن أقول إنّ هذا النّصّ بالضّرورة صحيح، سواء اتّسق مع المنطق العقليّ والمعرفة العلميّة، أو لم يتّسق؛ فالنّصّ عنده صحيح في الحالتين، هذا وجه موجود، لكنّ الإنسان لا يملك إلّا أن يستعمل ما عنده من ملكة التّعقّل في تبرير ذلك، والعقل في نظري ليس أداة، بل هو الإنسان نفسه، فأجسامنا تتحرّك، لكن جميعنا عقول تتخاطب، فإذا تعقّلنا شيئا استقبلناه بالقبول، وإذا لم نتعقّله بسبب أنّه جاء في نصّ يرفض التّأويلات الأخرى لعقلنته هذا شيء آخر تماما، وأمّا التّفكير الفلسفيّ فيتطلبّ الواقع الّذي لا يجعلنا ابتداء نتوقف عند النّصوص، بل يتوقف عند قدرتك في إبداء ما عندك ككائن عاقل لفهم تلك النّصوص.
جميع النّصوص قابلة للعقلنة والتّأويل
العبريّ: هل يوجد نصّ مغلق ونصّ مفتوح، أم جميع النّصوص قابلة للعقلنة والتّأويل، وهل يدخل فيها عقلنة اللّاهوت؟
صادق جواد: العقل لا يتعامل مع النّصّ كنصّ، وإنّما يتعامل مع محتوى ما يعبّر عنه النّصّ، ويدخل هذا ضمن سؤال: ممّ تتكوّن المعرفة الإنسانيّة؟ فإذا كانت المعرفة الإنسانيّة ابتداء تتكوّن من الوحي فهذا منهج، وإذا قلت إنّها تتكوّن ابتداء من واردات العقل الإنسانيّ فهذا منهج آخر، وهناك من يحاول الجمع بينهما، لكنّها متأرجحة [وليست ثابتة]، وأنا مع أنّه لم تعد الواردات الإسلاميّة التّقليديّة وافية لإدارة الشّأن الإنسانيّ العام، والسّؤال [المفتوح والمتعلّق هنا]: بماذا يدار الشّأن الإنسانيّ اليوم، هل يدار بواردات الأديان، أم بواردات الاجتهاد الإنسانيّ؟
ارتباط الأنسنة بالعلمنة
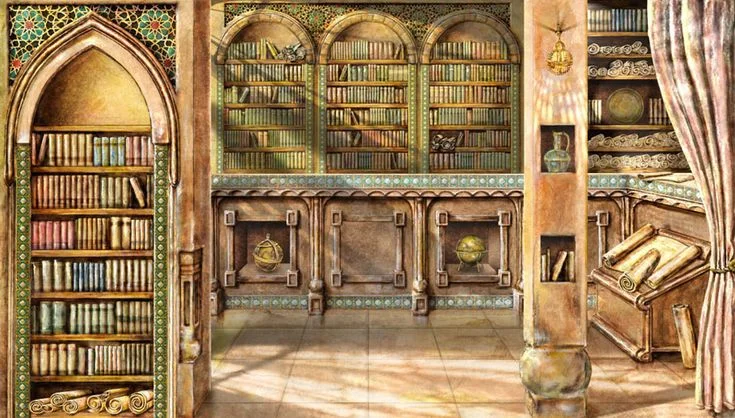
العبريّ: هل بكلامك هذا يعني أنّ الاجتهاد الإنسانيّ معناه استبدال المعارف الدّينيّة والتّراثيّة بما وصل إليه الإنسان اليوم من معارف واجتهاد تحت مظلّة أنسنة النّصّ والتّراث؟
صادق جواد: الأنسنة مرتبطة بالعلمنة، والاثنان مرجعيّتهما المعرفة العلميّة المرتبطة بالاجتهاد الإنسانيّ، والفرق بينهما أنّ في الأنسنة نزوع إلى رعاية الإنسان، بينما في العلمنة فهم الشّيء على ما هو عليه دون كثير اكتراث بالحالة الإنسانيّة، وبالجملة أرى لا داعي للتّعمق المؤدّي إلى تفسير الماء بالماء، فلكي تفهم الماء عليك أن تذهب إلى المختبر لتدرك ممّا يتكوّن، وترى كيف يتعامل الماء مع جاذبيّة الأرض، ويجري في مجراه من أعالي الجبال إلى أسفل المحيطات، والمسألة العلميّة عموما تدخل ضمن الاجتهاد الإنسانيّ، والعالم اليوم يُدار – كما أسلفت – بالاجتهاد الإنسانيّ، وفي مسألة العقلانيّة قد انتقدت ليس من ناحية العقل كوعي كامل للإنسان؛ وإنّما انتقدت من قبيل المنطق العقليّ، وكانت (ت: 1804م) رأى لها حدودا من هذا الجانب، فإذا ركنت إلى المنطق العقليّ في جميع الأمور؛ تجد أنّ اجتهادك لن يخرج بشكل وافٍ، فإذا جئنا إلى المثاليّة فمن الحواسّ والخبرة تدرّج النّاس في عموم العالم إلى الفلسفة العقلانيّة، ثمّ وجدوا أنّ هذه لها حدود أيضا، بمعنى أنّ اجتهاد الإنسان لا يقتصر عند دراسة الحواسّ وخبرة الإنسان الظّاهرة، ولا يقتصر عند المنطق العقليّ، فجاء الفكر ليكتشف أنّ في الإنسان قابليّات ضخمة لفهم هذا الكون وهذا الوجود، فإذا قلتَ إنّ فهمي حول الكون والوجود هو ما أعطي لي سابقا، هذا منهجك، لكن ليس هذا المنهج الّذي يسير عليه عالمنا اليوم، فكلّ الأمور الحياتيّة كالبيئة والاجتماع البشريّ دخلت في دائرة التّعقّل الّذي ليس بمعنى تسطير هذا وذاك، وإنّما بمعنى التّعقّل المرتبط والمتلازم مع المعرفة العلميّة المنبثقة والمتطوّرة من الإنسان نفسه، والمناهج الدّينيّة يعرف ماذا فيها، والعودة إلى التّفسيرات الدّينيّة لا يؤدّي إلى نتيجة، فإذا كنت معنيّا بالاقتراب من فهم طبيعة الوجود، ومن فهم ذاتك وعلاقتها بالوجود، هناك عالم معرفيّ آخر لفهم أسرار الكون والوجود، غير المنهج الّذي أنت عليه.
نظرة صادق جواد إلى الإلحاد

العبريّ: كيف تنظر إلى الإلحاد وارتباط الأديان به تحت مسميات منها الهرطقة والزّندقة؟
صادق جواد: كلمة الإلحاد لم اتوصّل حتّى اليوم ماذا نقصد بها، وأوردها القرآن ليس في مجال الإنكار، وإنّما في مجال تحريف الأسماء، ولمّا نقول الملحد كافر، بمعنى أنّ الإلحاد كفر، والكفر إنكار، بينما الإلحاد تحريف الأمر عن مقصده، فإلى أين يأخذ بك تفكيرك في الكون، كنت من أيّ بيئة ثقافيّة دينيّة أتيت منها، فإذا تتبعت المسار الفكريّ وتعمّقت فيه، واستوعبت ما في العالم من فكر أيضا، هذا يقودك إلى ساحات مفتوحة أمام جميع التبلورات، نعم، المسألة الدّينيّة محسومة في جميع الأديان، لها قوالبها وأدبيّاتها، ولها كتبها ومصادرها، لكنّ العالم اليوم ليست هذه مرجعيّته، مرجعيّته في الاجتهاد الإنسانيّ، في الغوص في أسرار الطّبيعة والوجود.
حدود التّعقلن وإعمال العقل
العبريّ: هل يوجد حدّ أو سقف في التّعقلن وإعمال العقل؟
صادق جواد: إذا أسقطت العقل على فهم النّصّ هل تخشى عدم صمود النّصّ أمام العقلنة، والفرد لمّا يأتي إلى النّصّ يفهمه تعقّلا، والتّعقّل هنا بمعنى الالتزام بالمعرفة العلميّة، أي بما عندك من عموم الإحاطة المعرفيّة، هنا لا خطورة على النّصّ، فالعقل مفتوح، ولا أحد له القدرة أن يضع له حدودا، فإذا وضعت عليها حدّا أو سقفا ممكن أن يكون حاضرا سابقا، لكن في عصرنا لا يفرض شيء على التّعقّل، بمعنى التّعامل مع الوجود من خلال العقلنة، لا يقتصر عند عقلنة النّصّ، بل يشمل عقلنة فهم الطّبيعة، وفهم الذّات، وفهم الكون، وما حولنا، فمن خلال المادّة الرّخوة في الجمجمة نستقبل، ومنها أيضا ننظر ونحلّل، فالمسألة العقليّة مرتبة من خلال المسألة الفكريّة والعلميّة، فإذا وضعنا حدّا، ومنعنا الإنسان من قراءة كتب معيّنة، ومتابعة أفكار ما؛ لأنّهم يخافون إذا اقتربت من غير معاييرهم ستتحوّل عمّا يريدونك أن تكون عليه، لهذا لا أرى وجود سقف أو حدّ للنّظر في الأمور الوجوديّة إطلاقا، حيث نحن في رحم الوجود، وهو يدعونا أن ننظر فيه بأدق ما يمكن لنا أن ننظر فيه، وهنا لا أتحدّث عن عقل فرديّ، وإنّما عن عقل يجمع النّاس عليه من خلال أبحاثهم ومعارفهم، فعندك مرجعيّة إنسانيّة جمعيّة، وعندك مرجعيّات خصوصيّة كالأديان، فإذا ذهبت إلى المرجعيّات الخصوصيّة قد تجد حدّا وسقفا أمام العقل، لكنّ العالم اليوم يحتكم بصورة أكبر إلى المرجعيّة الإنسانيّة بشكل عام [وهي عقليّة في الأصل منفتحة لا سقف لها].









