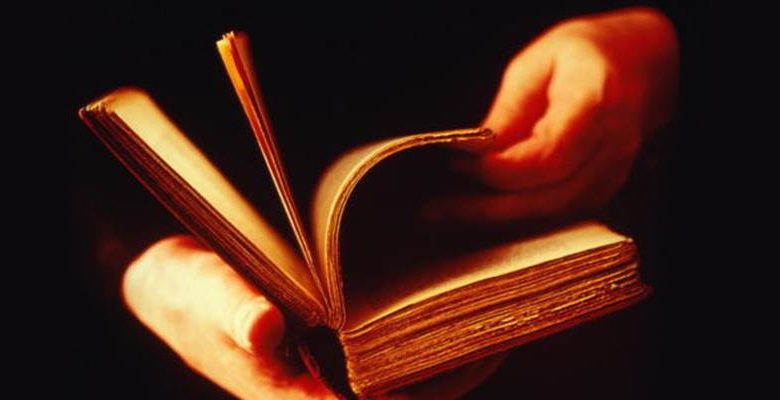مجلّة التّكوين، عدد 47، محرم 1441هـ/ سبتمبر 2019م، ص: 72 – 79.
ـ مجلّة التّكوين: يتلقى تيار العقل الإسلامي مواجهة شرسة منذ بدايات نشأته ممثلا في المدرسة الاعتزالية، وما طالهم من القمع والتنكيل والتصفية على يد الخليفة العباسي المتوكل، مرورا بكل حركات العقل والتجديد .. ما تفسير ذلك في نظرك؟
العبري: بداية أشكر مجلّة التّكوين عموما وللأستاذ حسن المطروشيّ خصوصا على إتاحة الفرصة في مجلّة تنويريّة تساهم في الحراك الفكريّ والتّنويريّ في عمان والمجتمع العربيّ عامّة.
الإنسان بطبعه يميل إلى الماضوية وتقديس ما ألفه، فيرى في الماضي بعين الاعجاب والانبهار والملائكيّة، ويشمل هذا ما ورثه من تراث ماديّ وشفويّ، حيث يرى الاطمئنانة فيه، فينزع إليه ويقدّسه، {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا} لقمان/ 21.
والجمود على الماضيّ ليس جمودا دينيّا أو فكريّا؛ بل يشمل الجمود السّياسيّ والمجتمعيّ أيضا، لذا الخوف من التّفكير وإعمال العقل لا ينحصر في الدّائرة الفرديّة، حيث تخاف أن تخرج في المألوف خشية أن تقع في الغضب الأخرويّ حسب ما ورثته من فلسفات ماورائيّة، أو خوفا من فقدان مصلحة ماديّة، أو مكانة اجتماعيّة، أو منزلة سياسيّة، فتمسكها بما روثته ليس دليل اقتناع؛ بل يكون كثيرا حفاظا على الحال، أو خوفا من المستقبل.
وأمّا الدّائرة الواسعة فتتمثل في السّلطات الثّلاثة: المجتمعيّة والدّينيّة والسّياسيّة، وهي متشابكة جدّا ومتداخلة على بعضها، فتواجه من يعمل عقله أو ينقد أو يفكر أو يخرج عن المألوف بتشويه صورته مجتمعيّا من خلال الدّين أو الإقصاء السّياسيّ، كما واجه فرعون موسى (ع) مستغلا السّلطتين المجتمعيّة والدّينيّة حيث يقول: {وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ} [غافر/ 26].
ويضرب القرآن نموذجا بالأحبار والرّهبان [رجال الدّين] في استغلال الواقع الدّينيّ لتحقيق مصالح مجتمعيّة وسياسيّة من خلال الموروث الدّينيّ السّائد حسب ثقافة أيّ بلد ومجتمع حيث يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التّوبة/ 34]، فوصفهم بالكثرة حتى لا يقال هؤلاء شواذ لا يقاس عليهم، ولطبيعة الغلبة السّائدة هي المستفيدة في النّهاية، وإن كانت أقليّة باعتبار المجموع العام، لكن باعتبار الحدود الإقليميّة تكون مستفيدة بكثرتها أو غلبتها فيه، وأتي بالفعل المضارع المؤكد لإفادة الاستمراريّة [ليأكلون، يصدّون، يكنزون]، مع واو الجماعة المفيد لاستغراق الجنس وهذا حتى لا يقال إنّ هذا خبر تأريخيّ انقضى، أو هو مخصوص بالأمم الكتابيّة السّابقة، بل يعمّ السّنن المجتمعيّة في ذلك ما وجد المجتمع البشريّ.
لهذا العودة إلى العقل والتّفكير، وغربلة التّراث والموروث، كثيرا ما يجابه من قبل المصالحيين المستفيدين من هذه السّلطات الثّلاثة، وهذا ما حدث تأريخيّا مثلا مع أرسطو [ت 332 ق.م] الّذي اتهم بالإلحاد والزّندقة، وهي تهمة تلازم التّيار الأصوليّ المسيحيّ الأرذوكسيّ والكاثولوكيّ تجاه العديد من الفلاسفة والمتنورين حتى بدايات العصر الحديث، ويشتدّ الأمر إذا تلاحم السّاسة مع رجال الدّين.
وهو نفسه لمّا صيغت روايات بعد وفاة الرّسول الأكرم – صلّى الله عليه وسلّم – في تمجيد الرّموز السّياسيّة، وأنّ الحاكم صنع الله، ووجوب الرّضا بقضاء الله، إلى غير ذلك، ممّا ضخم من نظرية الحديث والرّواية على حساب القرآن والعقل، فهنا نشأ تيار نقديّ في البداية فقها مع مدرسة أهل الرّأي، والّتي من أهم رموزها أبو حنيفة [ت 150هـ]، وهو نفسه لم يسلم من التّكفير، حيث تطورت هذه المدرسة إلى مدرسة الاعتزال، بعد حدوث التّرجمة، ودخول الفلسفة اليونانيّة، وتطور اللّاهوت الإسلاميّ، وشيوع الآلة والمنطق من العلوم، بدأ الحديث حول الرّواية والحديث، والّتي شاعت وركن إليها النّاس، واستفاد منها بصورة كبيرة المصالحيون، فكانت التّهمة كبيرة لهؤلاء، بداية من الخوارج والجهميّة إلى الاعتزال والزّندقة والإلحاد، وهذا ما حدث في عصر المتوكل [ت 247هـ]، بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الاعتزال، وهو صراع سياسيّ، الأصل فيه التّدافع الطّبيعيّ، والسّياسة تحمي الجميع، ولكنه بسبب ما أسلفت كانت النّتيجة سلبيّة، وأحيانا مأساويّة ودمويّة.
مجلّة التّكوين: هل يمكن القول أن ثقافتنا الإسلامية، في نطاقها الأوسع المهيمن، أصبحت تخشى العقل وهي طاردة للتفكير العقلي؟
العبري: أيّ ثقافة في الحقيقة هي تخشى من العقل، وأحيانا تحارب العقل والتّفكير باسم العقلانيّة نفسها، كما تحارب التّعددية باسم التّعايش والأمن الفكريّ، لهذا يجب أن نفرق بين المناهج وبين الشّعارات، فهناك فرق عندما ننطلق من منهج نقديّ يعظم فيه النّقد والبحث، ويحترم فيه رأي الباحث والنّاقد، ويوفر أجواء من الحريّة والأمن النّفسيّ والبدنيّ، وبين الشّعارات الجوفاء، الّتي هي صورة للخارج تخالف التّطبيق في الدّاخل.
والسّبب في نظري أنّ الهيمنة الغربيّة على الشّرق مع شراستها وتناقضاتها السّياسيّة، إلا أنّ المؤسسات المدنيّة الغربيّة قائمة على منهج الأنسنة والعقلنة وحريّة الإنسان وحقوقه، لذا العديد من السّياسات الشّرقيّة تمارس النّقيضين: النّقيض القائم على الشّعارات الجميلة المصدرة للخارج باسم العقلنة والتّسامح والتّعايش وحقوق الإنسان، والنّقيض الاستبداديّ في الدّاخل القائم على تمكين الأصوليّة وقمع التّيارات النّاقدة، تحت شعارات حفظ سياج المجتمع أو الأمن الفكريّ ونحوه.
لهذا لا يتوفر للباحث والنّاقد المناخ الملائم لأنّه يخشى على نفسه في ذلك، فيسعى إمّا إلى الهجرة أو الرّمزيّة في الكتابة، كما حدث لإخوان الصّفا وخلان الوفا في رسائلهم أو كما في كليلة ودمنة قديما.
نعم وجدت رموز عقلانيّة كبيرة وناقدة عندنا في الشّرق بداية من حسن العطار [ت 1835م]، وتلميذه رفاعة الطّهطاويّ [ت 1873م]، ومرورا حتى جمال الدّين الأفغانيّ [ت 1897م]، ومحمّد عبده [1905م]، ومن بعدهم كعليّ عبد الرّازق [ت 1966م]، ومحمود أبو ريّة [ت 1970م]، ومحمود شلتوت [ت 1963م]، إلى المدرسة النقديّة والتّفكيكيّة كما عند أبي القاسم حاج حمد [ت 2004م]، ومالك بن نبيّ [ت 1973م]، ومحمّد عابد الجابريّ [ت 2010م]، ومحمّد أركون [ت 2010م].
إلا أنّ هذه الرّموز لم تنطلق من مؤسسات يتوفر لها المناخ الآمن تحت ظلّ التّدافع البشريّ، وقد تستغل سياسيا وآنيّا ثمّ يضطهد معها لمّا تنتهي الغاية من هذه الورقة، لهذا تأثيرها يمشي ببطئ شديد، خلافا للجانب التّراثيّ والماضويّ، فهو يتلقى الدّعم السّياسيّ والإعلاميّ.
وهنا لا أمارس القمع ضدّ أحد ما، فمن حق الماضويين والتّراثيين أن يكون لهم ذلك، ولكن الأصل في السّياسة أن تفتح المجال للجميع، وأن تترك التّدافع تحت ظلّ القانون الحامي للكلّ، وهذا التّدافع السّننيّ الطّبيعيّ هو من يحفظ التّوازن في المجتمع، ولكن كما أسلفت الثّقافة المجتمعيّة والدّينيّة والسّياسيّة لا زالت تخاف من هذا التّدافع خوفا من مصالحها، أو استغلال هذا خارجيّا، فهي تخشى من الرّموز فضلا أن يتحول فكر هذه الرّموز إلى مؤسسات ناقدة وباحثة تحت مظلّة العقل والنّقد، وهنا تجمد الثّقافة في المجتمعات العربيّة بشكل عام.
ـ مجلّة التّكوين: تبدو مشاريع التنوير والمشاريع العقلية أو العقلانية في الفكر الإسلامي مشتتة أو متعددة ومتباينة، لا تجمعها رؤية واحدة يمكنها أن تشكل نظرية معرفية .. هل هذا صحيح برأيك؟ وما مدى أثره على المشهد؟
العبري: لابدّ أن نفرق بين الآلة والمنهج والنّتيجة، فالآلة العقليّة في التّعامل مع النّصوص التّراثيّة وغيرها واحدة، وهي متداخلة في المعارف الإنسانيّة، وفي الوقت نفسه متطورة، فآلة أصول الفقه، وآلة النّحو والدّلالات في العلوم الإسلاميّة سابقا لم تكن وليدة الصّدفة؛ بل نتيجة استفادة وتداخل مع المنطق الأرسطي، وهكذا التّأثر الحالي مثلا بعلم الحجاج والسّيميائيات.
نعم المناهج تختلف وتتعدد، وهذا شيء طبيعيّ، فذاك من منهجه مثلا قرآني، يقدّم القرآن على أيّ نص عداه، وهو مذهب قديم، استقر عند البعض في الاعتقاد، وتوسعوا في الفقه، ثمّ ظهر المذهب القديم عند القرآنيين، وعند أحمد صبحي منصور [معاصر] خصوصا كما في كتابه القرآن وكفى، وهناك من يقدّم النّص القرآني في تحكيم الرّواية مطلقا، وإن كان هذا المنهج قديما، وقال به أهل الحديث، إلا أنّ محمود أبو ريّة [ت 1970م] أعاد صياغته من جديد كما في كتابه أضواء على السّنة النّبويّة، وكذا الحال مع محمّد الغزاليّ [ت 1996م] كما في كتابه السّنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، ومن المتأخرين طه جابر العلوانيّ [ت 2016م]، وفريق آخر يعمّق الجانب الدّلاليّ في القرآن كما عند أبي القاسم حاج حمد [ت 2004]، وعالم سبيط النّيليّ [ت 2000م]، ومحمّد شحرور [معاصر]، وعدنان الرّفاعيّ [معاصر]، وخالد الوهيبيّ [معاصر].
وهناك منهج من يحاول الملائمة والموافقة بين التّراث والتّغريب، وإعادة قراءة العقل العربيّ قراءة معاصرة كما عند محمّد عابد الجابريّ [ت 2010م]، وفريق آخر يرى تأريخيّة النّصوص مطلقا بما فيها القرآن، فيستخدم المنهج التّفكيكيّ الواحد كما عند محمّد أركون [ت 2010م]، وغيرها من المناهج.
ومع اختلاف هذه المناهج في التّعامل مع النّصوص التّراثيّة والمعاصرة؛ بل حتى مع النّص المقدّس؛ إلا أنّ الآلة متقاربة ومتداخلة، ومتطورة عند البعض، وعند آخرين لا يزال يقف مع آلة القرن الثّالث والرّابع الهجريّ برمّتها، وهذا كلّه سيؤثر بلا شك في الجانب الثّالث، أي تعدد الرّؤى.
وعليه تعدد الرّؤى واختلافها هو في الحقيقة حالة صحيّة، بل العكس الاتفاق دليل الجمود؛ لأننا نتحدّث عن معارف عقليّة تصوريّة تتأثر بعشرات التّصديقات، وليس عن عمليّة تجريبيّة منظورة، مع قابليّة الثّانيّة للتّعدد في التّأويل والتّفسير أيضا.
فالخلل ليس في تعدد الرّؤى، وإنّما في المناخ الّذي يتيح حريّة واسعة لهذا التّعدد؛ لأنّه لا إبداع بدون تعدّديّة في الرّؤى والمناهج والبحث، ولا تعدّديّة بدون حريّة تكفل للنّاس ذلك وفق القانون العادل الحافظ للجميع.
مجلّة التّكوين: ـ ثمة رؤية تذهب إلى أن الفكر التقليدي راسخ وله شرعيته التاريخية وبات من المستحيل نقده، فضلا عن تغييره .. كيف تقيم مثل هذه المقولات؟
العبري: في الحقيقة لا يوجد هناك فكر تقليديّ واحد، هناك عشرات النّماذج من الأفكار التّقليديّة وبعضها متصارعة، وداخل الفكر الواحد أيضا عشرات النّماذج، نعم قد يبدو في الظّاهر حالة فكريّة واحدة، ولكن لمّا تتعمّق وتتوغل تجد عشرات النّماذج من الأفكار المتضاربة.
وتعود الصّورة الظّاهرية للحالة الفكريّة الواحدة إلى ما أسلفت سابقا من السّلطات الثّلاثة: المجتمعيّة والدّينيّة والسّياسيّة، ومدى تحقق مصالحها وفق رؤية فكريّة معينة، قد تنتسب لمدرسة أكبر مع اختلافها في العديد من التّطبيقات مع أصل هذه المدرسة، ولكن حفاظا على المصالح يتمّ الحفاظ على هذه الحالة الواحدة، واعتبار التّعدديّة يهدد استقرار الأمن العام، أي مصالح هذه السّلطات الثّلاثة في الحقيقة.
وعليه يكون إشكاليّة سؤالك صحيحة ولكن ليس من باب شرعيته التّاريخيّة؛ لأننا لو تدبرنا التّأريخ لرأينا العديد من النّماذج المتغيرة والمتطورة حتى في التّراث الدّينيّ ذاته، بل الأولى أن يقال من خلال شرعيته المعاصرة وفق السّلطات الثّلاثة الّتي أشرت إليها.
مجلّة التّكوين: ـ اللافت أن الجانب الرسمي في الدول الإسلامية يميل لصالح التيار التقليدي، حتى بعض تلك الأنظمة الحداثية التي ترفع شعار العلمانية .. إلى أي سبب تعزو هذا التناقض في الوقت الذي يحاول فيه العرب والمسلمون الانفتاح على العالم سايسيا وفكريا ومعرفيا؟
العبري: هناك سببان رئيسان في نظري: الأول غياب المؤسسات المدنيّة الفاعلة في المجتمع، والمستقلة عن السّلطات الثّلاثة، حيث تساهم في تفعيل المجتمع المدنيّ بعيدا عن الوصاية والهيمنة من قبل هذه السّلطات.
السّبب الثّاني: أنّ استقرار هذه السّلطات وتحقق مصالحها في الحدّ من التّعدديّة الّتي تفرز في ذاك نقاطا متعددة في المجتمع، ممّا يرفع من تحقق المبدأ العام، ويضعف من المنافع الشّخصيّة والفئويّة، وعليه كان الاتكاء على صور تقليديّة معينة، بما في ذلك الدّول الّتي تتظاهر بالعلمانيّة أو الحداثة؛ لأنّها في النّهاية وليدة هذه العقليّة، أو مرهونة بها في النّهاية، وقد يكون الادعاء ظاهريّا كصورة خارجيّة لا أكثر.
وبما أنّ الغلبة للسّلطة الدّينيّة وتأثيرها الأفقيّ على السّلطة المجتمعية؛ تكون السّلطة السّياسيّة خاضعة لهما من باب المنافع المشتركة، ومع غياب المؤسسات المدنيّة المستقلة والّتي قد تكون من خارج الصّندوق أو الفكر العام يبقى تأثيرها فرديا، وباجتهادات شخصيّة، وليس عن طريق مؤسسات مدنيّة وإعلاميّة، إلا ما استثني وهو قليل مقارنة بغيرها.
وهناك سبب مهم وهو أنّ حتى هذه الجهود الثّقافيّة والفكريّة الفرديّة تتحول في ذاتها إلى سلطة منفعيّة هدفها تحقيق المنافع الشّخصيّة من خلال ما تحمله من فكر وثقافة، فهي ليست مع المبدأ بقدر ما تكون مع المنفعة، وهذا أشرت إليه في مبحث الثّقافة في الوطن العربيّ والحراك المجتمعيّ، وهو منشور في كتاب إضاءة قلم حلقة التّعايش.
ـ مجلّة التّكوين: لك اشتغال بحثي في قضية التطرف ومواجهته، في الوقت الذي بات فيه المسلمون يواجهون هذه التهمة نظرا لبعض الممارسات التي تتبانها جماعات متطرفة .. البعض يرى أن الفكر التقليدي يؤسس لهذا التطرف ويغذيه وهو الرافد الرئيس الذي يغذي فكر الفئات الإرهابية المتطرفة .. إلى أي مدى ترى ذلك صحيحا ويتوجب المعالجة؟
العبري: التّطرف كما أشرت في كتابي “فقه التّطرف” لا يعرف دينا ولا مذهبا ولا أمّة، وهو الأصل نشاز بين البشر، فقد يغذيه المجتمع لسبب تعصب أو حمية أو اعتداد بعادات جاهليّة كحالات الثّأر مثلا، وقد يكون بسبب ترسبات تراثيّة أضيفت إلى الدّين، كما نرى من تفجير الكنائس أو المساجد أو الحسينيات، فهذا يفجر بالتّوراة، وذاك بالإنجيل، وثالث بالقرآن، وقد يكون مدعوما سياسيّا، لتحقيق مصالح سياسيّة، كدعم الكيان الصّهيونيّ عالميا ضدّ الشّعب الأعزل والمضطهد لأكثر من سبعين عاما، وقد يكون سببه الثّقافة نفسها، كما أشار إلى ذلك انشتاين [ت 1955م] في مقالاته عندما وجد المثقف يدعم التّطرف النّازي أو خصومهم من السّاسة، والّذي قاد إلى الحربين العالميتين، وكما نراه اليوم أيضا في مجتمعنا العربيّ.
لهذا بينت في كتابي كيف نستطيع التّفريق بين التّطرف ونحوه، وهذا من خلال المقاصد الخمس الحافظة للإنسان ونفسه وفكره وعرضه وعقله وماله، وهذا يتساوى حوله الجميع، والتّعامل مع النّفس البشريّة أنّها نفس واحدة، لها حق الحياة، وحق التّمتّع بالوجود، وعليه عالجت العديد من النّظريات الخاطئة في هذا، وضرورة التّفريق بين الجوانب التّكوينيّة والتّشريعيّة والجزائيّة، فالاختلاف والتّعدد دينا ولغة ولونا وجنسا جانب تكوينيّ، لا يتعارض وحق الحياة والتّمتع بها، لهذا من أحياها وحافظ عليها كمن أحيا النّاس جميعا، خلاف من سعى لإفسادها ودمارها، فتكون التّشريعات حافظة للحق التّكوينيّ، فهي مصاديق حافظة له، فإن كانت هذه التّشريعات عكس ذلك فهي لا قيمة لها، كتشريع قتل المرتد وغير الكتابي، وجواز أخذ مالك المشرك، وجواز غيبة المخالف في المذهب، وغيرها أسهبت الإشارة إليها في الكتاب، لهذا كان الجزاء بيد الله تعالى وحده، فلا يجوز أن نشاركه في الحكم، فندخل من نشاء نحن في رحمة ربنا، ونخرج من نشاء، وهذه قضية غيبية مرتبطة بالفرد أولا، وبالعدل الإلهي ثانيا؛ لأنّه أعلم بعبادة وبخلقه سبحانه، لا يظلم أحدا أبدا.
وعليه التّراث في جملته مرتبط بالصّيرورة البشريّة، وهذه الصّيرورة تصيب وتخطئ، تتقدم وترجع، فالتّراث ليس وحيا منزلا من السّماء، وليس من وضع الشّياطين، لهذا لابدّ من مراعاة حدّ الظّرفيّة المكانيّة والزّمانيّة في قراءته، فمن التّطرف تمجيده والتّعصب حوله، كذلك من التّطرف رفضه بالكليّة، فهو تجربة بشريّة يدرس تحت السّنن المجتمعيّة والتّشريعيّة المرتبطة بالبشر، نعم فيه سوءات تطرفيّة، وفيه حسنات أيضا، فنقف مع الحسن، ونقوّم وننقد السّيء، وفي الجملة مرتبط بما أسلفنا من سلطات ثلاث، فهناك من يحيي السّيء منه لمصالح آنية لا أكثر.
ـ مجلّة التّكوين: برأيك .. ما هي أولويات مشروع التنوير والتجديد حاليا، ومن أين يجب البدء، وأي المناطق في الفكر الإسلامي هي الأشد خطورة وتأثيرا .. الفقه المذهبي؟ التاريخ؟ المرويات؟ أم غيرها؟
العبري: دعنا نحدد المصطلح أولا المرتبط بالحركات التّنويريّة في العالم الإسلاميّ ككل، والعالم العربيّ خصوصا، ثمّ نعرف الأولوية، فالحركات التّنويريّة مرت بثلاث حركات داخل عباءة الموروث الدّينيّ في نظري: الحركة الإصلاحيّة والتّجديديّة والتّفكيكيّة، ولا يتسع المقال بذكر الرّموز وشيء من كلامهم في هذا اللّقاء السّريع، ولكن أشير إلى الفكرة بشكل عامّ.
أمّا الإصلاحيّة فظهرت في ظلّ الاستعمار الغربيّ، وحالة التّخلف الكبير الّذي ساد هذه الأمّة، لهذا كانت الكتابات متعلّقة بالإصلاح السّياسيّ والدّينيّ والمجتمعيّ والماليّ، والاتحاد ضدّ الاستعمار المهيمن لهذه الأمّة، فكان يقف المسلم مع المسيحيّ والدّرزيّ والاشتراكيّ والعلمانيّ في صف واحد؛ لأنّ الهدف واحد.
ثمّ لمّا بدأت الحضارة الغربيّة تمتدّ أذيالها وثقافتها إلى العالم الإسلاميّ، وبدأ العديد يهاجر إمّا لدراسة بداية من بعثات محمّد عليّ باشا [ت 1849م] في مصر، أو لعمل، وجدوا الفرق بين حاضرنا وحاضرهم، فكانت الكتابات لا تخرج في جملتها عن رأيين نقيضين، ورأي ثالث حاول التّوفيق والجمع، فأمّا الأول فنظر إلى الحضارة الغربيّة نظرة سلبيّة مطلقة، وأنّها جاهليّة ثانية، قرينة الكفر والفسوق والمجون، فمنهم من غالى حتى حرّم الوسائل كالاسطوانات والفنون والفلسفة والدّراسة في الغرب، بل حرّم تعلّم لغاتهم، وفريق اعتبر أنّ التّطور والمكانة والحضارة في تطليق التّراث الإسلاميّ، وتبنيّ الثّقافة الغربيّة مطلقا حتى في اللّباس والأكل والأعياد، وفريق حاول الجمع والتّوفيق، فقال نستفيد من الغرب في الحضارة المدنيّة، مع تمسكنا بالأصالة والتّراث والخصوصيّة، وسمى هذا الفريق نفسه بالتّجديديين والمجددين.
إلا أنّ الحركة التّجديديّة فشلت في الحقيقة، لصعود تيارات سلفيّة وتقليديّة متعصبة، بداية مع البترول والكاسيت والصّحف، وحتى ظهور الصّحوة الدّينيّة، وهذه ظهرت من داخل الصّندوق، فظهرت مدرسة جديدة وإن بدأت مبكرة كما عند عليّ عبد الرّازق [ت 1966م] وأبي ريّة [ت 1970م] وخالد محمّد خالد [ت 1996م]، هذا الفريق العديد من رموزه من مخرجات الصّحوة، ومع تنامي المناهج الغربيّة في آلات قراءة التّراث، حيث تجاوزت مرحلة التّرقيع تحت مظلّة التّجديد إلى إعادة قراءة النّص الدّيني نفسه، وبطبيعة الحال ستختلف المناهج مع الغاية الواحدة، لنرى في الوقت المعاصر مثلا حسن بن فرحان المالكيّ، وعبد الجواد يس، ومحمّد شحرور، وابن قرناس، وعبد الجبار الرّفاعيّ، وعدنان الرّفاعيّ، ومحمّد البغيليّ، ومن عمان مثلا خميس العدويّ، فنحن اليوم نعيش مع المرحلة التّفكيكيّة، أو إعادة قراءة النّص الدّينيّ من جديد، بما فيه النّص المقدّس ذاته.
أمّا عن سؤالك أيّهما أشدّ الرّواية أم الفقه أم التّأريخ أم غيرها، ففي نظري الأشدّ هو القرب من المقدّس، وجعل غير المقدّس مقدّسا، فأنت كلّما ضيقت المقدّس كلّما جعلت دائرة الإبداع والنّظر والتّفكر أكثر اتساعا، وكلّما وسعت المقدّس تكون ضيّقت مساحة غيره.
وبلا شك الرّواية تأتي في دائرة القداسة بعد القرآن، بل هي أشدّ، لذا قال بعضهم: لا خير في قرآن بلا سنّة، ولا في سنّة بلا فهم للسّلف الصّالح، وذلك لأنّ القرآن مساحته المغلقة قليلة جدّا، عكس المساحة المفتوحة فيه، بينما تأخذ الرّواية المساحة المغلقة تحت مظلّة البيان بشكل أوسع، ثمّ تجاوزت الرّواية مساحة السّنة المجتمع عليها إلى مساحة الرّواية المذهبيّة، فبعدما كانت الرّواية حتى نهاية القرن الأول كما في مسند الرّبيع بين حبيب [ت 175هـ]، ومجموع الإمام زيد بن عليّ [ت 122هـ]، وموطأ الإمام مالك [ت 179هـ] لا تتجاوز ألف رواية مع المكرر، وأغلبها روايات فقهيّة، نجدها في القرن الثّالث والرّابع الهجريين تجاوزت عشرة آلاف رواية، كما في مسند أحمد [241هـ]، وصحيح ابن حبان [ت 354هـ]، والكافي للكلينيّ [ت 329ه].
كذلك هذه الرّواية تجاوزت الجانب التّعبديّ المحض أو التّشريعيّ في صورته العامّة إلى حياة الإنسان، في لباسه وهيئته وتنقله وسكنه وتعامله، ثمّ زادت بزيادة التّداخل الحضاريّ، فظهرت روايات تحريم الفنون، والتّشبه بغير المسلم أو المبتدع، والحذر من الفلسفة والعقل، بل حتى تحذير الأشخاص بأعيانهم أو بالإشارة، ولمّا حصل الافتراق ظهرت الرّوايات السّياسيّة، والرّوايات الممجدة لبني أميّة أو بني العباس، أو روايات الطّاعة المطلقة، أو روايات التّحذير من الخوارج، ولمّا حدث التّعصب للأشخاص ظهرت روايات الممجدة للخلفاء الأربعة، أو ذمّهم، والرّوايات الممجدة لمعاوية أو ذمّه، وروايات الممجدة لعائشة أو ذمّها، وروايات العشرة المبشرين بالجنّة، وروايات آل البيت والقرشيّة والخلافة، وهكذا لمّا ظهرت بعض العقائد تناسب معها وضع الرّوايات، كروايات المرجئة والقدريّة والجهميّة والرّافضة والنّصب، بل حتى في الفروع الكلاميّة والفقهيّة، وضعت روايات كلّ ينتصر لرأيه ومذهبه، وقدّست فوق القرآن، على اعتبار السّنة – أي الرّواية – قاضية على القرآن الكريم، أو ناسخة ومقيدة ومخصصة له، ففقد القرآن هنا عنصر الهيمنة والتّصديق، لتكون الرّواية بشكل قريب أو بعيد هي صاحبة الهيمنة والتّصديق.
ولهذا ظهرت في المقابل روايات التّفسير، والّتي في جوانب تخضع للانتصار السّياسيّ والمذهبيّ بنسبة الأمر إلى الرّسول الأكرم أو الصّحابة والتّابعين أو آل البيت، وتخصيص نصوص مطلقة في القرآن لشخوص، ولازم هذا روايات السّير المتعلّقة بالنّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم -، إذ خضعت للقداسة لارتباطها بشخص الرّسول الأكرم.
وفوق هذا جاءت قضيّة السّلف الصّالح لتمتد دائرة المقدّس إلى درجة الصّحابة والتّابعين أو آل البيت، ولازم هذا ما يسمى بالإجماع، وهو صناعة مبكرة شايعها الصّناعة المذهبيّة، ليكون إجماع المذهب إجماع الأمّة، ومع ظهور أصوات مبكرة في نقده كما فعل محمّد بن علي الشّوكانيّ [ت 1255هـ] في إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السّماع إلا أنّ نظريّة الإجماع سادت في تفكير مجموع الأمّة.
فهذه الأربعة في نظري [الرّواية، والسّير، والسّلف، والإجماع] هي الّتي ضاعفت درجة المقدّس، وأثرت فيما عداها، من تفاسير وشروح وإنزالات طيلة أكثر من ألف عام.
أمّا الفقه فهو تشريعات يقتصر عند الكتاب والسّنة والرّواية والإجماع بل امتد إلى القياس عند الأغلب والمصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة والأثر العمليّ وعمل العترة وعمل أهل المدينة إلى نظريّة المقاصد والمصالح، والنّوازل في العصر الحديث، فالفقه في جملته تشريعات لم يقل أحد بأنّه مقدّس، ولا حتى الآلة المستخدمة في القواعد التّكليفيّة والوضعيّة والأدلّة الأصوليّة والدّلالات والأقيسة ونحوها بأنّها مقدّسة، ولكن الإشكاليّة في الجمود على المذهب أو بعض الشّخوص، أو استغلال ذلك مجتمعيّا أو دينيّا أو سياسيّا كما أسلفنا، وكذا الحال في التّأريخ والأحداث السّابقة، فهي عادة تكسب القداسة لظروف مشابهة، كما أنّ المتأخر يشوه المتقدّم، وأحيانا الإشكالية في الأقاليم والمذاهب، حيث تتعصب الأمم لتأريخها الإقليميّ والمذهبيّ، وتعطيه نوعا من القداسة والرّمزية، أحيانا يكون نقده جرما يتعرض ناقده للتّشويه والإيذاء المدنيّ، ولكن في الجملة لا يدخل في دائرة المقدّس الدينيّ أو الفقهيّ على أقل تقدير، خلافا لما أسلفنا ذكره.
ولنأت إلى بداية سؤالك من أين نبدأ التّنوير، علينا بداية أن نضيّق دائرة المقدّس، ثمّ نعرف الأماكن المغلقة في المقدّس نفسه، إذ الأصل في النّص أنّه مفتوح ولو كان مقدّسا، ثمّ أن ننتقل من العمل الفرديّ إلى العمل المؤسسيّ، وأن نشجع القراءات وتعددها، وأن تترك الحكومات التّدافع البشريّ يمشي في خطّه السّلميّ والطّبيعيّ، وأن يكون شغلها حفظ العدل والإنسان بعيدا عن مذهبه ودينه وفكره، مع حفظ القانون العادل الّذي يعطي الحريّة بالصّورة الأكبر، وبهذا أتصور أننا سنقترب من التّوازن الطّبيعيّ في لمجتمع، أمّا الأبويّة والمصالحيّة المبالغ حولها فهي تقود إلى الانسداد والتّطرف في النّهاية، كانت هذه الأبويّة دينيّة أم لبراليّة أم حداثيّة، كانت أصوليّة أم علمانيّة.
ـ مجلّة التّكوين: من أسس الفكر قبول الآخر والاعتراف به، إلا أن الملاحظ لدى طائفة كبيرة من حملة الفكر التقليدي ومعهم العامة، غياب ثقافة روح الحوار وقبول المخالف في الرأي، حتى أن الأمر سريعا ما يصل إلى الاتهام في العقيدة والدين .. كيف تقرأ أدب الاختلاف وضعف ثقافته لدينا؟
العبري: الحوار حالة طبيعيّة في المجتمع الإنسانيّ؛ لأنّ الإنسان مدنيّ بطبعه، كما أنّ الاختلاف حالة أيضا طبيعيّة، بل الاختلاف جانب تكوينيّ بين البشر، وعليه قبل الحوار: إقرار حق الذّات المختلف عني أيا كان هذه الاختلاف حتى في وجود الله أو الإيمان بما هو دونه، له حق الشّراك معي في بناء الكون وإصلاحه أمنا وعمارة، ثمّ بعد هذا يكون الحوار والجدال، وأسهب فيه القرآن الكريم، فأمر بالدّعوة إلى الحوار بالّتي هي أحسن، {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [العنكبوت/ 46]، وقلت في فقه التّطرف: “ولفظة أحسن من أفعل التّفضيل، أي على أفضل صورة من صور الحوار، وقد يقول قائل: نستخدم الشّدة مع إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، والاستثناء المراد به هنا في قنواته الخاصة في الحوار، مثال ذلك أن يحدث سب أو ضرب أثناء الجدال، فيكون ردّ الاعتبار بيد الجهات القضائيّة وليس معناه استخدام الشّدة والغلظة والعنف اللّفظيّ والبدنيّ، وإلا لا فائدة من الحوار هنا”، “وإذ اكان الحوار والتّعرف مع أهل الكتاب بالّتي هي أحسن، فإنّ الحوار مع النّاس جميعا والتّعرف عليهم عن طريق هذه الوسيلة يكون بالحسنى كما في قوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة/ 83[“.
ثمّ الانطلاق من المشترك في الحوار، {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران/ 64]، وبعدها يناقش المختلف، حتى نوسع المشترك لأنّه الأصل وهو المحكم بيننا، عكس المختلف.
لهذا رفض الحوار مع الآخر علامة ضعف في الحقيقة، في أيّ جانب من جوانب المجتمع، الفكريّ والدّينيّ والمجتمعيّ، والماليّ، والسّياسيّ، وفي الوقت نفسه لا فائدة من الحوار إذا كنت تلغي الآخر، أو القصد منه الاستعلاء والإلزام، فهنا ينتهي الحوار في الحقيقة!!
أيضا الحوار ينمو كلّما زادت مساحة الحريّة، فارتفع معدله حاليا ليس بسبب الحريّة القانونيّة، أو إرادة السّلطات الثّلاثة بذلك، بقدر ما لازم ذلك الانفتاح الإعلاميّ، بداية من الفضائيات على علاتها، والشّبكة العالميّة، حتى وسائل التّواصل الاجتماعيّ، ومع هذا ظهر في المقابل الجانب السّلبيّ في الحوار نتيجة تقديس الماضويّة أو الرّمز، وما يتبع ذلك من سب وشتم واستخفاف لمن طرح رأيا جديدا أو مخالفا، ولكن المجتمع بفضل هذه الوسائل يتطور يوما فيوما في تقبل الآخر بصورة أسرع من السّابق؛ لأنّ مساحة الحريّة في الإعلام أصبحت أوسع من السّابق بكثير.
مجلّة التّكوين: عملت على تأسيس “لجنة الفكر” تحت مظلة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء .. كيف تقيم هذه التجربة؟ وما هي آفاق نشاطها ومعوقاتها والدعم الذي تتلقونه من الجمعية؟
العبري: لجنة الفكر جاءت بعد فكرة مطارحات أخويّة في جامع الدّعوة في الموالح الجنوبيّة، وملتقى الأربعاء في أحد المطاعم في مسقط، فرأينا الانتقال إلى جانب قانونيّ، فعرض أحد الأخوة من الجمعيّة العمانيّة للكتّاب والأدباء الفكرة وهو الأستاذ صالح البلوشيّ، وحينها كان نائب رئيس الجمعيّة، فلقت مباركة من البعض، ورفضا من آخرين خشية تحجيم حرية الكلمة كعادة النّظرة السّلبيّة إلى المؤسسات الرّسميّة أو شبه الرّسميّة، ومع هذا تشكل فريق من الأخوة لإعداد الفكرة وتقديمها، ورأينا التّسهيل الكبير من الجمعيّة العمانيّة مشكوره، وعلى رأسها المهندس الأديب سعيد الصّقلاويّ.
وشهرت في الأربعاء 12 إبريل 2017م، من خلال أمسية قراءة في كتاب أثر الفقه في السّلوك المجتمعيّ [التّسامح نموذجا] لنبال خباش وأحمد النّوفليّ، وقامت مجلّة التّكوين مشكورة بنشر الورقة المقدّمة في عدد 21، يوليو 2017م، ص 62 – 65، وقد تنوعت الأمسيات بين محاضرة وندوة فكريّة وفلسفيّة وشبابيّة، وحوار مفتوح، وورشات، وقراءة في كتاب ونحوها، وقد عمدنا إلى التّوثيق المرئيّ لمن فاته الحضور، أو لنفتح المجال ليس للذين في عمان فحسب بل حتى خارج عمان للمتابعة، وسجلنا متابعات عديدة في الخارج والحمد لله تعالى، بدليل كثرة السّؤال عن اللّجنة وأمسياتها القادمة، كذلك التّوثيق الكتابي لما يقارب ثلاثين أمسيّة، ونأمل أن يصدر قريبا بإذن الله تعالى.
أمّا عن الأهداف منها فتتمثل في: الرّقيّ بالخطاب الفكريّ في مجتمعنا العمانيّ، ومتابعة الجديد في المجال الفكريّ على المستوى العمانيّ خصوصا والعربيّ عموما، وتعميق ثقافة التّعارف والتّسامح، مع نشر ثقافة الحوار والاعتراف في مجتمعنا، ثمّ التّعاون مع الجهات المختصة والجامعات والكليات والجمعيات فيما يتعلّق بالفكر والمعرفة.
أمّا عن المعوقات فتتمثل في الرّتابة الرّسميّة في بعض الموافقات خاصّة أن يكون الضّيف من خارج السّلطنة؛ لأنّ المجتمع العمانيّ صغير، فنحتاج إلى مفكرين من الخارج، والموافقات تأخذ وقتا طويلا، فنضطر إلى تكرار الأسماء، كذلك عدم وجود دعم، فالأعضاء يبذلون من جيوبهم، كذا لا يوجد تشجيع حضوريّ، لهذا عمدنا إلى التّوثيق، ولسبب أنّه لا زالت نظرة العديد إلى الفكر والثّقافة والفلسفة عندنا نظرة سلبيّة، ومع هذا والحمد لله ونحن في السّنة الثّالثة تجاوزنا العديد من الصّعوبات، وكسبنا العديد من النّقاط أيضا.
مجلّة التّكوين: ـ أيضا لك نشاط حواري واضح على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمتلك قناتك الخاصة على اليوتيوب .. هل هو بحث عن فضاء بديل للمنابر التقليدية التي لا ترحب عادة بالفكر العقلاني وخطاب التجديد الصادم؟
العبري: قديما شجّع القرآن على الهجرة: {قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} [النّساء/ 99]، ويتطلب سابقا استغلال المنابر والأحوال هجرة مكانيّة، أمّا اليوم – والحمد لله تعالى – لا يحتاج عادة هجرة مكانيّة؛ لأنّ الفضاء والهجرة إليه أصبحت مفتوحة، والعالم يعيش في قرية واحدة، فالمساحة إذا ضاقت هنا تنفتح هناك.
لهذا استغلال وسائل التّواصل في نشر الفكرة والمعرفة والتّنوير، حيث اشتغلت بداية على الفيس بوك، وقد ضعف الآن، فكانت فكرة القناة اليوتيوبيّة، ولها إقبال جيد والحمد لله تعالى، فسجلّنا خلال عام ونص بمساعدة الأخوة، وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم الصلتيّ، والأستاذ كمال اللّواتيّ ما يقارب حتى الكتابة اثنتين وأربعين حلقة حواريّة في التّعايش بين المذاهب والأديان والفكر والفلسفة ومعرفة الآخر ونقد الّذات، بجانب حوت حاليا ما يقارب ثلاثمائة مادّة، وقمنا بتوثيق العديد من الفعاليات وتقديما للعالم أجمع، خصوصا العربيّ.
وعليه لا ننتظر ترحيبا أو دعما من أحد، وفي الوقت نفسه لا نكون رهين التّحسر والنّقد فحسب؛ لأني أومن ما من فضاء ضيق إلا وتجد فضاء أوسع منه، فما عليك إلا البحث عن هذا الفضاء واستغلاله، أمّا إذا جلست تبكي، وتنتظر من الآخر أن يفتح لك فلن تتقدّم خطوة أبدا، وستظل تبكي، وغيرك يستغل المساحة المفتوحة ولو استغلالا رجعيا، شريطة أن يكون الاستغلال تأسيسيّا يقدّم الجديد للمعرفة والتّنوير، وليس مجرد نسخ ولصق وإعادة تكرار، وهذا ما سعينا إليه، مع فتح المجال للجميع من الأديان والمذاهب، وحاليا أن نسعى إلى التّيارات خارج التّقليد والنّقد الدّينيّ.
مجلّة التّكوين: ـ أخيرا .. وددنا معرفة مشاريعك ونشاطاتك البحثية والفكرية القادمة؟
العبري: لا أدعي أنني صاحب مشاريع، فأنا رجل بسيط لا أكثر، ومعرفتي محدودة جدّا، ولكن أهم المشاريع الحاليّة هو إكمال مشروع إضاءة قلم، وقد طبع الحلقة الأولى من قبل الجمعيّة العمانيّة للكتّاب والأدباء هذا العام 2019م، وكانت عن التّعايش بين المدارس الإسلاميّة، وسيكون الحلقة الثّانيّة عن التّعارف بين الأديان، والثّالثة عن إحياء العالم العربيّ، والرّابعة عن الإنسان.
كذا نعمل في إكمال مشروع التّفسير الإنسانيّ للقرآن الكريم، وحاليا في سورة البقرة، وهو أول تفسير يعيد مراجعة التّفاسير السّابقة تحت ظلّ ذات الإنسان الواحدة، أيضا مشروع فلسفة الدّولة، وإعادة قراءتها تأريخيّا وأيدلوجيّا من جديد، ونظرة جميع الفلسفات والأديان حولها.
أمّا الكتب القريبة فكتاب اللّجنة الّذي أشرت إليه، وكتاب من هم الزّيديّة (النّشأة والتّصورات والعمل) من خلال الحوار مع الباحثين من المدرسة الزّيديّة أبي الحسن مجد الدّين بن الحسن المؤيّديّ ومحمّد يحيى عزّان، وكتاب الجمال الصّوتي: تأريخه وفلسفته الفقهيّة: مراجعة في النّص الدّينيّ حول الغناء والمعازف.
عموما أشكر مجلّة التّكوين على إتاحة هذه الفرصة وللأستاذ حسن المطروشيّ على إتاحة الحوار.