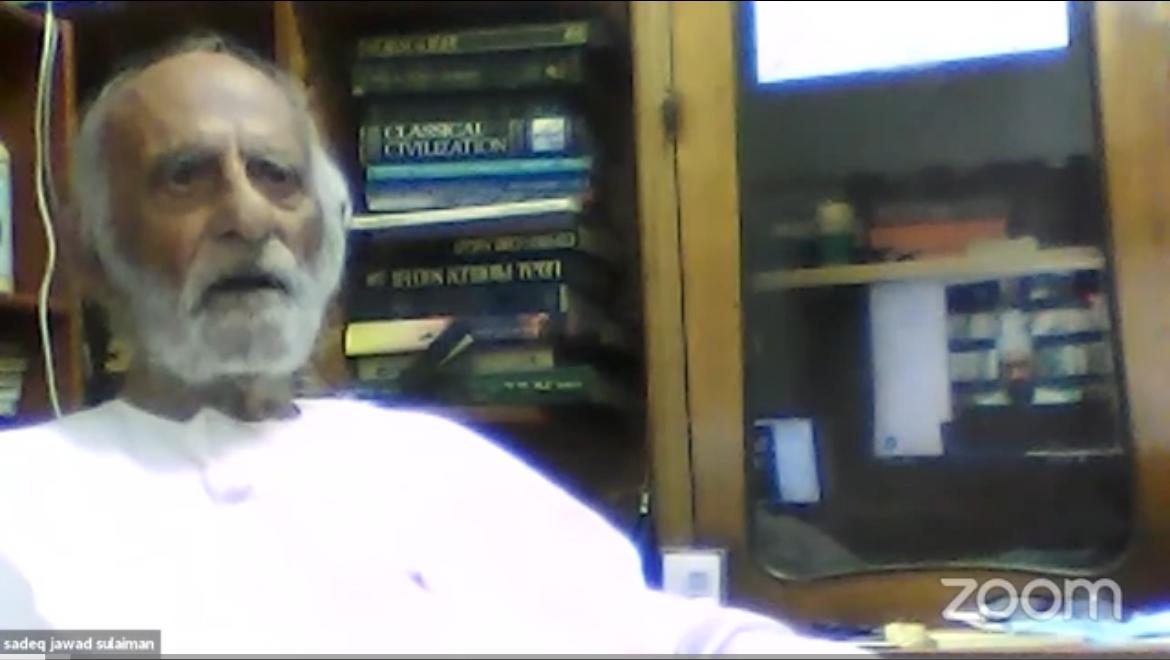ملحوظة: كانت الجلسة بطلب من صادق جواد سليمان، وبسبب “كورونا” أقيمت عن طريق برنامج zoom، يوم الاثنين 12 شوال 1442هـ/ 24 مايو 2021م، في التّاسعة والنّصف مساء بتوقيت مسقط، وبثت مباشرة على قناة أنس اليوتيوبيّة، وهي آخر جلسة حواريّة معه قبل سفره إلى الهند ثمّ وفاته في سفره يوم الثّلاثاء 27 يوليو 2021م.
صادق جواد: الموضوع الّذي عرضته لأتحدّث فيه موضوع معرفيّ يتعلّق ببعض المفردات في اللّغة العربيّة، وتوجد في غيرها من اللّغات أيضا، وهي مفردات إن جاءت منفردة يكاد لا تؤدّي المعنى المتوقع منها، وتكتمل عندما تقترن بمفردات ليستقيم معناها من خلال التّشكّل الثّنائيّ للمفردة، يتضح هذا من خلال الشّواهد، فلو قلنا مثلا: الكفاءة والأمانة، والكفاءة أهليّة الإنسان للقيام بالعمل المنوط إليه، والأمانة تعني أن يدير هذا العمل بشكل مفيد غير منحرف، فثنائيّة الكفاءة والأمانة يعطينا تكاملا في فهم سياق المفردتين، ولمّا بحثت عن هذه الثّنائيّة في القرآن الكريم وجدت في موقعين أتيا بذات الاقتران، ففي قصّة النبيّ موسى، عندما ورد ماء مدين، ووجد هناك أمّة من النّاس، من بينهم وجد امرأتين، ولمّا سألهما: ما خطبكما؟ أجابتا: لا نسقي حتّى يصدر الرّعاء وأبونا شيخ كبير، وقد كان موسى ذا مكنة جسمانيّة جيّدة، فسقى لهما، ثمّ تولى إلى الظّلّ، وقد كان غريبا في مدين، وقال كلمته الشّهيرة: ربّ إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير، وكأنّه يرى هذا المكان وما فيه من مياه وزروع ورعي، وهو فقير إلى هذا كلّه، ولمّا جاءته إحدى الامرأتين وهي تمشي على استحياء، أخبرته أنّ أباها يريد أن يستأجره ليجزيه أجر ما سقى لهما، ولمّا قصّ قصّته لشعيب قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظّالمين، وكاد الحوار أن ينتهي هنا؛ لكن إحدى الامرأتين قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين، فكأنّها سمعت حوار الاثنين، فنصحت أباها أنّ هذا شخصا ذا مكنة جسميّة، وفوق هذا هو إنسان أمين، فمن هذه العبارة يمكن خلاصة أنّ أهمّ مسألتين في ائتمان شخص ما، لعمل ما؛ أن تنظر في الكفاءة والأمانة معا، فقد يكون كفؤا، لكنّه إن لم يكن أمينا هذا لا يضمن لك الحصول على مردود وافٍ في العمل، والعكس صحيح إذا كان أمينا، لكنّه ليس كفؤا لهذا العمل، فلا يتحقّق بذلك المردود الحقيقيّ في العمل أيّا كان نوعه وصفته.
نجد هذه الثّنائيّة أيضا في القرآن الكريم في قصّة سليمان، فلمّا أبلغ بمجيئ بلقيس وحاشيتها إليه، فخاطب من معه {قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} [النّمل: 38]، كان جواب الأول {قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} [النّمل: 39]، هنا جمع بين القوّة والقدرة في إنجاز العمل، وبين من يقوم بالعمل أن يكون على قدر من الأمانة، حتّى لا يضيّع المردود من العمل.
هناك تلازم أيضا بين العلم والحكمة، فالعلم مكتسب، ويجعل حامله مؤهلا لعمل تخصّصه، لكن الحكمة إن لم تردف مع العلم لا تضمن المردود السّليم من العمل، فالحكمة ترشّد استعمال المعرفة العلميّة، وبدونها قد تسخّر المعرفة العلميّة لشيء حسن، أو شيء سيء أيضا.
ومن التّلازم أيضا: المسؤوليّة والمساءلة، فلمّا تأتمن شخصا لعمل ما، وتعطيه مسؤولية إنجاز العمل، الأصل أن يكون مسؤولا عن هذا العمل، فإذا أعفي من المساءلة؛ لن تضمن المردود الصّحيح من العمل، فلا يضمن في غيابها أن يقوم بالعمل على الوجه السّليم.
ومن التّلازم في الاقتصاد أنّه يستلزم زيادة الإنتاج وعدالة التّوزيع، فإذا ركزت على زيادة الإنتاج مع إهمال عدالة التّوزيع؛ هنا يختلّ الميزان، فالإنتاج يزيد، لكنّه يتراكم عند فئة من النّاس، بينما تهمل شريحة عريضة منه، فيختلّ بهذا ميزان الاقتصاد.
وكنتُ قبل يومين من هذا اللّقاء في معرض اختيار القيادات، والعصر اليوم معقّد جدّا، وهو لا يتطلّب الأهليّة العلميّة في الوظائف العامّة فحسب، بل يتطلّب أن يكون متفقا مع البعد الخلقيّ الّذي يؤصّل الحكمة في أداء الموظف أو العامل، وبالتّالي إذا تأثر هذا البعد الخلقيّ بمغريات دنيويّة كثيرة، فأرى أيّ عمل يتطلّب ابتداء المعرفة العلميّة، ويتطلّب معها الأمانة المرتبطة بالبعد الخلقيّ، هذا البعد الخلقيّ ذاته يتطلّب استقرارا في الإيمان، والإيمان لا حدّ له، فكلّما كان المرء موفورا في إيمانه؛ كلّما قوي لديه البعد الخلقيّ، والإيمان عندي ليس محصورا في أيّ ملّة أو دين، وإنّما هو حالة إنسانيّة توجد في أيّ ملّة، وسماته الأساسيّة تتمثل في نقاء الضّمير، وصدق الحديث، وصالح العمل، فإذا استقرّ الإنسان في هذا الإطار الإيمانيّ سيقوى لديه البعد الخلقيّ، والبعد الخلقيّ يرشّد المعرفة العلميّة، لتكتمل المنظومة المنتجة لعمل حميد رشيد، ومردود متكامل في العطاء.
بدر العبريّ: تطرّقت إلى المسؤوليّة والمساءلة، ونجد انحرافا في تطبيقها في العديد من الأنظمة، ممّا يؤدّي إلى فساد في المال العام، أو حتّى في الجانب الإداريّ، ويحدث تغيير سياسيّ ما، فيرى بعضهم لاستقرار الأوطان اللّجوء إلى قوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} [المائدة: 95]، وترك المسائلة لفتح صفحة جديدة في الوطن، ويعترض آخرون أنّ المساءلة في هذه المرحلة لا تسقط، وبها تستقرّ الأوطان؟
صادق جواد: الأنظمة النّاضجة تقرن المسؤوليّة بالمساءلة، هذا لا يعني أنّه بعد حدوث شيء ما تقوم بالاستدراك، وإنّما من الابتداء توجد مساءلة إلى جانب المسؤوليّة كمسألة مستدامة، وبها تستدرك إن وقع خطأ أو تقصير في حينه، وليس بعد وقوع الضّرر.
بدر العبريّ: من أين يأتي مصدر المساءلة، هل من الشّعب أم من جهات معيّنة، كما في الملكيّات الشّاملة، فهي علويّة في اختيار المسؤول ممّا يؤثر على المؤسّسات الرّقابيّة كالبرلمان، أو مؤسّسات العمل المدنيّ؟
صادق جواد: يقع مصدر المساءلة في الجانبين، في جانب المؤسّسات التّشريعيّة، وفي المؤسّسات الرّقابيّة حيث تراقب وترصد وتسائل بين وقت وآخر، ومن جانب آخر أنّ المؤسّسات الّتي تقوم بالعمل فيها أنظمة ترصد أداء العاملين فيها بذاتها، وخارجها طبعا توجد المجالس التّشريعيّة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ ككل؛ جميعها تتكامل في تنشيط بُعد المساءلة والمراقبة والرّصد المستمر وقبل حصول شيء ما، وكلّما نضجت الخبرة والمعرفة في أيّ مجتمع هو يعني بالمسؤولية والمساءلة معا في جميع الأوقات.
زهران العبريّ: إذا كانت الأخطاء في الحكومة بسيطة فيمكن للدّولة التّساهل فيها، أمّا إذا كانت تهدّد استقرار الدّولة فيجب المساءلة والعقاب معا، ولا يصحّ التّساهل حولها.
صادق جواد: إذا كانت الأمور تدخل في نطاق جرميّ تكون المحاسبة هنا قانونيّة، ويدخل في هذا أيّ تقصير عن عمد أو إهمال، وأنا أقصد من المساءلة بشكل عام ليس المعاقبة أو المحاسبة لسبب جرميّ، وإنّما متابعة ما يحصل حتّى تستدرك الأمور في حينها، ويكون الشّخص مُسائلا في أيّ وقت، كما تعمل المجالس التّشريعيّة في مقابلة الوزراء، وكذلك مقابلتهم مع الإعلام.
بدر العبريّ: أنت منذ عشرين سنة تقريبا ذكرت عن الفارق بين القيادة والرّيادة، ما التّلازم بينهما؟
صادق جواد: في المجتمعات الحيّة هناك ريادات منتشرة في جميع المجالات، وهناك أشخاص يحملون أدوارا رياديّة في مجالات تخصّصهم وعملهم، فإذا سمح لهم أن يتولوا منصبا قياديّا يأتون على دراية وافية في العمل أو الموضوع المؤتمنين عليه، ونظريّة الرّيادة والقيادة تتمثل في أنّه كلّما تعمّمت الرّيادات في المجتمع كلّما تهيأ أناس أكثر لتولي مواقع قياديّة، وأحسن القيادات تأتي من أحسن الرّيادات.
بدر العبريّ: تطرّقت إلى موضع الإيمان، كيف تنظر إلى الإيمان التّقليديّ؟
صادق جواد: الإيمان ليس عقائد، هو حالة نفسيّة وعقليّة، وإذا نظرت إلى الأديان تجد فيها عقائد مختلفة، لكن في جميع الأديان يوجد أناس مؤمنون، أي على حال عقليّ سليم نقيّ راق، وتشخيص الإيمان لا يخرج عن الحال الوجدانيّ في الإنسان نفسه، وفي القرآن بصيرة من هذا، كما في الآية {قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 14]، والإسلام هو الدّخول في منظومة العقائد، بينما الإيمان لم يستقرّ في قلوبهم، فهو شيء يحصل في وجدان الإنسان، وهو عامّ في كلّ ملّة، وحتّى عند من لا يؤمن بدين، الخلاصة هو حالة وجدانيّة لا علاقة للإيمان ومعتقدات الأفراد والمجتمعات.
زهران العبريّ: هل الرّيادة تسبق القيادة، وعليه يتمّ اختيار القائد وفق تفوقه في القيادة؟
صادق جواد: نعم، هذا ما أقصده؛ لأنّ الرّيادة تهيئ الإنسان للقيادة، مثلا هناك شخص رائد في مجال التّعليم، وأمضى فترة في هذا المجال، فلمّا يؤتى به في مرحلة متقدّمة ليتولى مسؤوليّة قياديّة، نجد خلفه خبرة ودراية مسبقة عنده، فلا يأتي إلى الوظيفة دون إلمام وخبرة سابقة، والقيادة عموما تكون لأفراد محدّدين، وأمّا الرّيادة فمتاحة لجميع النّاس، والقيادة لمّا تأتي على مستوى الرّيادة تكون أوفى بالمجال المعنيّة فيه.
خليفة الحوسنيّ: تحدّث صادق جواد قبل قليل حول الإيمان، وأنّه حالة إنسانيّة لا ترتبط بدين معيّن، وسلامة الضّمير يولّد عطاء للإنسانيّة، وإذا أسقطنا هذا على الواقع المحلّي فلدينا حالة إيمانيّة بأهميّة صناعة القيادة، من البرلمان وحتّى مؤسّسات الدّولة، إلّا أنّها لم تثمر في صنع قيادات بشكل كبير، وكانت فعاليّتها محدودة، فأين الخلل في نظرك؟
صادق جواد: ذكرت الجوانب التّشريعيّة والبرلمانيّة، ومجالس الحكومة، هذه لا علاقة لها فيما ذكرت في بداية سؤالك، قد تجد إنسانا بسيطا في حقله أو مزرعته تولد لديه نقاء في الضّمير، وصدق الحديث، وصالح العمل، فالمسألة الإيمانيّة حيث ما توجد تضفي شيئا على الإنسان، في أيّ موقع كان، فإذا كان ذا استقرار إيمانيّ؛ لا تجد لديه خصومات مع النّاس، أو أفكارا سامّة كالجشع والكراهيّة، وهي حالة وجدانيّة عند أيّ فرد كان، بعيدا عن موقعه [الدّينيّ والفكريّ والثّقافيّ والاجتماعيّ]، فالإيمان لا يُصنع اجتماعيّا، وإنّما هو حال يحصل في الإنسان، وحيث ما يحصل تجده يعطي رقيّا روحيّا في هذا الإنسان، فهذا المزارع البسيط تجده أرقى من صاحب المنزلة الاجتماعيّة أو الإداريّة ممّن لم يتحصّل لديه هذا الإيمان، وهو عموما يضفي شيئا على الإنسان أيّا كان موقعه في السّلطة أو المجتمع أو القيادة.
خليفة الحوسنيّ: التّلازميّات الضّروريّة المتعلّقة بتلازميّة الانضباط الإنسانيّ لا نجدها متوفرة في مجتمعنا، وفي الجانب الآخر إلى أيّ مدى ممكن حضور الرّقابة والمساءلة كأداة ناجحة لتصحيح المسار؟
صادق جواد: لا يوجد في أيّ مجتمع وضع مطلق للإصلاح، وإنّما تسعى إليه، حال هذه المجتمعات كحال الإنسان الفرد يكون في اجتهاد مستمر لإصلاح نفسه، فهو في تجربته يرتقي، ولا يوجد حدّ لارتقائه، فلا يوجد هناك نقطة تتوقف عندها، وإنّما تكون في حال اكتمال مستدام، وهذا ذاته ينطبق على المجتمعات أيضا.
زهران العبريّ: إذا جئنا إلى متلازمة الكفاءة والأمانة باجتماعها مع الرّيادة والقيادة، هذه الرّيادة والقيادة تجتمع مع الكفاءة، لكن كثيرا ما يحدث الخلل في الأمانة، حتّى مع وجود الرّيادة والكفاءة، وأرى سببها في نظري تقديم مصلحة الشّخص على مصلحة الدّولة.
صادق جواد: مجتمعات العالم جميعها تشتكي من الفساد، والفساد يأتي من قبل النّاس أنفسهم، لكن في خضمّ الحراك الإنسانيّ يوجد تدافع بين الخير والشّرّ، وبين الصّلاح والفساد، وأتّفق معك أنّ الأمانة ليست موفورة دائما بالقدر المرجو من توفرها، وهذا في جميع المجتمعات، وأحيانا نجد عدم توفرها عند أناس لديهم درجة من العلم والثّقافة والتّجربة، هذا كلّه شيء، والشّيء الآخر أنّ جانب الأمانة المتعلّقة بجانب الإيمان لا نجده موفورا كما ينبغي أن يكون، والأمانة مسؤوليّة كبيرة جدّا حتّى في القرآن الكريم، ولا تنحصر في الإنسان نفسه، {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: 72]، وهذه رمزيّة في أنّ هذه الكائنات أدركت عدم توفر المكنة والأهليّة لديها لتحمّل الأمانة، وبادر الإنسان في حملها، ووصفه القرآن بأنّه ظلوم جهول، ونحن مقصّرون جدّا في جانب الأمانة ليس على مستوى الدّولة والحكومة فحسب، بل حتّى في شؤوننا الاعتياديّة، وصلاح الأمانة لا يتوقف عند التّلقين، لكنّها تحتاج إلى شيء من التّهذيب في الذّات، وترويض النّفس، فهناك إغراءات في الحياة تبعدك عن أداء الأمانة على الوجه الأوفى.
خليفة الحوسنيّ: بما أنّ هذه التّلازميّات عابرة للأديان، كيف نقرأ نجاح مجتمعات في تحقيقها أو الاقتراب منها، وفشل مجتمعات أخرى، وفي مجتمعاتنا جرّبنا الاشتراكيّة والرّأسماليّة وفشلنا، ولا زلنا متأخرين عن الآخرين؟
صادق جواد: الإنسان يسعى نحو الأصلح والأمثل والأفضل من حيث هو، فإن وجدت قصورا فعلى الأقل أن تعي بوجود هذا القصور، وتعمل على سدّه وإصلاحه، وهناك تداخلات عديدة في الحراك الإنسانيّ، كالنّظم الفلسفيّة، لكن المجتمع الّذي يعي بأن يوجد توازنا في سياقه، بحيث يكون التّوازن مرجّحا لصالح الأصلح والأمثل،؛حينها يسعى إلى تحقيق ذلك، والجميع يشترك في خلق هذا الوعي في أيّ مجتمع كان، مستمرا في ذلك دون توقف، فالمجال مفتوح لهذه المجتمعات لأجل الارتقاء بدون حدّ يحدّها، وكمالها مستمرّ لا يتوقف عند مرحلة زمنيّة معيّنة.
زهران العبريّ: نعود مرّة أخرى إلى قضيّة المساءلة والمحاسبة، عندما يُتعمّد في سرقة أموال الدّولة كما في المناقصات، أو الاختلاسات، ونهب الأراضي، وتعيين الأقرباء في المناصب، أين تكمن المحاسبة هنا، هل في البرلمان، أم يتجاوزه؟
صادق جواد: الدّولة تشرّع في هذا المجال، وتحدّد العقوبات، وتضع المنهج لمحاسبة الفرد أمام المحاكم، فإذا تقاعست الدّولة تفشى ذلك، والدّولة هي الحكومة والمجتمع، والمجتمع يشارك في المساءلة، فإذا أدرك المجتمع أهميّة دوره في المساءلة يسهم هذا في عدم وقوع الخطأ؛ لأنّ المساءلة سابقه تداركا لعدم وقوع الفعل، لأنّه إذا حدث الفعل قصدا أو عمدا أو إهمالا أو نتيجة سوء استغلال للسّلطة فهذا له قوانينه في العقاب والمساءلة عموما.
بدر العبريّ: فيما يتعلّق بالرّيادة والقيادة، هل يمكن تحقّق الرّيادة في العمل السّياسيّ مع عدم وجود أحزاب تفرز قيادات مؤهلة في هذا الجانب؟ خصوصا في المجتمعات الّتي يصعد وزراؤها خدميّا من الأسفل لا من الأعلى؟
صادق جواد: قضيّة الأحزاب السّياسيّة عمّت غالب العالم، لكن المشكلة عندما تنحرف عن غاية الحزب، لأنّ فكرة الأحزاب هو تكتل الرّأي حول منهج معيّن، وبعض الدّول لها خبرتها في هذا، وغيرها مثل نقابات العمّال، لم تكن معروفة في مجتمعاتنا، لكنّها أصبحت لاحقا لها حضورها وتقنينها، ولها عملها ووظيفتها، واليوم نحن لا نعيش وفق تجاربنا فقط، فحتّى مؤسّساتنا تعمل على أفكار صنعت في الخارج، كما في الشّرطة والصّحة والماليّة والرّقابة وغيرها جميعها منظومات للعمل ابتدعت في أماكن أخرى، وتمّ اقتباسها، وهذا حسن، ولكن بعد الاقتباس لابدّ أن تُعنى بحصانتها وسلامتها، فكذلك الأحزاب، فإذا حان الوقت لوجودها فلابدّ من وجودها على وجه صحيح، فتخاصم الأحزاب ذاتها مؤثر في الجانب الإداريّ ذاته، فحياة الإنسان اليوم معقّدة، وتحتاج إلى نظر وافر وشامل، ولا يقتصر النّظر عند جهة واحدة معيّنة وقاصرة.
زهران العبريّ: في نظري أنّ الأحزاب في مجتمعنا لها مخاطرها، ونحن لا زلنا في مهد التّفكير السّياسيّ؟
صادق جواد: الأحزاب لا تُحصر في المخاطر والمساوئ، وإنّما تقرأ وفق التّعقيدات الّتي تحصل عند تنظيم المجتمع السّياسيّ، فأن تكون لك قدرة في إدارة المسرح السّياسيّ الّذي يقوم على الأحزاب؛ هذا يحتاج إلى تجربة وخبرة، ولا شيء ممتنع على أيّ مجتمع إن أراد أن يقتبس مثل هذا في تنظيم واقعه، وعندي أهم شيء في المجتمعات غير المكتملة سياسيّا أنّها تقوي المجتمع المدنيّ، مثل الجمعيّات المدنيّة، فهذه وظيفتها أن توجد أمام الرّأي العام ما تنتهي إليه من اجتهاد في الشّأن الوطنيّ، فلا تتوقف عند اسمها، بل لابدّ أن تتقدّم من واقع خبرة أعضاءها في بناء الاجتهاد الوطنيّ، ويكون اجتهادا متكاملا مع المؤسّسات التّشريعيّة، والجهات التّنفيذيّة والرّقابيّة، ولا يعني الاجتهاد الوطنيّ أنّ تتوقف عند ما تعمله الحكومة فقط، بل هو اجتهاد ينبت من واقع اجتهاد العمل المدنيّ، والمجتمعات المتقدّمة تكوّن لها مؤسّسات ومراكز للفكر، وكيفيّة التّعامل مع القضايا الوطنيّة، لتخرج ما عندها من اجتهاد ورؤى ونصح وتبصير لهذه الأمور.
زهران العبريّ: مشكلة الاقتباس من الخارج عندنا أننا نقوم بتشويهه بدلا من تطويره والاستفادة منه؟
صادق جواد: توقفك عند مصطلح الاقتباس جدير بالانتباه؛ لأنّ الاقتباس غير التّقليد، والاقتباس كلمة في اللّغة ذات معنى رفيع، فعندما تقتبس من شيء لا ينقص ما تكتنزه أنت من الجهة المقتبس فيها، كقبس النّار لا ينقص من أصل شعلتها شيئا، فالاقتباس بمعنى آخر عندما تأخذ الفكرة من الخارج هذا لا يعني أنّك تقتبسها بكامل تفاصيلها، وإنّما تأخذها كفكرة، وفي الدّاخل عليك أن تخضعها لما يتناسب عندك من ظروف، وتطوّره إلى الأحسن والأفضل حتّى لا يشوه، ويكون أقرب إلى التّقليد الأعمى، فلا غنى لأيّ مجتمع أن يقتبس ما يراه حسنا وصالحا له من المجتمعات الأخرى، مثلا لمّا اقتبس المسلمون الأوائل علوم اليونان، لم يتوقفوا عند الاقتباس، وإنّما طوروه وأبدعوا فيه.
جمعة اللّواتيّ: ما قراءتك لمستقبل مؤسّسات المجتمع المدنيّ عندنا، فلا زالت تراوح نفسها، لا تقدّم ولا تؤخّر شيئا؟
صادق جواد: أنت الآن في موقع تتحسّف فيه على نقاط الضّعف في مجتمعك، والمسألة في نظري هي ليست خطوة واحدة، وإنّما نهج تستمرّ عليه وتطوّره، وأرى أنّ الخطوة الأولى هو تلاقي العمانيّين مع بعضهم بعضا، وأن يشاركوا بعضهم في الحوار والتّفكير وطرح الأفكار، وهذا الّذي يولد المجتمع المدني، وهذا الّذي يصنع الاجتهاد والوعي بالّذي تريده، وإن كان بشكل غير مباشر، لكنه يتقدّم بوعي متراكم، ونحن هنا لا نتعامل مع جيل واحد، وإنّما مع أجيال متعاقبة.