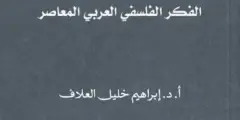استخدام لفظة التجديد ليست جديدة في الموروث الفقهي التراثي الإسلامي، فبعضهم يعودها إلى رواية: إنّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها، إلا أنّ هذه الرواية أقرب إلى الفردية فيمن نبغ في الاجتهاد، فهناك عالم يشذ عن أقرانه أو عن الصورة النمطية للجو السائد في المجتمع ليس بالضرورة أن يكون ناقدا عقليا، كما حدث للشوكاني ت 1839م مثلا في المدرسة الزيدية.
أما التّجديد بهذا المصطلح لم يرد في القرآن الكريم، ولكنه ورد بما هو أخص من ذلك كالنقد والتعقل والنظر والسمع والتدبر والنهي عن تقليد الآباء، والسير في الأرض سيرا عقليا وبحثيا كقوله تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}، وقوله: {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ}، وإذا كان الله تعالى أمر بالتدبر والنظر في آيات كتابه، فمن باب أولى إسقاط ذلك على ما دون كتابه من تراث بشري وحضاري وإنساني.
ومع هذا شاع حديثا مصطلح التجديد حتى صار مادة بنفسه يدرس في بعض المعاهد والجامعات الشرقية.
وقد كان التجديد بداية مع وجود الحركات الإصلاحية في عهد محمد علي باشا ت 1849م، وإرساله البعثات العلمية إلى أوربا، وبعضهم يرجع ذلك إلى حملة نابليون على مصر عام (179-1801م)، ومع فشل الحملة وقصر مدتها؛ إلا أنّه كان لها الأثر العلمي والاجتماعي في مصر.
في حين يرى آخرون أنّ الدراسات البحثية الاستشراقية كان لها الدور الأكبر في تحريك المياه الراكدة، ووضع لبنة البحث العلمي الأكاديمي على القائم على المنهج العلمي الشكي في ذلك.
ومع هذا يعتبر القرن العشرون انطلاقة في هذا الطريق بداية من الإمام محمد عبده ت 1905م في مصر، وحركته الإصلاحية التجديدية، وقيام حركات إصلاحية أخرى كالحركة البيوضية ت1981في الجزائر مثلا، وهي وريثة لهذه الحركة في تجديد الفكر والخطاب في التراث الإباضي على الخصوص، بجانب كتابات الشيخ محمد الغزالي ت 1996م ومحمد حسين فضل الله ت 2010م مثلا.
والتجديد في البداية وجد صراعا انصب بين مدرستين مدرسة الأثر أو السلف، والتي تعتصم بكل ما هو موروث، وتعتبره مقدسا، ومدرسة يطلق عليها بالتغريب، والتي ترى رفض كل ما هو موروث، وتقبل كل ما هو غربي جديد في الفكر والعادات والتقاليد.
هنا كانت مدرسة التجديد وسطا بين الفريقين، فهي مع الأولى في الثوابت، ومع الثانية في المتغير والاستفادة من الجديد.
إلا أنّه نشأ جيل جديد منذ ثمانيات القرن الماضي تجاوز مرحلة الوفاق، إلى مرحلة النقد حتى للثوابت ذاتها، ومعرفة ما هو ثابت وما هو غير ثابت أصلا، كمراجعة نقدية للذات قبل الاستفادة من الفلسفات والمناهج المعاصرة.
عموما هذه مقدمة تاريخية ضرورية لفهم والانطلاق للموضوع، والأمر المفرغ منه ضرورة التجديد في الخطاب في قضايا الأمة المعاصرة، وهذا الجزء الآخر للتجديد في الفكر، والأصل الثاني، والأول نتائج، وهناك تجديد في الوسائل، وهو رابط بينهما.
أمّا القضايا المعاصرة فلا شك هناك العديد من القضايا وعلى رأسها القضايا الفكرية الكلية، والقضايا التربوية، والمجتمعية، والخلقية، بجانب القضايا الاقتصادية والإعلامية والسياسية.
هذه القضايا المعاصرة بحاجة إلى تجديد الخطاب الديني حولها لأسباب عدة وعلى رأسها العولمة أو الكوكبة المعاصرة، نتيجة قرب العالم إلى بعضه، فاندمجت الثقافات ببعضها، وسهل التواصل بين البشر، حتى أصبح العالم قرية صغيرة، ولذلك كان الجديد في كل وقت، بجانب أنّ الهيمنة الإعلامية كانت للأقوى، وهي التي تفرض ثقافتها وفكرها على الأضعف، سواء كانت هذه الهيمنة سياسية أم اقتصادية، ولكوننا نحن الأضعف كنا ثلاثة فرق: الأولى انجذبت كليا ورفضت الأصل، واعتبرت الهيمنة فتحا مبينا، فتأثرت فكرا وسلوكا، وفريق آخر ارتد واعتبرها كفرا بواحا، مما تشكلت بعض المجموعات المتشددة والتكفيرية لكل ما هو جديد، وفريق آخر بقى متذبذبا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
كلّ هذا أوجد للجيل الجديد ازدواجية في التفكير، مما أحدث عند بعضه ردة عن الدين كليا، وتصورا أنّ هذا الدين ليس ملائما للواقع، فهو نزل قبل ألف سنة في صحراء عربية متوحشة، فلا ملائمة له والواقع المعاصر الذي وصل القمر، ومما زاده إيمانا هذا التطرف الديني، والتشدد في قضايا فرعية، وزاده سوءا انشغال هذه الجماعات بتكفير بعضها، ولعن أسلاف وخلف بعضهم بعضا، بجانب الجماعات الدموية في العالم النامي باسم الجهاد والإسلام، وعليه كيف يصلح هذا الدين أن يكون رحمة للعالم جميعا!!!
من هنا كانت ضرورة تجديد الخطاب ملحة والذي ينطلق بداية من العودة القرآنية، والذي جعله الله تعالى في محاور ثلاثة تنطلق منها الأجيال على مر العصور: النور والهدى، والتصديق، والفرقان، فهو في ذاته نور وهدى، ومصدق لما وافقه، وفرقان لما خالفه.
ثمّ إنّ التراث البشري ليس وحيا منزلا، واجتهاد الفقهاء ليس قرآنا يتلى، وإنما هو اجتهاد بشري يستفاد منه كما يستفاد من أي تجربة بشرية أخرى.
إذا انطلقنا من هذا بداية سنجد أنفسنا أمام حديقة واسعة من التجارب البشرية على اختلاف مذاهبها الدينية، وأطيافها الفكرية والسياسية، وعليه سيكون الدين – كما في الأصل – منفتحا على الجميع، منطلقا من الماضي وليس منغلقا عليه، متمسكا بالأصالة وليس متعصبا لها.
من هنا سيتغير الخطاب ذاته تلقائيا، لأنّه سيجد بيئة تتقبل أي نقد علمي لذاتها وللواقع على مختلف قضاياه، وعلى تنوع معارفه، في حين لو وجد بيئة تتعامل مع بسلبية كبيرة من تكفير وتبديع وإقصاء مجتمعي أو وظيفي؛ هذا بلا شك سيجعل الخطاب من الجميع متطرفا.
هذا بالنسبة للقضايا الفكرية، فنحن بحاجة إلى مؤسسات تجديدية، تنطلق من نقد منهجي علمي، يكون لها رؤيتها في الإصلاح المجتمعي، والنقد الذاتي، ولا يقتصر فحسب على المقالات والمؤتمرات السريعة.
وكذا الحال في القضايا المجتمعية والتربوية، والاستفادة من التجارب المعاصرة، والأبحاث العلمية الأكاديمية، خاصة وأنّ الأمة لا زالت تعاني من المشاكل التربوية، والقضايا المجتمعية الخلقية، نتيجة الطفرة المعاصرة في وسائل التواصل، مما شكل جماعات معاصرة تتفنن في الجرائم بمختلف صورها، مما زاد معدل الانحراف وانتشار الفساد الخلقي، بجانب ضعف الجانب التربوي والقيمي، وعليه البقاء على الخطاب القديم لن يعالج شيئا إن لم يزيده سوءا، مما يلزم ضرورة إلى وجود خطاب تربوي ووعظي وقيمي اجتماعي يعاش الواقع، منطلقا من مؤسسات بحثية ومعرفية، إلى مراكز التدريب والاستشارة، فالتطبيق الإعلامي والواقعي.
وهكذا الحال أيضا في الجانبين الاقتصادي والسياسي، نتيجة الطفرة المعاصرة في الإنتاج والسوق، والتقدم السياسي والقانوني، يجعل ضرورة تجدد الخطاب في الجانبين، وأن يكون ملائما للحال.
وكما أنّ التجديد كما أسلفتُ يكون في القضايا ذاتها يكون أيضا في الأساليب المتعلقة بذلك، ولا يمكن في هذا اللقاء السريع تعداد ذلك، ولكن مما يشار إليه ضرورة نحن بحاجة في الشرق إلى مراكز دارسية بحثية فكرا وميدانا، بحيث تبحث في الواقع بحثا علميا منهجيا، وتشمل الميدان والإحصاء، وليس مجرد مؤتمرات تغلق توصياته برجوع باحثيه، وإنما مراكز متخصصة في مختلف الجوانب والقضايا التي أسلفنا في ذكر بعضها، والتي تخلص إلى نتائج وتوصيات يعمل بها وفق رؤية زمنية ومكانية ومالية، وعلى مختلف الشرائح المجتمعية، وبحث الوسائل لتحقيقها، مع نقد ذات النتائج هذه لتعالج ذاتها، وتعايش واقعها، وتواصل مسيرها، وأن يكون العمل مؤسسيا تتواصل في الأجيال جيلا بعد جيل، وأمة بعد أمة.
فالوسائل التجديدية في الخطاب ناتجة عن الاستفادة من الواقع في كافة جوانب تطوره، ويكون الخطاب ذاته ملائما للواقع ومعاصرا له فكرا ووسائلا.
وبهذه المناسبة لابد أن تتخلص الأمة من خطابها الطائفي الذي يجعلها تعيش في صراع الماضي، ليكون الخطاب قرآنيا منطلقا من الذات والواقع إلى الاستفادة من التجارب البشرية بمختلق توجهاتها.
ولابد من الاستفادة من التعددية، وأنّ التعددية بناء وليست هدما، والتعامل مع التعددية على أساس المشترك من المواطنة وفق القانون الجامع للجميع.
بهذا بلا شك سيتشكل خطاب جديد يدرك في هذا الجيل وغيره عظمة هذا الدين، والذي فتح لهم باب الأفق للنظر والتفكير والتدبر، وكان منطلقا لهما لبعث هذه الرحمة الربانية في العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
جريدة عمان 1436هـ/ 2015م