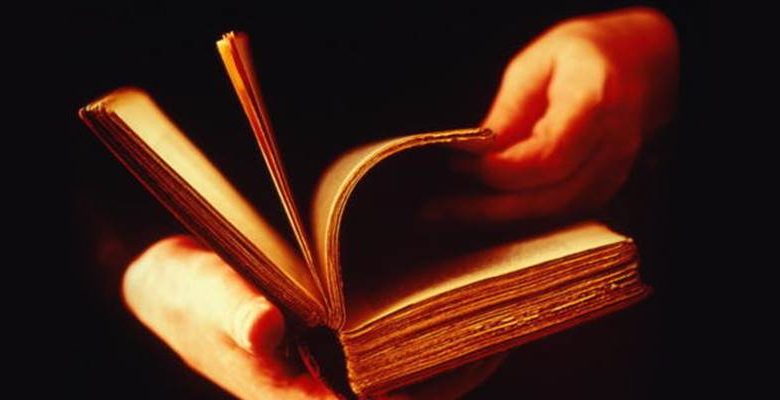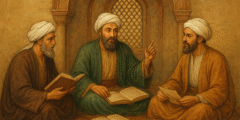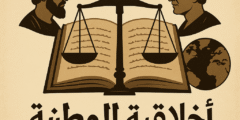جريدة عُمان 1444هـ/ 2022م
من أكثر الجدليّات المتعلقة بالنّصّ الدّينيّ قديما وحديثا قضيّة تاريخيّة النّصّ، فتارة يتعلّق بتاريخيّة النّص، وتارة بتاريخانيّة النّصّ، ويفرق محمّد النّعيميّ بينهما أنّ “الفرق بين التّاريخيّة والتّاريخانيّة في أنّ الأولى تربط الظّواهر والحقائق والمعتقدات والنّصوص الدّينيّة بزمن نشأتها التّاريخيّة، بينما ترى الثّانية أنّ هذه الأحداث تتطوّر مع التّاريخ نتيجة ارتباطها بالظّروف التّاريخيّة، والقول بتاريخيّة النّصّ يعني أنّ النّصّ حادث في زمن معين، ومتعلق ببيئة معينة، وأحداث معينة، فهو يعالج أوضاع تلك المرحلة الزّمنيّة من عمر التّاريخ وأحداثه، وهو ليس معنيّا بالأحداث والأوضاع الّتي بعد تلك المرحلة الزّمنيّة”، فالتّاريخيّة “مذهب يقرر أنّ القوانين الاجتماعيّة تتصف بالنّسبيّة التّاريخيّة، وأنّ القانون من نتاج العقل الجمعيّ”، والتّاريخانيّة “تعتبر التّاريخ مبدأ وحيدا لتفسير كلّ الظّواهر المرتبطة بالإنسان بما فيها الدّين، فالتّاريخ يكفي نفسه بنفسه”.
وبعيدا عن جدليّة المصطلح، ثمّ بعيدا عن جدليّة العقلنة قديما، والأنسنة حديثا، نجد أيّ نصّ كان له ظاهر يقرأ وفق منطوقه، وهو ما يعبّر عنه بحرفيّة النّصّ، فهذا النّصّ إمّا أن يتعلّق بقضايا في الأصل مطلقة كالغيبيات والماورائيات والأخلاق والقصص، وأمّا ما يتعلّق بالنّصوص المرتبطة بعلاقة الإنسان مع الآخر على مستوى الجنس كالدّولة، أو على مستوى الأفراد كالمعاملات، أو على مستوى الجزاء كالحدود ونحوها، فهذا لا يمكن جعل جميعها مطلقة، وإنّما نجدها نصوصا متحركة ومفتوحة، ولهذا يقودنا إلى التّأويل الزّمكانيّ.
هناك من يرى كلّ نص هو مفتوح ومتحرك، وهذا بمعنى التّأويل الشّموليّ، ولولا حركة النّصّ لما رأينا هذه التّعدديّة في المذاهب والرّؤى الّتي تمتلئ بها المكتبات من مخطوطات ومطبوعات وكتب لا تتوقف في قراءة النّصّ جيلا بعد جيل، فعلم الكلام أو اللّاهوت الإسلاميّ ذاته مثلا، مع ارتباطه بالغيبيات والماورائيات، إلا أنّ النّصّ الواحد ذاته نجد له تأويلات متباينة بين أهل الحديث الواقفين عند حرفيّة النّصّ، مع التّوسع في النّصّ الثّاني، وبين المعتزلة الأكثر انفتاحا في التّأويل، وتحجيما للنّصّ الثّاني، بينما يتراوح الأشاعرة والماتريديّة بينهما.
فإذا ما دخلنا في القراءات الباطنيّة للنّصّ الدّينيّ، من غنصوصيّة عرفانيّة وصوفيّة، سنجد التّأويل الباطنيّ حاضرا للنّصّ، ما بين الظّاهر والباطن والحقيقة، وما بين حرفيّة النّصّ ورمزيته، ليتوسع بعضهم في تأويلات حتّى الطّقوس الدّينيّة الّتي يتشدّد فيها الظّاهريون من أغلب الفرق الإسلاميّة، ولا يتجاوزن العلّة القاصرة (الحِكمة) فيها في الجملة، لهذا سنجد عند الباطنيين تأويلات للصّلاة والصّيام والحج والقبلة وغيرها.
فإذا ما تجاوزنا هذا كلّه، سنجده البعد الظّرفيّ [التّأريخيّ] منذ فترة مبكرة؛ بل في حياة الرّسول –صلّى الله عليه وسلّم – نفسه، وهنا يضرب الأصوليون مثلا برواية ابن عمر [ت 73هـ] أنّ رسول الله –صلّى الله عليه وسلّم – قال لأصحابه: “لا يصليّن أحد العصر إلا في بني قريظة”، فأدركتهم العصر في الطّريق، فانقسم حول النّصّ فريقان، فريق لم يتجاوز ظاهر النّصّ، وقال لا صلاة للعصر إلا في بني قريظة ولو خرج وقتها، وفريق آخر أدرك أنّ المراد من النّصّ ليس ظاهريّته، وإنّما هو حث على السّعي والحركة، وليس المراد تأخير الصّلاة عن وقتها، والنّبيّ أقر الفريقين، هذا التّعامل مع النّصّ سنجده حالة طبيعيّة في الفقه الإسلاميّ يلازم المتعامل مع النّصّ طيلة التّأريخ الإسلاميّ.
وفي اجتهادات عمر بن الخطاب [ت 23هـ] ستتشكل بذرة التّأويل الظّرفيّ من حيث العلليّة، فهو مفتوح قابل للتّأويل، وبه يدخل الإنسان في التّعامل مع النّصّ حسب فهوماته من جهة، وحسب الزّمكانيّة من جهة ثانية، كاجتهاده في سهم المؤلفة قلوبهم، واعتزال البلد المبوءة بالدّاء، وقضيّة الطّلاق بالثّلاث وغيرها، ليتشكل لاحقا علليّة النّصّ عند الأصوليين، ليدور النّصّ مع العلّة وجودا وعدما، ثمّ ارتباط النّصّ بالمصلحة، فأينما تكون المصلحة فثمّ شرع الله، حيث ينفتح المجتمع على حضارات وثقافات، ويمتدّ إلى بيئات مختلفة، ولولا ضيق المقالة لذكرت مصاديق عديدة في ذلك.
وأضرب نموذجين معاصرين في ذلك الأول في القضايا الطّبيّة، فيرى محمّد سليمان الأشقر [ت 2009م] أنّ “الأحاديث … الّتي تدخل في صلب الأمور الطّبيّة والعلاجيّة، وليست من أحاديث الفئات المذكورة في النّوع الأول [أي حكم أصل العمل بالطّب والتّداوي به] لا ينبغي أن تؤخذ حجّة في الطّب والعلاج، بل مرجع ذلك إلى أهل الطّب، فهم أهل الاختصاص في ذلك …. ونقلنا قوله – صلّى الله عليه وسلّم – لأهل النّخيل والزّراعة: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فشؤون الطّب الصّرفة هي من هذا، فأهل الطّب هم أهل الحذق والمعرفة بها، وإليهم المرجع في هذا الباب، وقد يتبيّن في شيء من هذا الأحاديث الخطأ من النّاحيّة الطّبيّة الصّرفة، ولكن كما قال القاضي عياض [ت 544هـ]: ليس في ذلك محطّة ولا نقيصة؛ لأنّها أمور اعتياديّة يعرفها من جرّبها، وجعلها همّه، وشغل نفسه بها، ولذا يجوز على النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – فيها ما ذكرنا، يعني الخطأ والصّواب” .
والنّموذج الثّاني ما ذكره حسين الخشن أنّ “الحكم الصّادر عن النّبيّ – صلّى الله عليه وآله وسلّم – بصفته التّشريعيّة، وكوّنه مبلغا لوحي الله [يفيد الإطلاق]، وأمّا الحكم الصّادر عنه – صلّى الله عليه وآله وسلّم – بصفته قائدا للمجتمع، وما يسمّى بالحكم التّدبيري أو الولايتي أو السّلطاني فالأصل أن يكون ظرفيّا وليس دائميّا”.
هذه العلليّة أو المصلحيّة بعيدا عن جزئياتها ومصاديقها أصبحت تدرس كجزء من تأريخيّة النّصّ، والّذي يتجاوز الزّمكانيّة إلى القيم المرتبطة بالماهيّة الإنسانيّة، فهي قيم مطلقة عابرة للظّرفيّة الزّمكانيّة، وهذا ما يعبّر عنه صادق جواد [ت 2021م] أنّ هناك “مبادئ عامّة، فيبقى شغلنا في المبادئ والأحكام، فالمبادئ أيضا تبقى كما هي؛ لأنّه لا ينظر إليها أنّها أتت من السّماء، وإنّما ينظر إليها لأنّه بها تكون صيانة الإنسان، فهي إنسانيّة عامّة، ولها صحة وثبات مستدام، وأمّا الأحكام فهي معلولة بعللها، أي أصبحت ظرفيّة، وهي موصولة بالمبادئ”، “فعندما نقول إنّ المبادئ لها صحة وثبات مستدام فهل نقول إنّ للأحكام كذلك؟ فالأحكام لمّا كانت متسقة مع المبادئ في حينها لم تعد متسقة في حين آخر، فإذا كان لابدّ من تغيير أو تطوير فيكون في الأدنى أي الحكم وليس المبدأ، فالأحكام جوانب إجرائيّة تتحرك بما تفيء بمتطلبات المبدأ”.
فبعيدا عن جدليّة [الظّرفيّة – المصلحيّة – القيم المطلقة أو المبادئ]، إلا أنّ مدار النّصّ بين الظّرفيّة والتّدبير والإطلاق، وهي متعلّقة بتاريخيّة فهم النّصّ ذاته وإنزاله، ليست نزعة حداثيّة جاءت من الخارج، بقدر ما هي حاضرة طيلة الاجتهاد الإسلاميّ منذ فترة مبكرة – كما أسلفنا -، وهذا ما يشير إليه محمّد باقر الصّدر [ت 1980م] أنّه “حينما يتحوّل النّسبيّ إلى مطلق إلى إله من هذا القبيل؛ يصبح سببا في تطويق حركة الإنسان، وتجميد قدراته على التّطوّر والإبداع، وإقعاد الإنسان عن ممارسة دوره الطّبيعيّ المفتوح في المسيرة”.
إلا أنّ تراكمات القراءات المعاصرة وتدافعها، والّتي جاوزت القراءات الأصوليّة التّقليديّة، ومع أهميّتها التّأريحيّة، إلا أنّها – في الجملة – جمدت عند القراءات الأصوليّة الأولى في فترة مبكرة ما بعد النّصّ، ليتدافع العالم اليوم في القرارات ما بعد البنيويّة، كشيوع المدرسة التّفكيكيّة أو التّقويضيّة المرتبطة بالفيلسوف الفرنسيّ جاك دريدا [ت 2004م]، والّتي قوّضت الحداثة، متمردة على المدارس النّصيّة والفلسفيّة والحداثيّة السّابقة، مع تشكل قراءات ومدارس معاصرة، لم تتوقف عند النّصوص الأدبيّة والإنسانيّة، لتتجاوز القراءات الدّينيّة ذاتها، ثمّ إنّ الحداثة وما بعد الحداثة أيضا لها تأثيرها الكبير في تأريخيّة النّصّ، لتشتدّ الحاجة إلى محاولة حفر أكبر ينفتح فيه العقل المسلم على القراءات الأخرى، ويقدّم رؤيته في ذلك، بعيدا عن التّوجس والخوف الّذي سيدفع بثقله سلبا أم إيجابا، خصوصا وأنّ القوّة للآخر.