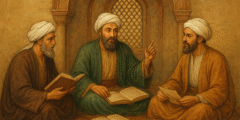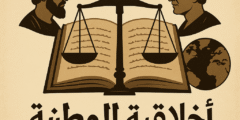تمّ التّسجيل الصّوتيّ على إذاعة هلا أف أم [الغبرة/ مسقط] في شعبان [مارس]، وبثت في رمضان [أبريل / مايو] 1442هـ/ 2021م.
الحلقة الأولى: لماذا الحديث عن الغناء والمعازف؟
أسئلة الحلقة
- لماذا الحديث عن الغناء والمعازف؟
- ما علاقة الغناء والمعازف بفلسفة الجمال؟
- ما معنى الغناء؟ وهل يكون مع آلة دائما؟
لماذا الحديث عن الغناء والمعازف؟
الحديث عن الغناء والمعازف لعدّة أسباب:
الأول: جعل القضيّة من المسلمات، بينما الخلاف من عهد الصّحابة إلى اليوم لم يتوقف.
الثّاني: تحويل المسألة من مسألة رأي إلى مسألة دين.
الثّالث: تحويل النّسبي إلى مطلق والظّرفي إلى عام.
الرّابع: فرض الرّأي الواحد في المسألة.
الخامس: ربط الغناء بالفواحش والمجون.
ما علاقة الغناء والمعازف بفلسفة الجمال؟
علم الجمال ينتمي إلى علوم الفلسفة الحديثة من حيث المنهج في القرن السّابع عشر وتطوّر في القرن العشرين، إلا أنّه قديم من حيث الوجود، ويقول القرآن: {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ} [النّحل/ 6].
فكما أنّ هناك جمال العين، وجمال اللّمس، وجمال التّذوق؛ هناك جمال الأذن والسّماع، لهذا الغناء والمعازف فرع من فلسفة الجمال.
ويعتبر محمّد عمارة [ت 2020] من أوائل من ربط بين فلسفة الجمال والغناء لدراسة الحكم الشّرعي في كتابه: الإسلام والفنون الجميلة، وركز على الجمال في القرآن خصوصا، واعتمد يوسف القرضاوي [معاصر] في كتابه: الإسلام والفنّ على كتاب عمارة، وقسّم الجمال إلى أربعة أنواع: فنّ الجمال المسموع وفنّ الجمال المرئيّ كالتّصوير؛ فنّ الفكاهة والمرح [الكوميديا]، وفنّ اللّعب.
ولهذا لا يمكن دراسة الغناء بعيدا عن فلسفة الجمال؛ لأنّ هذه الفلسفة داخلة في كلّ شيء.
– ما معنى الغناء؟ وهل يكون مع آلة دائما؟
الغناء كما عرفه عبد العزيز الحمدان هو التّطريب والتّرنم بشعر أو نثر، ويكون برفع صوت وموالاته، مصحوبا بالموسيقى أو لا.
والغناء في ذاته حقيقة على الأشهر، ثمّ خصص بالتّغليب مع آلة، إلا أنّه يشمل الجميع من حيث الأصل.
وارتبط الغناء بركنين: اللّحن والمضمون قصيدة أو نثرا، ويرتبط غالبا بالآلة. ليتكون منه علم مستقل بذاته.
لهذا سؤالنا:
- ما علاقة الغناء والمعازف بمحاكاة الطّبيعة؟
- متى نشأ الغناء مع الإنسان؟
- هل اهتم العرب بالغناء قبل بعثة النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم -، هذا ما سنراه في الحلقة القادمة.
الحلقة الثّانية: الغناء والمعازف …. النّشأة والمحاكاة
أسئلة الحلقة:
- ما علاقة الغناء والمعازف بمحاكاة الطّبيعة؟
- متى نشأ الغناء مع الإنسان؟
- هل اهتم العرب بالغناء قبل بعثة النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم -؟
ما علاقة الغناء والمعازف بمحاكاة الطّبيعة؟
المحاكاة فلسفة قديمة عند الإنسان، ولسببها حاول كشف سنن الوجود، فحاول محاكاة الطّيور لأجل أن يطير، وحاول أن يحاكي الحصان لأجل أن يكتشف آلة تختصر له الزّمن في التّنقل، ويذكر القرآن أنّه قام بمحاكاة الغراب لأجل دفن الميت: {فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ}. [المائدة/ 31].
ومن المحاكاة حاول محاكاة حناجر الحيوانات ليصنع آلات تخرج الصّوت عن طريق الأنبوب أو النّفخ أو الضّرب على الأوتار، كما أنّه حاول محاكاة الطّبيعة في ظهور الأصوات بقوّة فسخّر جلود الحيوانات في صناعة الطّبول ونحوها.
متى نشأ الغناء مع الإنسان؟
الغناء كفطرة نشأ مع الإنسان وهو يشق هذه الحياة، ويحقق الاستخلاف فيها وعمارتها، فنشأ مع الرّاعي ومع المزارع والصّانع والبنّاء، ومع الأم وهي ترضع طفلها، ومع الأب وهو يلاعب أولاده.
ثمّ عن طريقة المحاكاة كما أسلفنا اكتشف الآلة لتختصر له النّفخ والضّرب، ليتحوّل إلى علم فلسفي مع فلاسفة اليونان القدماء، ثم يظهر علم الاستاطيقا مع علماء الإغريق في القرن الثّامن الميلادي، ليتطور علم الجمال في ما بعد القرن الثّامن عشر الميلادي وحتى اليوم.
وأشهر توثيق للغناء كان مع الحضارة المصريّة القديمة، حيث ترك المصريون نقوشا ولوحات يظهر فيها عازفون على مختلف الآلات، وارتبطت بالصّلوات وأماكن العبادة.
كما أنّ التّوراة وثّقت الغناء والمعازف إلى ما قبل الحضارة المصريّة، ونسبوا ظهور العود النّبيّ داود – عليه الصّلاة والسّلام – وذلك بعد الطّوفان، حيث هذّب وضرب به، وقالوا إنّ العود الّذي كان يضرب به داود لم يزل ملقى بعد وفاته في البيت المقدس حتى وقت السّبي، وفي الأدبيات الإسلاميّة أنّ النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – أنّه قال عن أبي موسى الأشعريّ [ت 44هـ]: إنّه أعطي مزمارا من مزامير آل داود.
هل اهتم العرب بالغناء قبل بعثة النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم -؟
وهي المرحلة الّتي تسمىّ بالجاهليّة، وتمتدّ قبل بعثة سيّدنا محمّد – صلّى الله عليه وسلّم-، قرنا ونصفا أو مئتين قبل البعثة، والجاهليّة ليست ضدّ العلم، وإنّما ضدّ الطّيش والجهل، ويرى سيد قطب [ت 1966م] أنّ الجاهلية ليست فترة تاريخيّة بل تتكرر متى ما توفر الطّيش ونحوه.
وكان للجانب الإنشاديّ انتشار في العصر الجاهليّ، وهو غالبا بدون آلة، وقد يصحبه بعض الآلات كالدّف، ومن أنواعه عندهم الحداء، وهو عادة ما يستخدم في التّرحال، فقد كان يستعين به المرء في أسفاره، يؤنس به نفسه، ويستحث به مطيته، حتى قال بعضهم:
فغنها وهي لك الفداءُ إنّ غناء الإبلِ الحداءُ
وقيل إنّ أول من حدا من العرب مضر بن نزار بن معد، فقد روي أنّه سقط من بعير في أحد أسفاره، فانكسرت يداه، فجعل يقول:
يا يداه …….. يا يداه
وكان من أحسن النّاس صوتا، فاستوقفت الإبل، وطاب لها السّير، فاتخذه العرب عادة لهم بعد ذلك، ثمّ تطور شيئا فشيئا حتى أصبح له أنواع وتسميات مختلفة، كالتّغرود والموال وغيرها،
ومن أنواع الغناء عند العرب أيضا غناء ترقيص الأطفال، فقد شاع بكثرة عن العرب خاصة البدو لكثرة المربيات.
ومن أهمّ الآلات الّتي عرفها العرب في الجاهليّة الدّف والمزمار والطّبل والقضيب والزّهر .
وعموما تأثر العرب بالفرس والإغريق إلا أنّهم لم يحولوه إلى علم معرفي.
لهذا سؤالنا:
- هل يوجد فرق بين أهل مكّة والمدينة في الغناء، وكيف تعامل النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – مع الوضع؟
- متى تحوّل الغناء عند العرب إلى علم وصناعة؟
- ما الاسهامات الّتي قدّمها العرب والمسلمون للحضارة المعاصرة في هذا الجانب؟ هذا ما سنراه في الحلقة القادمة.
الحلقة الثّالثة: الغناء في العهد النّبويّ والحضارة الإسلاميّة العربيّة
أسئلة الحلقة:
- هل يوجد فرق بين أهل مكّة والمدينة في الغناء، وكيف تعامل النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – مع الوضع؟
- متى تحوّل الغناء عند العرب إلى علم وصناعة؟
هل يوجد فرق بين أهل مكّة والمدينة في الغناء، وكيف تعامل النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – مع الوضع؟
لا يمكن المقارنة بين مكّة والمدينة؛ لأنّ العرب أرخوا عن المدينة أكثر من مكّة، إلا أنّ من خلال الرّوايات يدل أنّ أهل المدينة كانوا أكثر عشقا للغناء والطّرب، من ذلك مثلا:
أولا: لما وصل النّبيّ المدينة استقبله أهلها وهم يرددون:
طلع البدر علينا …… من ثنيات الوداع
ويرى ابن القيم [ت 751هـ] أنّ هذا بعد رجوعه من تبوك 9هـ؛ لأنّ ثنيات الوداع إنّما هي من ناحية الشّام، وقيل كرر ذلك مرتين، مرّة عند قدومه المدينة، ومرّة عند رجوعه من تبوك.
ثانيا: روت عائشة [ت 57هـ] أنّها زفّت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم –: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإنّ الأنصار يعجبهم اللّهو، وفي رواية: إنّ الأنصار فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول:
أتيناكم أتيناكم ……. فحيانا وحياكم
ثالثا: عن عائشة [ت 57هـ] دخل عليّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – وعندي جاريتان تغنيان غناء بعاث [يوم من أيام العرب في الجاهليّة]، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهزني: مزمارة الشّيطان عند النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم –، فأقبل النّبيّ فقال: دعهما، فلمّا غفل غمزتهما فخرجتا.
وعلى العموم كان تعامل النّبي – صّلى الله عليه وسلّم – أكثر مرونة، وظهر ابتداع روايات بسبب ارتباط الغناء بمجالس الخنا والخمور وغيرها.
متى تحوّل الغناء عند العرب إلى علم وصناعة؟
في العصر الأموي ويعدّ سائب خاثر [ت 63هـ] تلميذ نشيط الفارسي، ونشيط الفارسي شيخ سائب وابن محرز؛ فيعدّ سائب خاثر نواة النّهضة الموسيقيّة في الدّولة الأمويّة، وأول من نقل الغناء الفارسيّ، وأصبغه بالطّابع العربيّ، وعرف هذا الأسلوب من الغناء بالغناء المتقن الّذي يقابل غناء الرّكبان في العصر الجاهليّ.
وأمّا مسلم بن محرز [ت 40 ه] الّذي توفي قبل قيام الدّولة الأمويّة فيعتبر من المجددين في هذا الجانب, وترك تلاميذ له ممّن امتهن الطّرب.
كما ظهر في الدّولة الأمويّة أول تصنيف، حيث صنّف يونس الكاتب [ت 135هـ] كتاب النّغم، وكتاب القيان، وكان نواة لما صنّف بعد ذلك في هذا الفنّ.
ولمّا قامت الدّولة العباسيّة تطور علم الغناء، وكثرت التّصانيف، وارتبط بالتّرجمة والفلسفة، وممّن كتب في هذا العصر : أبو منصور الحسن بن زبلة [ت 440هـ] تلميذ ابن سينا [ت 428هـ]، له كتاب الكافيّ في الموسيقى، وأبو نصر محمّد الفارابيّ [ت 339هـ]، صاحب كتاب الموسيقى الكبير، وإخوان الصّفا وخلان الوفا في الرّسالة الخامسة من القسم الرّياضيّ كانت عن الموسيقى.
والأمويون في الأندلس طوّروا الغناء، وظهر عندهم فنّ الموشحات.
وفي الدّولة الفاطمية ظهر فنّ الموالد احتفاء بمولد النّبيّ – صلى الله عليه وسلّم – وارتبط بالغناء، وظهر علماء كبار في هذه الفترة أيضا كأبي الحسين محمّد بن الطّحان [ت بعد 449هـ]، كان ملحنا ومغنيا، ألف كتاب: جامع الفنون وسلوة المحزون في ذكر الغناء والمغنيين، وابن الهيثم [ت 430هـ]، كان من أكبر علماء الرّياضة الّذين عرفتهم مصر، له في الموسيقي كتاب تحت عنوان رسالة تأثيرات اللّحون الموسيقيّة في النّفوس الحيوانيّة .
لهذا سؤالنا:
- ما الإسهامات الّتي قدّمها العرب والمسلمون للحضارة المعاصرة في هذا الجانب؟
- ما موقع الغناء والمعازف في الوطن العربي في القرن العشرين؟ هذا ما سنراه في الحلقة القادمة.
الحلقة الرّابعة: إسهامات العرب والمسلمين في الغناء والمعازف
أسئلة الحلقة:
– ما الإسهامات الّتي قدّمها العرب والمسلمون للحضارة المعاصرة في الغناء والمعازف؟
– ما موقع الغناء والمعازف في الوطن العربي في القرن العشرين؟
ما الإسهامات الّتي قدّمها العرب والمسلمون للحضارة المعاصرة في هذا الجانب؟
الحضارة الأوربيّة استفادت كثيرا من الحضارة العربيّة خصوصا حضارة الأندلس في الغناء والمعازف، كما أنّها استفادت من الحضارات القديمة كالحضارة الإغريقيّة، إلا أنّ العرب حافظوا على نتاج الإغريق، فقد توصل العرب منذ القرن الثّامن الميلاديّ إلى عمل بحوث ودراسات فاقت النّظريات والدّراسات الموسيقيّة الإغريقيّة ذاتها، وقد ترجمت بحوث الفارابيّ [ت 339هـ] إلى اللّغة اللّاتينيّة، وأصبحت كتبه مراجع قيّمة للباحثين والدّارسين الأوربيين فيما بعد.
لهذا الغناء الأوربي خلال القرن الثّالث عشر كان ذا نكهة شرقيّة واضحة، وبعض الإيقاعات الّتي كانت تستخدم في أوربا في ذلك الوقت انحدرت من أصل مغربيّ، وثبتت نسبتها إلى أصول عربيّة.
ما موقع الغناء والمعازف في الوطن العربي في القرن العشرين؟
تطور الغناء في الوطن العربي خصوصا في مصر في نهاية القرن التّاسع عشر، وفي القرن العشرين، ويعتبر سيّد درويش [ت 1923م] مؤسس مدرسة القرن العشرين في الموسيقى العربيّة ، وواصل مسيرة أستاذه سلامة حجازي [ت 1917م] ، وهؤلاء مهدوا القاعدة لمن بعدهم، حتى جاء المنظرون الأربعة محمّد القصبجيّ [ت 1966م]، ومحمّد عبد الوهاب [ت 1991م]، وزكريا أحمد [ت 1961م]، ورياض السّنباطيّ [ت 1981م] وأحدثوا نقلة كبيرة فن الفنّ الغنائيّ في العالم العربيّ، انطلاقا من مصر، حتى أصبحت مركز الفنّ العربيّ، وقبلة الرّاغبين في هذا المجال، ثمّ تأتي مرحلة محمّد الموجيّ [ت 1995م]، وكمال الطّويل [ت 2003م]، وبليغ حمديّ [ت 1993م]، والسّيد مكاويّ [ت 1977]، وغيرهم .
ومرحلة منتصف السّبعينيات يتراجع الفنّ الكلاسيكي ليحلّ محلّه الفنّ الشّبابيّ، وما تبعه من ظهور فيديو كليب الّذي أثر في الأغنيّة الشّبابيّة، وتأثير الأغنية الغربيّة على الأغنية الشّرقية، ومنافسة لبنان لمصر، ثمّ العراق، وأخيرا الخليج العربي.
وظهرت الفنون الغنائيّة كالمسرحيات الغنائيّة، والأفلام الغنائيّة، والسّيمفونيات والأوبرا، ومراكز التّعليم الغنائيّ، ونشطت الكتابات الفنيّة والموسيقيّة.
كما ظهر بعض المنظرين مثل غازي الخالديّ [ت 2006م]، حيث صنّف الفنون على أساس المهمة الأصليّة للفنون، وارتباطها بالإنسان، فوضعها في مجموعات: الفنون التّشكيليّة الّتي تهدف إلى صناعة الشّكل مجسّما أو مسطحا، والتّطبيقيّة الّتي تنفّذ باليد وتعتمد على التّصميم، والحركيّة الّتي تعتمد على الحركة كالتّمثيل والرّقص، والسّمعيّة كالموسيقى والغناء، والجامعة كالسّينما والتّلفزيون والفيديو[1].
لهذا سؤالنا:
- كيف كانت بداية تطور الغناء في الحضارة الأوروبيّة الحديثة؟
- كيف تطور المجال الفلسفي في هذا الجانب؟ هذا ما سنراه في الحلقة القادمة.
الحلقة الخامسة: الغناء والمعازف في الحضارة الأوروبيّة
أسئلة الحلقة:
- كيف كانت بداية تطور الغناء في الحضارة الأوروبيّة الحديثة؟
- كيف تطور المجال الفلسفي في هذا الجانب؟
كيف كانت بداية تطور الغناء في الحضارة الأوروبيّة الحديثة؟
رأينا سابقا أنّ الحضارة الأوربيّة استفادت كثيرا من الحضارة العربيّة والأغريقيّة عن طريق الحضارة العربيّة، وكان الغناء ذا نكهة شرقيّة، خصوصا عن طريق الحملات الصّليبيّة، وعن طريق الحج، وعن طريق الأندلس.
وبداية مع عصر النّهضة في القرن الرّابع عشر استطاعت أوروبا أن تطور الغناء الشّرقيّ فحوّلته من اللّحن المفرد المعبر بذاته إلى التّمثيليات الغنائيّة (الأوبرا)، والتّمثيليات الدّينيّة (الأوراتوريو)، والسّيمفونيا، والرّباعيات الوتريّة وغيرها.
وبظهور الأوبرا ظهرت وتطورت الآلات الموسيقيّة مثل السّوناتا والسّمفونيّة والحواريّة (الكونشرتو) وبعض كما أنّه تطورت الآلات الوتريّة ليتبوأ البيانو عرشها.
كيف تطور المجال الفلسفي في هذا الجانب؟
بعد عصر النّهضة في أوروبا كان عصر التّنوير، وهنا انتقل الجانب الغنائي من الجانب الموسيقي العام إلى الجانب الفلسفي، ويعتبر القرن التّاسع عشر عصر الإبداع، وفيه تمخضت اتجاهات موسيقيّة كثيرة غيّرت الموسيقى في العالم جميعا إلى يومنا هذا، ومن أهم المنظرين في هذا العصر فيبر [ت 1826م] وبتهوفنّ [ت 1827م] وشوبرت [ت 1828م] وشوبان [ت 1849م]، وغيرهم كثير.
ومن الفلاسفة مثلا كانت [ت 1804م] حيث يرى للفنون ثلاثة طرق: أولا: الّتي تستخدم الكلمات كالشّعر والخطابة، ثانيا: الّتي تستخدم الصّور التّشكيليّة كالعمارة والنّحت، ثالثا: الّتي تستخدم الأصوات كالموسيقى، وأضاف إلى هذه الأنواع نوعا آخر سماه الفنون المركبة، أي مؤلفة من عدة فنون: أدب، ضوء، تمثيل، إخراج، ديكور، رقص … الخ، كفنون المسرح، والغناء، والأوبرا، والرّقص.
ثمّ يأتي هيجل [ت 1831م] حيث صنّف الفنون من الرّؤية الميتافيزيقيّة للفنّ، فالفنون عنده تندرج في ثلاثة مستويات: المستوى الرّمزيّ في فنّ العمارة، وفيه تطغى المادّة على الرّوح، ومستوى الفنون الكلاسيكيّة النّحت وفيه يتساوى مستوى المادّة والرّوح، ومستوى الفنون الرّومانتيكيّة المتمثلة في التّصوير والموسيقى والشّعر، وفيه تسيطر الرّوح وتسود .
ثمّ يأتي شوبنهاور [ت 1860م] حيث يصنّف الفنون تصنيفا هرميا، فيرتبها حسب ما تعبر عنه من مُثل تكون نابعة من قوى الإرادة، فيرى أنّ فنّ العمارة أدنى درجات الفنون؛ لأنّ المنفعة تتغلب على الجانب الجماليّ، فيرتفع إلى فنّ النّحت وبعده التّصوير، ويعتبر الشّعر أعلى درجة من التّصوير؛ لأنّه يعبر عن المثل بواسطة الخيال الّذي يجسد التّصورات عن طريق الكلمات.
لهذا سؤالنا:
- ما موقع الغناء في عمان قديما؟
- ما موقعه حديثا؟ هذا ما سنراه في الحلقة القادمة.
الحلقة السّادسة: الغناء والمعازف في عمان قديما وحديثا
أسئلة الحلقة:
- ما موقع الغناء في عمان قديما؟
- ما موقعه حديثا؟
ما موقع الغناء في عمان قديما؟
دولة الإمامة في عمان، خصوصا في عهدها الذّهبيّ من عام 179هـ وحتى عام 272هـ كانت دولة فقهيّة تنظر إلى الغناء والمعازف نظرة سلبيّة، سيسقط هذا على التّعامل السّياسيّ، وعليه الفكر السّياسيّ والفقهيّ العمانيّ التّقليديّ تاريخيّا لم يستوعب الموسيقى والفنون عامّة، فوضعها في خانة اللّهو واللّعب باعتبارها مظهرا من مظاهر التّرف المنبوذ.
وفي دولة النّباهنة في القرن السّابع الهجريّ، والّتي امتدّت لخمسة قرون، بخل التّأريخ أن يسجل عن هذه الفترة، ومع هذا يشير الشّاعر النّبهانيّ اللّواح [ت؟] إلى انتشار الطّرب في مدينة نزوى أيام النّباهنة.
وأمّا الدّولة اليعربيّة [من 1034ه وحتى 1161ه] فقد اهتمت بالتّوسع أكثر من الاهتمام بالمعرفة، وهي دولة فقهيّة ملكيّة وراثيّة، والجانب الفقهي يطغي عليها، ولهذا النّظرة سلبيّة إلى المعازف والغناء بشكل عام.
وأمّا دولة البوسعيد من 1161ه وحتى يومنا هذا فهي الأفضل حالا، خاصّة في الشّق الأفريقيّ ابتداء، وفي عهد السّلطان قابوس انفتحت على الغناء والمعازف مشرقا.
ومع هذا كان الجو العام كطبيعة الإنسان مرتبطا بالغناء، لكنّه لم يشارك إخوانه في العالم كعلم بسبب النّظرة الفقهيّة السّلبيّة له، فكان ضرب الطّبل مصاحبا للمحتسب وفي الحرب كما يقول نور الدّين السّالميّ [ت 1332هـ]:
روى ابن محبوب لنا عن صحبه *** بأنّ ضرب الطّبل لا بأس به
ويذكر أبو زكريا يحيى بن سعيد [ت 427هـ] عن القصبة الكبيرة – أي المزمار، فإنّ المسلمين – أي الإباضيّة – أجازوا استماعها لمزيد قربها من الآخرة، أخبرني زياد بن الوضاح [ت ق 3هـ] أنّه رأى أباه [ت ق 3هـ] يستمعها وهو يبكي.
وانتشر المولد أو المالد فقد كان حاضرا عند الشّافعيّة الصّوفيّة في عمان منذ فترة مبكرة جدّا، إلا أنّه لم يعهد في المجتمع الإباضيّ خاصّة في الدّاخل الاحتفاء به إلا عند بعض سلاطين البوسعيد، وكانت النّظرة إليه سلبيّة، والإباضيّة في عمان تأثروا بهذا أبان اختلاطهم بالصّوفيّة الشّوافع خصوصا في شرق أفريقيا، فانتشر لديهم قراءة البرزنجيّ الشّافعيّ [ت 1317هـ] بصوت غنائيّ، والّذي جعل من أبي مسلم البهلانيّ [ت 1339هـ] تأليف كتاب النّشأة المحمديّة كبديل عن البرزنجيّ ، وعند بعض الشّوافع يقرأون من الفيوضات الرّبانيّة لعبد القادر الجيلانيّ [ت 561هـ]، أو من ديوان ابن الفارض [ت 632هـ] في مدح النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – .
وتقترب الرّزحة من الإنشاد الدّينيّ، وتقام عادة في المناسبات الدّينيّة والاجتماعيّة، ومعها بعض ضروب التّرفيه والرّقص، وغناء النّساء دان دان ، وفنّ السّيف عند البدو ، والعازي الّذي يصاحب الرّزحة خاصة في الحروب ، ومن الإنشاد الدّينيّ العمانيّ القديم التّيمينة والتّسبيح للتّعبير عن الحب للخالق والرّسول والأماكن المقدسة والكعبة خصوصا، بجانب أغاني البحر والسّفر وترقيص الأطفال.
وانتشر في المجتمع العمانيّ كبقية دول الخليج العربيّ استعمال العود الشّرقيّ.
ما موقعه حديثا؟
الفنّ الغنائيّ تطور في عهد السّلطان قابوس [ت 2020م]، وكان بنفسه يدعم من البداية الفرق الموسيقيّة، كالفرقة الشّرقيّة الخاصة.
بجانب دعم المؤسسات الخاصة كان هناك جمعيّة هواة العود تتبع ديوان البلاط السّلطانيّ، وفرقة الأوركسترا السّيمفونيّة السّلطانيّة العمانيّة والّتي تأسست عام 1985م، ومركز عمان للموسيقى التّقليديّة التّابع لوزارة الأعلام 1983م [ديوان البلاط السّلطانيّ، مركز السّلطان قابوس للثّقافة والعلوم حاليا]، والموسيقى العسكريّة ، وغيرها كثير، وأخيرا دار الأوبرا السّلطانيّة.
وظهر العديد من الملحنين والمبدعين، بجانب بعض الكتب والمؤلفات.
سؤالنا القادم:
متى بدأ النّشيد الوطني في عمان؟ هذا ما سنراه في الحلقة القادمة.
الحلقة السّابعة: مسألة النّشيد الوطني في عمان
سؤال الحلقة:
متى بدأ النّشيد الوطني في عمان؟
يقال تمّ إنشاء أول مقامة وطنيّة كانت في عهد السّيد برغش بن سعيد [ت 1888م] في زنجبار، مطلعها:
فليحيى السّيدُ عمّرَ البيداء
مولانا الأمجدُ أقهر الأعداء
ولما زار السّلطان تيمور بن فيصل [ت 1965م] الهند أعجب في بومباي بالفرق الموسيقيّة، وفيها نظم أحد الشّيوخ قصيدة النّشيد الوطنيّ، ولحنها قائد الفرقة الموسيقيّة، وبات النّشيد الوطني يعزف في نهاية كلّ احتفال موسيقيّ .
ولما التجأ الإمام غالب بن عليّ الهنائيّ [ت 2009م] إلى السّعوديّة بعد خروجه من عمان وضع نشيدا وطنيا مطلعه:
لقني الخصمَ دروسا يا عمانُ مجدُك السّامي بهِ نفتخرُ
نحنُ أسدُ اللهِ في سوقِ الوغى عزمُنا كالنّارِ يشوي من طغى
وعموما لم يكن في عمان نشيد وطني موحد في الغالب، وفي أحيان كثيرة لم تكن الفكرة حاضرة إلا لماما، ولما رجع حمد بن سيف بن سالم البيمانيّ [ت 1384هـ/ 1965م] من زنجبار سنة 1372هـ/ 1952م أسس مدرسة شبه نظاميّة في محلّة الخضراء ببهلا جعل فيها للطّلاب والمدرسة نشيدا ينشد أشبه بالنّشيد الوطنيّ، وذلك عام 1964م، وممّا قال فيه:
أيا طالبَ العلمِ قمْ عاجلا
لحملِ العلومِ ونيلِ الكرمْ
أتدري بما قالتِ الحُكَمُ
بأنّ الجهالةَ تزولُ النّعمْ
ولما حكم السّلطان قابوس بن سعيد [معاصر] عمان عام 1970م، وضع النّشيد الوطني، والأشهر أنّ الّذي وضعه الأستاذ توفيق بن محمّد جمال عزيز حيث كتب مذكرة في صفحتين بتأريخ 20 يناير 2009م، وذلك لحفظ حقه، أثبت فيها أنّه صاغ النّشيد الوطنيّ العمانيّ في شهر يناير 1971م، وقيل وضعه محمود الخصيبيّ [ت 1998م]، وعدّل الكلمات حفيظ الغسانيّ مدير المدرسة السّعيديّة بصلالة خلال السّبعينات، وقيل الّذي وضعه أصلا حفيظ الغسانيّ [ت 2015م]، وقيل الشّاعر المغربيّ علي الصّقليّ [معاصر]، ومطلعه:
| يا رب احفظ لنا | بلادنا عمان | |
| والشّعبُ في الأوطان | بالعزِّ وَالإيمان |
وأقترح السّيد حمود بن حمد البوسعيديّ [معاصر] رئيس الدّيوان السّلطانيّ آنذاك، أن يتضمن النّشيد اسم السّلطان قابوس ليكون:
| يا ربنا احفظْ لنا | جلالةَ السّلطانْ | |
| بِالعزِّ وَالأمانْ | ||
كما غيّر:
| أبشري نحنُ الفداء | وبنوكِ الأوفياء | |
| فاسعدي ولتباركك السّماء | ||
إلى:
| أبشري قابوسُ جاء | فلتباركه السّماء | |
| واسعدي ولتقيه بالدّعاء | ||
ولمّا حكم السّلطان هيثم في عام 2020م بقي كما هو إلا أنّه غيّر الجزء الأخير إلى:
فارتقي هام السّماء واملئي الكونَ الضّياء
واسعدي وانعمي بالرّخاء
لهذا سؤالنا:
- هل ابن حزم أول من أحدث مراجعات للنّص الدّيني حول الغناء والمعازف؟
- وهل أبو حامد الغزالي أول من أحدث مراجعات فلسفيّة حوله؟
- وهل الشّوكاني أحدث مراجعات في الدّليل الأصولي حوله؟ هذا ما سنراه في الحلقة القادمة.
الحلقة الثّامنة: المراجعات الحديثيّة والأصوليّة الأولى حول الغناء والمعازف
أسئلة الحلقة:
- هل ابن حزم أول من أحدث مراجعات للنّص الدّيني حول الغناء والمعازف؟
- وهل الشّوكاني أحدث مراجعات في الدّليل الأصولي حوله؟
هل ابن حزم أول من أحدث مراجعات للنّص الدّيني حول الغناء والمعازف؟
لما كثرت مجالس السّمر، وما اقترن بها من شرب ورقص ومعازف، ظهرت الرّوايات المعممة للتّحريم، فأتى فريق من الكراميّة فقالوا: يجوز وضع الحديث في التّرهيب والتّرغيب، وتابعهم على ذلك كثير من جلّة الزّهاد والمتصوفة والوعاظ، لهذا كثرت روايات التّحريم.
من هنا جاء فريق من العلماء وعملوا مراجعات مبكرة لهذه الرّوايات، ومن هؤلاء عليّ بن أحمد ابن حزم الظّاهريّ [ت 456هـ]، عالم الأندلس في عصره، ولد بقرطبة، كانت له ولأبيه رياسة الوزارة، وتدبير المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتّأليف، صاحب كتاب المحلى، وهو الرّمز الثّاني للمدرسة الظّاهريّة في الفقه بعد أبي داود الظّاهري، واشتهر بالشّدة، حتى قيل لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان.
ناقش ابن حزم أهمّ أدلّة من حرّم الغناء والمعازف ، فوجدها لا تخلو من سند منقطع، أو علّة تقدح فيها، حتى قال: ولا يصح في هذا الباب – أي باب التّحريم للغناء والمعازف – شيء أبدا، وكلّ ما فيه موضوع، ووالله لو أسند جميعه، أو واحد منه عن طريق الثّقات عن رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – لما ترددنا في الأخذ به.
وبين أنّ الأصل في سماع الغناء الإباحة، فمن نوى باستماعه عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كلّ شيء غير الغناء، فمن نوى به ترويح نفسه؛ ليتقوى على طاعة الله، وينشّط نفسه على عمل البر؛ فهو مطيع محسن، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها، فالأصل في الشّيء الإباحة.
هل الشّوكاني أحدث مراجعات في الدّليل الأصولي حوله؟
جاء محمّد بن عليّ الشّوكانيّ [ت 1250هـ]، من كبار فقهاء صنعاء، وهو في الأصل زيديّ، إلا أنّه تأثر بمدرسة أهل الحديث، ناقش القضيّة من خلال الدّليل الإجمالي الرّابع في أصول الفقه وهو الإجماع، فخلص إلى أنّه لا يوجد إجماع أصلا في حرمة السّماع، فينطلق من قول ابن طاهر القيسرانيّ [ت 507هـ]: أنّه لم يصح في هذا الباب شيء، وبقول أبي القاسم عيسى بن ناجيّ التّنوخيّ [ت 837هـ] في شرح رسالة أبي زيد [ت 368هـ]: “لم أعلم في كتاب الله، ولا في السّنة حديثا صحيحا صريحا في تحريم الملاهيّ، وإنّما ظواهر وعمومات يتأنّس بها لا أدلّة قطعيّة”.
فيبدأ من الصّحابة ممّن أجاز السّماع والغناء مثل عبد الله بن جعفر [ت 80هـ] أنّه كان لا يرى بالغناء بأسا، ويصوغ الألحان لجواريه، ويسمعها منهنّ على أوتاره، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب [ت 40هـ]، وأنّ عبد الله بن الزّبير [ت 73هـ] كان له جوار عوّادات، وأنّ ابن عمر [ت 73هـ] دخل على ابن الزّبير وإلى جنبه عود، فقال ما هذا يا صاحب رسول الله؟ فناوله إياه، فتأمله ابن عمر، فقال: هذا ميزان شاميّ، فقال لابن الزّبير: توزن به العقول.
ثم يتطرق إلى التّابعين فيستشهد أنّ عمر بن عبد العزيز [ت 101هـ] كان يسمع من جواريه قبل الخلافة، وأنّه ورد التّرخيص في الغناء عن طاووس بن كيسان [ت 106هـ].
مع وجود هذا الخلاف يخلص الشّوكاني بعدم وجود إجماع أصلا في المسألة.
لهذا سؤالنا:
- هل أبو حامد الغزالي أول من أحدث مراجعات فلسفيّة حوله؟ هذا ما سنجده في الحلقة القادمة.
الحلقة التّاسعة: المراجعات الفلسفيّة الأولى حول الغناء والمعازف
سؤال الحلقة
هل أبو حامد الغزالي أول من أحدث مراجعات فلسفيّة حوله؟
جاء أبو حامد محمّد الغزاليّ [ت 505هـ] في زمن ابن حزم، وهو فيلسوف ومتصوّف، والغزاليّ شافعيّ المذهب، عاش في عهد الدّويلات الّتي قامت نتيجة ضعف الدّولة العباسيّة، ولمكانته العلميّة والفلسفيّة ولاه نظام الملك [ت 485هـ] التّدريس في مدرسته ببغداد.
وفي عصره كثر الجدل حول الغناء والمعازف لسببين: الأول صناعة الرّوايات المحذرة من الغناء والمعازف، بجانب روايات الزّهاد والقصاصين والوعاظ، وفي المقابل رؤية الفلاسفة الّتي تنظر إلى المعازف والغناء كفنون علميّة لا علاقة لها بالحلّ والحرمة.
لهذا سيكون هنا فريقان: فريق ينظر إلى الغناء والمعازف بنظرة سلبيّة كبيرة، فمنهم من مال إلى تحريم الاثنين مطلقا، ومنهم من رخص في بعض الآلات، ومنهم من رخص في الغناء دون المعازف ، وفريق يرى أنّها تدور وفق العلّة، فإن استخدمت في خير فخير، وإن استخدمت في شرّ فشرّ.
جاء الغزالي ونظر إلى المسألة ليس من زاوية حديثيّة كابن حزم، بل ناقشها من زاوية جماليّة فلسفيّة، فيرى ابتداء يرى أنّ الغناء أساسه صوت طيّب، مفهوم المعنى، والطّيب ينقسم إلى موزون وغير موزون، والموزون ينقسم إلى المفهوم كالأشعار، وغير المفهوم كأصوات الجمادات وسائر الحيوانات.
ويربط بين حواس الإنسان ومظاهر الطّبيعة، حيث يجد علاقة كبيرة بينهما، ممّا يحدث لذة في حواس الإنسان، فالبصر لذته النّظر إلى المبصرات الجميلة كالخضرة، والشّم لذته الرّوائح الطّيبة، واللّمس لذته مسّ النّاعم، والعقل لذته العلم والمعرفة، وهكذا السّمع لذته الصّوت الحسن من جماد وإنسان.
وعليه ما من شيء صنعه الإنسان إلا وله أصل في الخلْقة، وأصل المعازف حناجر الحيوانات، فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرّم لكونها طيبة أو موزونة، فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب والطّيور، لهذا ينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الإنسان كالقضيب والطّبل والدّف وغيرها من الآلات.
فقام باستقراء الرّوايات المحرّمة للغناء والمعازف حسب المنطلق العقليّ الفلسفيّ، وخلص أنّها ليست محرّمة لذاتها؛ بل لما اقترنت به من أمور ثلاثة:
– أنّها تدعو إلى شرب الخمر.
– تذكر مجالس الأنس بالشّرب.
– الاجتماع عليها غالبا من عادة أهل الفسق.
ولهذا يرى أنّه لو استخدمت هذه الآلات في مجتمع، وكانت صفاته معاكسة؛ لكان الحكم آخر؛ لأنّها لم تحرّم من حيث كونها كأصوات؛ وإنّما لعوارض أخرى.
وجاء بعده أخوه أبو الفتوح أحمد بن محمّد الطّوسيّ الغزاليّ [ت 505هـ]، وقد درّس بالنّظاميّة نيابة عن أخيه أبي حامد لمّا ترك التّدريس فيها، رسالته المسماه: بوارق الألماع في تكفير من يحرّم السّماع، والرّجل فرّط في المقابل، حيث شنّ هجمة لمن حرّم، فأوصله إلى التّكفير والتّفسيق، ودلل على كلامه بقوله: من قال إنّ السّماع حرام فقد حرّم في الشّرع ما لم يرد النّص به، إذ لم يرد في كتاب الله، ولا في سنّة رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – نص بتحريم السّماع والرّقص، ومن حرّم في الشّرع ما ليس يحرم؛ فقد افترى على الله كذبا، ومن افترى على الله كذبا كفر بالإجماع.
وعموما رسالته على صغرها لكن مهمّة، وفي فترة مبكرة، واستخدم المنهج الحديثي في مناقشة الأدلّة، مع القواعد الفقهيّة كقاعدة الشّيء المطلق إذا جاز بعضه، ولم يرد النّهي عن الباقي دلّ على جوازه، ومثله دلّت النّصوص على جواز الدّف، بيد أنّه لم تأت نصوص في الآلات الأخرى، فدلّ على الجواز كأصل عامّ، إلا ما منع، أو ارتبط بعلّة تخرجه إلى الحرمة أو الكراهة.
سؤال الحلقة:
- ما أهم المراجعات للغناء والمعازف في بداية القرن العشرين في المدرسة الإصلاحيّة؟ هذا ما سنجده في الحلقة القادمة.
الحلقة العاشرة: مراجعات المدرسة الإصلاحيّة حول الغناء والمعازف
سؤال الحلقة:
- ما أهم المراجعات للغناء والمعازف في بداية القرن العشرين في المدرسة الإصلاحيّة؟
ارتبط محمّد رشيد رضا [ت 1935م] بالدّعوة الإصلاحيّة الّتي قادها جمال الدّين الأفغانيّ [ت 1897م] ومحمّد عبده [1905م]، والدّعوة الإصلاحيّة امتداد لما قام به حسن العطار [ت 1835م] وتلميذه رفاعة الطّهطاويّ [ت 1873م].
ورشيد رضا أصله من جبل لبنان بلبنان، وعاش في مصر منذ عام 1898م، وأنشأ مجلّة المنار، الّتي حققت صيتا شهيرا في العالم الإسلاميّ، ونشر فيها دروس الإمام محمّد عبده في التّفسير ،وقام بتحريرها حتى الآية 125 من سورة النّساء، ثمّ واصل رشيد رضا التّفسير حتى وصل إلى سورة يوسف، وأتمّ البيطار سورة يوسف، وجمّع هذا التّفسير باسم المجلّة أي المنار.
ومنطلق مراجعات رشيد رضا تنطلق من العودة إلى الأصل المجمع عليه وهو الكتاب والسّنة العمليّة المتفق عليها، ويعذر بعضهم بعضا في الرّوايات القوليّة الآحاديّة.
فيرى أنّ قضيّة الغناء والمعازف في الأمر الثّالث، لهذا يرى أنّ سبب شيوع التّحريم على المعازف والغناء، والنّطرة السّلبيّة له أنّ كثيرا من أئمة العلماء الزّهاد شدد النّكير على أهل اللّهو لما كثر وأسرف النّاس فيه عندما عظم عمران الأمّة، واتّسعت مذاهب الحضارة فيها، حتى جاء أهل التّقليد، فرّجحوا أقوال الحظر، وزادوا عليها في التّشديد، حتى حرّم بعضهم سماع الغناء مطلقا، وسماع آلات اللّهو جميعا إلا طبل الحرب ودف العرس، وزعموا أنّه دف مخصوص لا يطرب، وأنّه غير دف أهل الطّرب!!
واستقرأ رشيد رضا روايات الحظر وروايات الإباحة فخلص إلى أحاديث الإباحة مرجحة بصحتها وضعف مقابلها ونكارته، وهي موافقة ليسر الشّريعة والفطرة، ولم يرد نص في الكتاب ولا في السّنة في تحريم سماع الغناء أو آلات اللّهو يحتج به، وورد في الصّحيح أنّ الشّارع وكبار أصحابه سمعوا أصوات الجواري والدّفوف بلا نكير.
لهذا يمكن اعتبار رشيد رضا ابن حزم الثّاني.
ثمّ جاء بعده من المدرسة الإصلاحيّة محمود شلتوت [ت 1963م]، وانطلق في الغناء المنطلق الفلسفي والجمالي، فيرى أنّ الله تعالى خلق الإنسان بغريزة يميل بها إلى المستلذات والطّيبات الّتي يجد لها أثرا طيّبا في نفسه، به يهدأ، وبه يرتاح، وبه ينشط، وبه تسكن جوارحه، فتراه ينشرح صدره بالمناظر الجميلة، كالخضرة المنسقة، والماء الصّافيّ الّذي تلعب أمواجه، والوجه الحسن الّذي تنبسط أساريره، ولهذا لا يمكن عقلا نزع هذه العاطفة أو إماتتها أو مكافحتها في أصلها.
فإذا مال الإنسان إلى سماع الصّوت الحسن، أو النّغم المستلذ، من حيوان أو إنسان، أو آلة كيفما كانت، أو مال إلى تعلّم شيء من ذلك؛ فقد أدى للعاطفة حقّها، بحيث يقف مع هذه الغريزة مع الحدّ الّذي لا يصرفه عن الواجبات الدّينيّة، أو الأخلاق الكريمة، أو المكانة الّتي تتفق ومركزه.
فسماع الآلات، ذات النّغمات والأصوات الجميلة، لا يمكن أن يحرّم باعتباره صوت آلة، أو صوت إنسان، أو صوت حيوان، وإنّما يحرّم إذا استعين به على محرّم، أو اتخذ وسيلة إلى محرّم، أو ألهى عن واجب؛ لأنّ تحريم ما أحلّه الله تعالى، أو تحليل ما أحلّه كلاهما افتراء على الله سبحانه وتعالى.
ويخلص أنّ هذا حدّ كاف للتّعامل مع هذه القضيّة، ولهذا يمكن اعتبار شلتوت أبا حامد الغزالي الثّاني.
لهذا سؤالنا:
– ما أهم المراجعات في مرحلة الصّحوة؟
– هل توجد مراجعات حديثة في المدرسة الإباضيّة؟ هذا سنناقشه في الحلقة القادمة.
الحلقة الحادية عشرة: مراجعات حول الغناء والمعازف في مرحلة الصّحوة
أسئلة الحلقة:
– ما أهم المراجعات في مرحلة الصّحوة؟
– هل توجد مراجعات حديثة في المدرسة الإباضيّة في مرحلة الصّحوة؟
ما أهم المراجعات في مرحلة الصّحوة؟
مرحلة الصّحوة جاءت في النّصف الثّاني من القرن العشرين، خصوصا بعد السّتينيات، كبديل عن التّيار اليساري، لهذا ارتبطت بالسّياسية، وارتفع صوتها بعد حادثة جهيمان في الحرم، وبعد نجاح الثّورة الإسلاميّة في إيران، ومن صفاتها التّشدد في قضايا فرعيّة ومنها الغناء والمعازف.
فجاء محمّد الغزالي [ت 1996م]، فكرّس حياته في محاربة التّيار الإسلاميّ – إن صح التّعبير – المتشدد، والّذي يراه بالتّيار البدويّ أو الصّحراويّ، فكتب في مناقشته كتبا منها هموم داعية، والسّنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وفي المقابل محاربة التّيار المتنكر للشّرق، الرّافض لكلّ ما هو تراث.
وهنا واجه الغزاليّ التّيار الرّافض للفنّ والغناء والمعازف، وفي الوقت نفسه رفض أن يكون الفنّ وسيلة للعريّ والفسوق والمجون، فهو رسالة نبيلة إذا أحسن توظيفه.
ويرى أنّه ليس من المعقول أن نحظر الغناء والمعازف لكون فئة من النّاس استخدمته استخداما سيئا، بل علينا أن نصحح الفكرة والغاية، لتكون في صالح الأمّة، ونشر الفضيلة.
وفي زمنه أيضا السّيد محمّد حسين فضل الله [ت 2010م] من علماء الإماميّة في لبنان، فهو يفرّق بين الغناء الّذي يثير الغرائز، ويؤدي إلى الميوعة الشّعوريّة والسّلوكيّة، فيحرم من جهة النّتائج السّلبيّة في الجانب الأخلاقيّ والرّوحيّ في حياة النّاس، وبين الغناء الّذي يرتفع بالرّوح، ويسمو بالنّفس، ويهدّئ الأعصاب، ويريح النّفس، فيحلّ من جهة النّتائج الإيجابيّة في المستوى النّفسيّ والأخلاقيّ والرّوحيّ وذلك كالموسيقى الهادئة أو الحماسيّة، ولهذا يخلص أنّ الفقيه لا يصح له أن يفتي دون الرّجوع إلى أهل الخبرة في معرفة الغناء المحرّم من الغناء الحلال.
هل توجد مراجعات حديثة في المدرسة الإباضيّة في مرحلة الصّحوة؟
في القطر الإباضي المغربيّ قاد الحركة الإصلاحيّة الشّيخ بيوض إبراهيم بن عمر [ت 1980م]، والصّحفيّ الأديب أبو اليقضان إبراهيم [ت 1973م]، إلا أنّ الشّيخ بيوض في حركته اهتمّ بجانبين: الإصلاح الاجتماعيّ، والتّأسيس العلميّ، حيث أسس معهد الحياة في القرارة بميزاب، فقاد المسيرة الإصلاحيّة بعده تلميذه وعونه الفقيه عبد الرّحمن البكريّ [ت 1986م]، ومن ثمّ تلميذهما الشّيخ عدون [ت 2004م]، والشّيخ ناصر المرموريّ [ت 2011م].
وبيّن بيوض أنّ الأصل في التّغني بالغناء، والتّطريب بألحانه؛ لا دخل له في التّحليل والتّحريم، فأصل الغناء أنّ حلاله حلال، وحرامه حرام، وعليه هو كسائر المسائل تعتريه الأحكام الخمسة، ولا ينتقل إلى الحرمة إلا إذا اقترن بمحرّم، أو أدّى إلى محرّم، أو ضيع واجبا.
وأمّا آلات اللّهو لا تصل إلى حدّ الحرام، بغض النّظر عن نوعها، إذ أقل ما يقال فيها الكراهة الشّديدة، سواء اقترنت مع غناء – أي كلام ملحن – أو انفصلت عنه، إلا إذا استخدمت في حرام، أو قادت إلى محرّم، أو ضيّعت واجبا، فتصبح محرّمة.
ويرى تلميذه البكري أنّ سماع الموسيقى والتّلفزيون لا بأس بهما عند فريق من العلماء إذا خلا ذلك ممّا يهيّج النّفس، ويبعثها على الرّذيلة، ومن تورع عن ذلك فهو خير له وأسلم.
سؤالنا القادم:
- هل توجد رؤية فقهيّة منفتحة في المدارس الثّلاثة الأولى: الإباضيّة والزّيديّة والجعفريّة؟ هذا سنناقشه في الحلقة القادمة.
الحلقة الثّانية عشرة: الرّؤية الفقهيّة المنفتحة في المدارس الثّلاثة الأولى: الإباضيّة والزّيديّة والجعفريّة
سؤال الحلقة:
هل توجد رؤية فقهيّة منفتحة في المدارس الثّلاثة الأولى: الإباضيّة والزّيديّة والجعفريّة؟
المدرسة الإباضيّة من أوائل المدارس الإسلاميّة تشكلا، إذ نشأت في القرن الأول الهجري، ومنظرها الفقهي جابر بن زيد [ت 93هـ]، ومنظرها السّياسي أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة [ت 150هـ]، أما نسبتها إلى عبد الله بن أباض [ت 86هـ] فليست نسبة علميّة وإنّما نسبة سياسية.
أجاز الأوائل ضرب الدّف والطّبل لمقاصد في المجتمع كما يذكر السّالميّ [ت 1332هـ]، وهو قول محمّد بن محبوب [ت 260هـ].
| روى ابنُ محبوبٍ لنا عن صحبهِ | بأنّ ضرب الطّبلِ لا بأس بهِ | |
| ولمْ يرخصوا بضربِ الطّبلِ | للهوِ لكن لمعانِ العدلِ | |
| وذاك كالإرهابِ للأعدا | وكإجابةِ الصّريخِ النّائي | |
| وكدعاءِ لصلاةِ العيدِ | أو اجتماعٍ بينهم سديدِ |
ويرى أبو المؤثر الصّلت بن خميس [ت 278هـ] استحباب الدّهرة والطّبل في الحرب، ولا يكسر، والتّكبير والتّهليل أحق وأولى .
ويرى أبو زكريا يحيى بن سعيد [ت 427هـ] عن القصبة الكبيرة – أي المزمار -، فإنّ المسلمين – أي الإباضيّة – أجازوا استماعها لمزيد قربها من الآخرة، أخبرني زياد بن الوضاح [ت ق 3هـ] أنّه رأى أباه [ت ق 3هـ] يستمعها وهو يبكي .
ويرى البكريّ [ت 1986م] أنّ سماع الموسيقى لا بأس به عند فريق من العلماء إذا خلا ذلك ممّا يهيّج النّفس، ويبعثها على الرّذيلة.
وأمّا المدرسة الزّيديّة فهي نسبة إلى الإمام زيد بن عليّ المتوفى 122هـ، فقد رأينا سابقا ممّن أبطل الإجماع في تحريم مطلق السّماع الشّوكانيّ [ت 1250هـ]، وقد كان فقيها زيديّا قبل أن يتأثر بمدرسة أهل الحديث.
وقال: الجلال في ضوء النّهار: وأمّا الغناء فقال الفقهاء: إنّه مكروه فقط، إلا إذا شغل عن واجب، أو أفضى إلى حرام.
وذكر في التّاج المذهب أنّ ما يقع في العرسات وسائر أوقات السّرور كالعيد وزيارة الإخوان ولقائهم ونحو ذلك من أوقات الفرح والتّرح من رفع الصّوت بالشّعر، والتّغني بالألفاظ المشتملة على الحكم والمواعظ ومكارم الأخلاق، وإيقاظ الأفكار إلى السّعي لنيل كلّ خير، والمشتملة على وصف الأزهار والرّياحين والخضر والألوان والماء ونحو ذلك، أو المشتملة على وصف إنسان غير معين إذا لم يترتب عليه فتنة محرّمة؛ فإنّه مباح لا ضرر فيه، وكذا إنشاد الشّعر مع الضّرب بالدّفوف، واللّعب بالدّرق والحراب، أو الخناجر، والرّقص المعروف بالبرع الّذي يفعله الرّجال أمام مثلهم فهو كما تعلم لا يثير أي شهوة.
وأمّا المدرسة الجعفريّة فهي نسبة إلى أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق [ت 148هـ] الإمام السّادس لدى الإماميّة والإسماعيليّة، وينسب إليه فقها لعلمه وفضله.
يرى محمّد حسين آل كاشف الغطاء [ت 1954م]، حيث يرى أنّ الغناء سواء رافقه الطّرب (الموسيقى) أم لا مباح ما لم يستخف السّامع إلى حدّ يخرج معه عن الكمال، فهو إذ ذاك غير مشروع، ويرى محمّد حسين فضل الله [ت 2010م] أنّ المحرم في الغناء ما كان مشتملا على الكلام الباطل الّذي يؤدي إلى الضّلال الفكريّ والرّوحيّ والأخلاقيّ، مع كون اللّحن متناسبا مع أجواء الإثارة غير الأخلاقيّة، بحيث يكون من ألحان أهل الفسوق، فهذا يترك تأثيره السّلبيّ على أفكار الإنسان وتصوراته ومشاعره، ويخلص إلى أنّ الموسيقى جائزة إلا إذا كانت متناسبة مع ألحان أهل الفسوق.
سؤالنا القادم:
- هل توجد رؤية فقهيّة منفتحة في السّنيّة الأربعة والظّاهريّة؟ هذا سنناقشه في الحلقة القادمة.
الحلقة الثّالثة عشرة: الرّؤية الفقهيّة المنفتحة في المدارس السّنيّة الأربعة والظّاهريّة
سؤال الحلقة:
- هل توجد رؤية فقهيّة منفتحة في السّنيّة الأربعة والظّاهريّة؟
المدرسة الحنفيّة نسبة إلى المنسوبة إلى أبي حنيفة [ت 150هـ]، وهو من أوائل وكبار علماء مدرسة أهل الرّأي، وأنّ أبا حنيفة سئل هو وسفيان الثّوريّ [ت 161هـ] عن الغناء فقالا: ليس من الكبائر، ولا من أسوأ الصّغائر، ويقول وهبة الزّحيليّ [ت 2015م]: “الحنفيّة اختلفوا في الغناء بدون آلة، ذهب بعضهم إلى تحريم سماعه، بينما ذهب الآخرون إلى جواز سماعه من غير كراهة”، ومن متأخري الحنفيّة عبد الغني النّابلسيّ [ت 1143ه] حيث ألف رسالة سماها إيضاح الدّلالات في سماع الآلات، وبين أنّ الأصل في سماع الأصوات والآلات الإباحة، إلا إذا اقترن بها محرّم، أو اتخذ وسيلة إلى المحرم، فيصبح حراما بهذا، وإذا خلا من هذا كان مباحا في حضوره وسماعه وتعلّمه .
والمدرسة المالكيّة نسبة إلى مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحيّ [ت 179هـ.]، من أهل المدينة، من كبار العلماء وفقهاء تابعي التّابعين، يقول ابن رشد الحفيد [ت 520هـ] في مقدّمته للمدونة الكبرى “أنّه يجوز ضرب الدّف وشبهه في إشهار النّكاح”، ويذكر الشّوكانيّ [ت 1255هـ] أنّ مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف، وعليه بعض المالكيّة، وبين ابن العربيّ [ت 543هـ] أنّه لم يصح في أحاديث المنع شيء.
وأمّا المدرسة الشّافعيّة فنسبة محمّد بن إدريس الشّافعي [ت 204هـ]، ولد في غزة بفلسطين، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين، وآخر حياته استقر في مصر، وذكر أنّ يونس بن عبد الأعلى [ت 261هـ] أي تلميذ الشّافعي، سأل الشّافعيّ عن إباحة أهل المدينة السّماع، فقال: لا أعلم أحدا من أهل الحجاز كرّه السّماع، إلا ما كان منه في الأوصاف، فأمّا الحداء، وذكر الأطلال والمرابع، وتحسين الصّوت بألحان الأشعار فمباح.
ويعلل الغزاليّ [ت 505هـ] استثناء الشّارع للأوتار والمزامير من القضيب والطّبل والدّف لم يكن لذاتها؛ بل لما اقترن بها من بعض المنكرات عادة كشرب الخمور، وعادة اجتماع أهل الفسق عليها، فإذا وجدت مع قوم غير مقترنة بالمنكرات، ولم تكن مختصة لأهل الفسق؛ في هذه الحالة يتغير الحكم، وتنتقل من المنع إلى الإباحة ، وبمثل تعليل الغزاليّ يرى شلتوت أنّ الآلات والمعازف ليست محرمة لذاتها؛ وإنّما تكون تابعة للغاية الّتي استعملت فيها، حيث لا يفرّق بين آلة وأخرى، فحلالها حلال، وحرامها حرام .
والمدرسة الحنبليّة نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل [ت 241هـ]، من أئمة مدرسة أهل الحديث، يقول ابن قدامة [ت 630هـ]: واختلف أصحابنا – أي الحنابلة – فذهب أبو بكر [ت 311هـ] وصاحبه أبو بكر بن عبد العزيز [ت 363هـ] إلى إباحته، وكان الخلّال يحمل الكراهة على أحمد على الأفعال المذمومة لا على القول بعينه، وذكر الشّريف الحسنيّ [ت 1341هـ] أنّ أحمد بن حنبل صحت الرّواية عنه أنّه سمع الغناء عند ابنه صالح [ت 265هـ]، فقال له ابنه: كنت تكرهه؟! فقال: إنّي بلغني أنّه يستصحب معه المنكر، فإذا كان مثل هذا فنعم .
وممن تساهل فيه من المعاصرين من الحنابلة ولو مع آلة مثل أحمد الغامديّ [معاصر] ، وعادل الكلبانيّ [معاصر] ، وصالح المغامسيّ [معاصر] .
وأما المدرسة الظّاهريّة نشأت مع داود بن عليّ الظّاهريّ [ت 270هـ] في القرن الثّالث الهجريّ، وسميت ظاهريّة لأنّها تأخذ بظاهر النّصوص من الكتاب والسّنة [الرّوايات] والإجماع، وترفض جملة ما عداه من قياس ومصالح مرسلة واستحسان وسدّ الذّرائع وشرع من قبلنا ونحوه، وقد تطورت في القرن الخامس مع ابن حزم الأندلسيّ [ت 456هـ]، ومن بعده ابن القيسرانيّ [ت 507هـ].
وفي الجملة اشتهر الظّاهريّة بإباحة الغناء والمعازف، وصرّح ابن حزم أنّه لا يصح في هذا الباب – أي باب التّحريم للغناء والمعازف – شيء أبدا، وكلّ ما فيه موضوع، ووالله لو أسند جميعه، أو واحد منه عن طريق الثّقات عن رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – لما ترددنا في الأخذ به .
وتابعه أبو الفضل محمّد بن طاهر القيسرانيّ الظّاهريّ الّذي ناقش الأدلّة بصورة أوسع مستخدما المنهج الحديثيّ وخلص إلى جواز ذلك غناء وآلة .
ومن المعاصرين محمّد بن عمر العقيل المعروف بابن عقيل الظّاهريّ [معاصر]، وقد كتب رسالة عن نجاة الصّغيرة [معاصرة] فيما لا يقل عن سبعين صفحة، وعمره خمس وعشرون عاما، حيث تحدّث عن ولادتها، ونشأتها، وأغانيها، ومن لحنها، وغنى بها.
سؤالنا القادم:
- هل توجد أدلة من القرآن تحرم أو تبيح الغناء والمعازف؟ هذا سنناقشه في الحلقة القادمة.
الحلقة الرّابعة عشرة: هل توجد أدلة من القرآن تحرم أو تبيح الغناء والمعازف
- هل توجد أدلة من القرآن تحرم أو تبيح الغناء والمعازف؟
القرآن الكريم لم يتطرق إلى قضيّة الغناء والمعازف بقدر ما تطرق إلى آيات الوجود والكون كالجمال في مخلوقاته، وما ذكر حول بعض الآيات إنّما هي إسقاطات اجتهاديّة تأثرا بأدلّة خارجيّة، أو لوازم ظرفيّة معينة، وليست هي النّص ذاته، فهي مصاديق قابلة للتّصديق والإسقاط.
واستدل فريق من يرى الإباحة بقوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [فاطر/ 2].
والشّاهد قوله سبحانه: {يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ} فسّرت بعدّة تفسيرات منها: الصّوت الحسن، فقال هو نعمة من نعم الله تعالى، والغناء صوت جميل، سواء خرج من حنجرة بشر أو أوتار آلة.
والصّواب الآية مطلقة وعامّة كما يقول الرّازيّ [ت 606هـ]: “من المفسرين من خصصه وقال المراد الوجه الحسن، ومنهم من قال الصّوت الحسن، ومنهم من قال كلّ وصف محمود، والأولى أن يعمم، ويقال الله تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء، فيزيد ما يشاء، وينقص ما يشاء”.
واستدل المانعون للغناء والمعازف بعدّة أدلة من القرآن أشهرها قوله تعالى في سورة لقمان آية 6: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} .
وقد جمع الماورديّ [ت 450هـ] هذه في سبعة أقوال منها شراء المغنيات، والغناء كما عند ابن مسعود، والشّرك بالله، والجدال في الدّين.
ولكثرة الآراء وضعف من روي حول من أسباب النّزول ذهب ابن حزم إلى [ت 456] أنّه: “لا حجة في هذا لوجوه أحدها: أنّه لا حجة لأحد دون رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم -، والثّاني: أنّه قد خالف غيرهم من الصّحابة والتّابعين، والثّالث: أنّ نصّ الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأنّ فيها: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ}، وهذه صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف؛ إذا اتّخذ سبيل الله هزوا، ولو أنّ امرأ اشترى مصحفا ليضلّ به عن سبيل الله؛ كان كافرا بلا خلاف، فهذا الّذي ذمّ الله تعالى، وما ذمّ قط من اشترى لهو الحديث ليتلهى به، ويروّح نفسه، لا ليضلّ عن سبيل الله” .
ويقول فضل الله [ت 2010م] في تفسيره: “وإذا كانت بعض الأحاديث المأثورة قد فسّرت لهو الحديث بقصص الأكاسرة والجبابرة، أو بالغناء؛ فإنّ الجو الّذي تتحرك به الآية أوسع من ذلك، فهي تتحرك في خطّ النّتائج العمليّة، لما يقدّمه هؤلاء من أحاديث، يحاولون بها إشغال النّاس عن كلمات الله، وعن دينه”
فالآية معللة بالإضلال كما عند القرطبيّ [ت 671هـ]: وترجم البخاريّ [ت 256هـ] باب كلّ لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله، وإلا إذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم كان لغناء أم غيره.
ومن أدلتهم قوله تعالى في سورة الإسراء آية 64 {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ}، حيث فسّر مجاهد [ت 104هـ] الصّوت بالغناء واللّهو ، وفسّره الضّحاك [ت 111هـ] بصوت المزمار ، وقيل بصوتك أي بوسوستك ، بينما ذهب ابن عباس [ت 86هـ] إلى عموم الدّعاء إلى معصية الله تعالى، لهذا يقول الطّبريّ [ت 310هـ]: “وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصّحة أن يقال إنّ الله تبـارك وتعالـى قال لإبلـيس: واستفزز من ذرّية آدم من استطعت أن تستفزّه بصوتك، ولـم يخصص من ذلك صوتا دون صوت”، وبالعموم ذهب أيضا ابن سعديّ [ت 1376هـ] حيث يرى أنّه يدخل في هذا كلّ داع إلى المعصية ، ورجّحه قطب الأئمة [ت 1332هـ]، واعتبر العموم أحسن لأنّه أعمّ .
فالآية ولا علاقة لها بالغناء والمزامير واللّهو، إلا إذا استخدمت في الشّر فتكون كأي وسيلة حكمها حكم الغاية الّذي تستخدم فيه.
سؤالنا القادم:
-كيف نتعامل مع تناقض الرّوايات الحديثيّة حول الغناء والمعازف؟ هذا سنناقشه في الحلقة القادمة
الحلقة الخامسة عشرة: كيف نتعامل مع تناقض الرّوايات الحديثيّة حول الغناء والمعازف؟
سؤال الحلقة:
- كيف نتعامل مع تناقض الرّوايات الحديثيّة حول الغناء والمعازف؟
جمّع محمّد رشيد رضا [ت 1935م] روايات المنع فوجدها تدور حول ولهذا ذكر صاحب المنار أهم روايات الحظر وروايات الإباحة، فيرى أهم روايات الحظر تسع روايات ، وتتمثل في رواية مجيء قوم من الأمّة يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ورواية وضع ابن عمر [ت 73هـ] أصبعيه في أذنيه لمّا سمع صوت زمارة، وعدل عن الطّريق، ورواية تحريم الكوبة أيّ الطّبل، ورواية الخسف والمسخ والقذف الّذي سيكون في الأمّة بسبب ظهور المعازف والخمر، ورواية الرّيح الحمراء الّتي ستظهر في الأمّة بسبب عدة مفاسد ومنها ظهور القيان والمعازف، ورواية المسخ إلى قردة وخنازير بسبب استحلال الخمر وضرب الدّفوف واتخاذ القيان، ورواية أنّ النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – أمر بمحق المزامير والكبارات أي المعازف، ورواية النّهي عن بيع القينات أي المغنية وشرائهنّ، ورواية ابن مسعود [ت 32هـ]: الغناء ينبت النّفاق في القلب.
وخلص أنّه لا يصح من هذه الأحاديث إلا الأول، أي رواية عبد الرّحمن بن غنم [ت 178هـ] قال: حدّثني أبو مالك [توفي في عهد عمر 13 – 23هـ] أو أبو عامر [توفي في عهد عبد الملك 65 – 86ه] سمع النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – يقول: ليكوننّ من أمّتي قوم يحلّون الحر ، والحرير، والخمر، والمعازف، اتفق المحدثون على صحة الرّواية سندا، وخالفهم ابن حزم [ت 456هـ]، وذهب إلى أنّها موضوعة بدليلين: الأول “الانقطاع ما بين البخاريّ [ت 256هـ] وهشام [ت 145هـ] ، “حيث قال البخاريّ: قال: هشام، مع أنّ لفظة قال ليست من صيغ الاتصال، والبخاريّ لم يلق هشاما، فالحديث منقطع، والمنقطع كما هو معلوم من أقسام الضّعيف، قلتُ – أي ابن حزم -: فضلا على أنّ هشاما متكلّم فيه”.
ورأى المجيزون بدلالة رواية ابن ماجه وهي أصح أنّ المجيزون أنّ الرّواية معللة، حيث بينت العلّة من الحرمة ليس لذات المعازف والغناء، وإنّما ما يصاحبه من صفات منكرة.
وهكذا عموم الرّوايات الأخرى إمّا معللة أو لا تخلو من ضعف بسبب سند أو انقطاع أو تهويل في مسألة فرعيّة، ممّا يشم منها رائحة الوضع.
استقرأ أيضا رشيد رضا روايات الإباحة فوجدها تدور حول ست روايات، وهي رواية الجاريتين اللّتين تغنيان بمحضر النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – غناء بعاث، ورواية حبّ الأنصار للّهو، ورواية الجويريات اللّاتي يضربن بالدّف، ورواية الفصل بين الحلال والحرام الدّف والصّوت في النّكاح، ورواية ترخيص اللّهو في العرس، ورواية نذر الجارية أن تضرب بالدّف وتغني بين يدي النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم.
من خلال المقارنة بين أدلّة الفريقين نجد أنّ أدلّة المجيزين في الجملة أقوى سندا، وأقرب إلى روح الشّريعة، وأبعد عن التّكلف في الصّناعة الحديثيّة، واستخدام العبارات التّهويليّة كاللّعن في قضايا فرعيّة، وارتبطت بجانب عمليّ في المدينة المنورة، لهذا نرى أولى بالانطلاق منها لتفكيك روايات النّهي، فإن صح بعضها لا يخرج عن العليّة المصاحبة للسّلوك السّيء لا لذات الغناء والمعازف، فيبقى على أصله في الحليّة والإباحة.
سؤالنا القادم:
- هل يوجد إجماع على تحريم الغناء والمعازف؟ هذا سنناقشه في الحلقة القادمة.
الحلقة السّادسة عشرة: هل يوجد إجماع على تحريم الغناء والمعازف؟
سؤال الحلقة:
– هل يوجد إجماع على تحريم الغناء والمعازف؟
للإجابة عن هذا السّؤال يترتب علينا تعريف الإجماع وبيان شرطة بشكل عام، فالإجماع “في عرف الأصوليين والفقهاء وعامّة المسلمين اتفاق علماء الأمّة على حكم في عصر، وقيل: اتّفاق أمّة محمّد – صلّى الله عليه وسلّم – على أمر، وزاد بعضهم: ولم يسبقه خلاف مستمر” ، ومن شروطه أن يكون للمجمعين مستند يستندون إليه من كتاب أو اجتهاد كان ذلك المستند قطعيّا أم ظنيّا ، وأن لا يكون هناك نص من كتاب أو سنّة أو إجماع يخالف ما أجمعوا عليه .
حكا الأغلب ممّن يرى الحرمة خصوصا مع حضور الآلات الإجماع إلا ما خصص كالدّف في العرس للنّساء، وفي المقابل نقض الشّوكانيّ هذا الإجماع [ت 1250هـ] في كتاب السّماع، وبيّن لا وجود له، وقبله كذلك أبو الفتوح الغزالي في رسالته حول السّماع وغيره.
وبما أنّ الإجماع ينبني على دليل سابق من كتاب أو سنّة أو اجتهاد، رأينا لا يوجد دليل قرآني ظاهر في قضيّة الغناء بالكليّة، وإنّما ترك الأمر للفهم البشريّ، وأمّا السّنة والرّوايات فمتناقضة ما بين إقرار الجواز، وروايات المنع، ولكون التّناقض ممتنعا لابدّ أن يكون أحدهما صحيحا والآخر باطلا، فإذا أمكن الجمع في التّرجيح فيها كان بها، وإلا لزم سقوط أحدهما لرفع التّناقض، وإلا كانت الأدلة مضطربة ومتناقضة، فهناك من جعل أدلّة الجواز حاكمة لأنّها تتوافق مع أصل الإباحة، وهناك من أبطلها بأدلّة الحرمة، أو جمع بينهما إذ خصص الجواز لبعض ما يماثله كعرس، ونحن إذا تأملنا الأدلّة كما رأينا سلفا نجد أدلّة الجواز أقرب إلى روح الشّريعة، وأبعد عن التّكلف في الصّناعة، ولأنّها الأصل من الجواز، دلّ هذا على أنّ الإجماع أيضا لم ينبن على دليل صريح من السّنة، فإذا بطل مستند الكتاب والسّنة بقي مستند الاجتهاد، ونحن نجد الخلاف ظاهرا من عهد الصّحابة وتابعيهم إلى يومنا هذا، فهذا دليل على عدم وجود إجماع في المسألة، وبقاء هذه القضيّة في دائرة الرّأي الواسع الذّي لا يترتب عليه تفسيق فضلا أن يترتب عليه تكفير، فمن أراد أن يتورع فلنفسه، ومن انفتح سماعا ومهنة فالأمر واسع له.
سؤالنا القادم:
- هل يمكن منع الغناء والمعازف بدليل سدّ الذّريعة أو الذّرائع؟ هذا سنناقشه في الحلقة القادمة.
الحلقة السّابعة عشرة: هل يمكن منع الغناء والمعازف بدليل سدّ الذّريعة أو الذّرائع؟
سؤال الحلقة:
- هل يمكن منع الغناء والمعازف بدليل سدّ الذّريعة أو الذّرائع؟
اختلف اختلافا كبيرا في قضيّة سدّ الذّرائع وتحديد مفهومه وشرائطه ما بين معمم ومخصص، ومتوسع ومضيق، فمن أشهر تعاريفه: التّوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة ، أو المسألة الّتي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى ممنوع .
فتوسع بعضهم في تطبيق هذه القاعدة على المعازف والغناء، باعتباره وسيلة إلى محرّم كشرب الخمر، أو الزّنا، أو إضاعة واجب، أو تلف مال، ونحوه، والسّبب في هذا إمّا ظاهر بعض الرّوايات كما أسلفنا، أو أنّ استخدامها ساير هذه السّوءات كما في السّياق التّأريخيّ.
وسدّ الذّرائع ليس دليلا إطلاقيّا بقدر ما يكون قرينة ظرفيّة تدبيريّة، وفي الوقت نفسه ليس دليلا وحجة مطلقة بقدر ما يسايرها الجوانب التّكليفيّة والوضعيّة، وعليه تحويل الظّرفيّ النّسبيّ إلى مطلق يؤثر في أصل الإباحة وما خلقه الله للعباد ليتمتعوا به، ونحو هذا يقول محمّد باقر الصّدر [ت 1980م]: “وحينما يتحول النّسبيّ إلى مطلق إلى إله من هذا القبيل؛ يصبح سببا في تطويق حركة الإنسان، وتجميد قدراته على التّطور والإبداع، وإقعاد الإنسان عن ممارسة دوره الطّبيعيّ المفتوح في المسيرة” .
ونحن إذ نعذر بعض المتقدّمين لسوء استخدام هذا الجمال الفنيّ بقدر ما ننقد تأصيلهم المتشدد وتعميمه كأنّه من قطعيات الشّريعة، فضلا عن صناعة نصوص روائيّة تدعمه من قبل بعض الوعاظ، وبقدر ما نحترم هذا الرّأي وإن رأيناه متشددا نلومه في الوقت المعاصر ونحن نرى أنّ الغطاء انكشف اليوم، فلم تعد سهرات الأمس المغلقة في قصور الخلفاء على الجواريّ والخمرة هي السّائدة، حيث أصبحت الموسيقى والغناء لها سبلها في التّعليم والعلاج والاستراحات والتّلفزة والأغاني العسكريّة والوطنيّة والاجتماعيّة والتّربويّة، والسّماع الديّنيّ والعرفانيّ، وغيره كثير، فلا معنى للتّضييق والتّشديد تحت قاعدة سدّ الذّرائع!!!
حيث لا يوجد دليل صريح لمنع الغناء والمعازف أو تحريمه، وإلا لذكره الله في كتابه صريحا، وما جاء من نهي لا يخرج عن دائرة العليّة السّلبيّة، فإن ارتفعت عاد إلى أصل الإباحة؛ لأنّه من الجمال الذّي بثه الله تعالى في مخلوقاته، وما حاكاه الإنسان في صنع آلات وأشعار تناغم هذا الجمال، حتى تحول إلى صنعة وعلم يدرس ويتقن، وهذا لا يعني أنّه ليس للبشر حق التّقنين بما يحفظ المقاصد الخمس أو السّت الّتي تدور حولها مقاصد التّشريع والتّقنين.
سؤالنا القادم:
هل الغناء خاص بالرّجل ويمنع على المرأة؟ هذا سنناقشه في الحلقة القادمة.
الحلقة الثّامنة عشرة: المرأة والغناء
سؤال الحلقة:
- هل الغناء خاص بالرّجل ويمنع على المرأة؟
المرأة كائن بشريّ، وهي سيان مع الرّجل في التّشريع، فلا يخصص أحدهما عن الآخر إلا بمخصص واضح بما يوافق فطرتهما، وإلا الأصل عموم الإباحة والتّشريع.
وإذا جئنا إلى موضوع الغناء والمعازف سنجد فريقا كبيرا من الفقهاء يمنع المرأة من الغناء، وبعضهم يخصص الزّوجة لزوجها فقط، وبعضهم يتوسع قليلا حيث يجيز المرأة لمثيلاتها، وفي حالات معينة كالعرس، وبآلة مباحة وهي الدّف، وأن يكون المغنى سليما، لا فاحشا ولا فاجرا، وبعضهم بالغ وأدخل الشّاب الأمرد في جنس المرأة من المنع.
ويستند هؤلاء إلى أربعة أدلّة رئيسة: الأول قوله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} ، والأصل عموم الخطاب في الآية – أي ليس خاصّا بنساء النّبيّ عليه السّلام -، والثّاني: أنّ صوت المرأة عورة، ويثير الغرائز، والثّالث: الأمر بسدّ الذّريعة، والرّابع: لم يعهد هذا في العهد الأول ولا السّلف الصّالح.
وأمّا الآية إذا سلّمنا بعموم الخطاب فيها فمفهومها منع التّكسر والخضوع في الكلام، ولا علاقة للغناء بالتّكسر والخضوع؛ لأنّ الآية لا تخرج عن السّلوكيات المجلسيّة واللّقائيّة الّتي يصاحبها أحيانا ليونة، فإذا ارتفع ذلك ارتفع الأمر، فكيف والرّسول – صلّى الله عليه وسلّم – وصحابته سمعوه من الجواريّ، فّإذا صاحب الغناء خضوع وتكسر شمله الحكم، وإذا كان غناء متزنا شمله الجواز من رجل أو امرأة.
أمّا كون صوت المرأة عورة فهذا يخالف النّقل والعقل، والتّصديق التّشريعيّ والعمليّ، أمّا النّقل فقد أورد القرآن المرأة كشريك مشارك بقوّة في القصص القرآنيّة، خلطة وحديثا، كما في مريم (ع) مع قومها، وبلقيس مع قومها ومع سليمان (ع)، وهذه المرأة حاضرة في حياة النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – ومن بعده إلى يومنا هذا، وعليه كان هذا لأنّه عقلا لا يمكن نزعه من التّكوين البشّريّ، فلازمه التّصديقان التّشريعيّ والعمليّ، “فالمرأة والرّجل كائن اجتماعيّ، ليس بمقدوره أن ينعزل عن الآخر مهما كانت الظّروف، وأنّ المطلوب هو تنظيم هذه الإفرازات والمنبهات الجنسيّة، حتى ولو كان في أعماق كلّ منهما شعور جنسيّ حيال الآخر، إذ لا يعني ذلك أنّ حركة الجنس الدّاخلية الّتي لم تظهر بعد ممّا يجب إلغاؤها” .
وأمّا سدّ الذّرائع فهو وظرفي غير مطلق، وأمّا نظريّة السّلف الصّالح فلا حجة فيها؛ لأنّه ليس دليلا على الصّحيح، فهي تجربة بشريّة خاضعة للظّروف المجتمعيّة، وكيف وقد وجد الرّأي الآخر أيضا ومن الجواريّ منذ فترة مبكرة جدّا.
وعموما نخلص أنّ المرأة والرّجل سيان في الجواز، كأن تسمع المرأة من الرّجل والرّجل من المرأة، شريطة مراعاة الأدبيات الأخلاقيّة والعرفيّة، وأن لا يكون المغنى داعيا إلى محرمات قطعيّة، وما عداه يشمله عموم الإباحة، وما يجده البعض كأفراد من ميولات داخليّة جنسيّة، فهي إفرازات فرديّة لا تعطي حكما جمعيّا يؤثر في أصل الإباحة المطلقة.
سؤالنا القادم:
هل توجد تطبيقات معاصرة للغناء والمعازف؟
الحلقة التّاسعة عشرة: تطبيقات معاصرة في الغناء والمعازف
سؤال الحلقة:
- هل توجد تطبيقات معاصرة للغناء والمعازف؟
من التّطبيقات المعاصرة ما يتعلّق بالطّفل، فالطّفل يعشق الصّوت الجميل، ورأينا والمرأة منذ القدم ترقص طفلها وتغني له لينام، واليوم توجد دمى تحوي أصواتا وأغاني موسيقيّة، بل وأصبحت الموسيقى مادّة تعليميّة للطّلاب منذ فترة مبكرة، تغذي فيهم الحس الرّوحيّ والوجدانيّ، ولها حضور في الألعاب والأفلام التّعليميّة، ولا أحد يقول في هذا مفسدة، أو دعوة إلى حرام، فبقي أصل الإباحة والجواز، إذ لا تعارض فيها والمصالح التّكوينيّة للإنسان، بل تساهم في تهذيبها ورقيها.
ومن التّطبيقات المعاصرة ارتباط الموسيقى بالعلاج، فالموسيقى إذا استخدمت استخداما سيئا كالموسيقى الصّاخبة لا شك سوف تضر الإنسان في سمعه مثلا، والموسيقى الاسترخائيّة أو العلاجيّة فهي مفيدة للإنسان، بما تعطيه من طاقات إيجابيّة، تخلّصه من بعض السّموم، وتركنه إلى الهدوء والرّاحة، فلا مانع منها عقلا ولا شرعا.
وهكذا ما يتعلق اليوم بموسيقى المؤثرات الصّوتيّة والأخبار والموسيقى الحربيّة والسّاعات وقاعات الانتظار.
كذلك الغناء أصبح اليوم تخصصاته كثيرة، وليس مجرد ملاهي أو حفلات ليليّة، فهناك الأغاني والموسيقى الحربيّة، والمعلّم الّذي يفرّغ نفسه لتدريس هذا الفنّ، والملحن الّذي يقطع الكثير من وقته في الإبداع وإنتاج الجديد، والمغني الّذي يفرح النّاس في أفراحهم وأعيادهم، فهؤلاء يبذلون وقتهم في شيء نافع للمجتمع البشريّ، فلا مانع أن يكون منه كسبهم، فهو في دائرة الحلال لا الحرام.
فهذا كلّه لا يخرج عن الجمال الّذي رآه في الكون وقام بمحاكاته، فطالما تمتع بجمال السّماء والنّجوم، وشدّ رحاله في السّهول والسّواحل والجبال والغابات، حتى أصبحت السّياحة اليوم فنّا جماليّا يتسابق فيه العالم، ليتعرف الإنسان ويكتشف أكثر جمال الطّبيعة.
كذلك تَمتَعَ الإنسان بجمال الصّوت، فهو يتمتع بصوت العصافير، وصوت حنجرة الإنسان الطّبيعيّة.
وأمّا الملموس والمتذوق فهو يلمس جماليات ما حوله يتمتع بهم كملاعبته لأطفاله، وتذوقه لكلّ ما هو طيب من الطّعام والشّراب.
لذلك حاول الإنسان منذ بداياته البحث عن الجمال وفهمه ومن ثمّ تقليده، أمّا تقليده فله صور عديدة من ذلك جمال اللّباس، {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}، واللّباس تقليد للباس الطّبيعة، وحاول الإنسان تطويره في أشكاله ورسوماته، وتعدد اللّباس في ذاته فنّ إنسانيّ بديع.
كذلك قلّد جمال الطّبيعة في صنع بيته والتّفنن فيه، ممّا اعطى للهندسة المعماريّة ذوقا جماليّا وفنيّا، وحاول أيضا تقليد أصوات الطّبيعة في صنع الآلات والألحان، وابتكار المقامات والقواعد الموسيقيّة، بجانب الإبداع الشّعريّ وقواعده، والفنون الشّعبيّة.
وفي المقابل كان التّصوير والنّقش والرّسومات الفنيّة، واليوم الإبداع الرّسميّ عن طريق الفوتوشوب والرّسومات الالكترونيّة، وجاءت الأديان السّماوية لإضافة بعد جمالي روحي ليتكامل الجمالان الروحيّ والبدنيّ.
سؤالنا القادم: كيف ينظر القرآن إلى الجمال؟
الحلقة العشرون: القرآن والجمال
سؤال الحلقة: كيف ينظر القرآن إلى الجمال؟
ينظر بعضهم إلى فلسفة الجمال في المنظور الفقهيّ الإسلاميّ بحساسيّة مبالغ فيها؛ لأنّه يتصور الجمال عريا وسفورا وبعدا عن تعاليم السّماء، لذلك كانت النّظرة الفقهيّة خصوصا وما ينتج عنها من أبعاد اجتماعيّة أقرب إلى السّلبيّة في الكثير من الوسائل الجماليّة، بجانب قلّة الأبحاث الفقهيّة في الجمال كنظرة فلسفيّة، فمع تطور الفنّ فيما يخص الغناء والموسيقى في المجتمع العباسيّ إلا أنّه في المقابل اشتهر القول بالتّحريم بدافع الزّهد والورع، ولأنّ الغناء والمعازف كانا مصاحبين غالبا لمجالس الأنس وشرب الخمر، وشاعت الحرمة بين النّاس وتناقلوها .
لهذا حاول العديد من المعاصرين تغيير الصّورة النّمطيّة في النّظرة الفقهيّة للجمال في الإسلام، ومن هؤلاء محمّد عمارة [معاصر] في كتابه الإسلام والفنون الجميلة، وبين فيه أنّ الإسلام في أصله دين جمال، وجاء لتمكين هذا الجمال والحفاظ عليه وضبطه بما يتوافق وفطرة الإنسان، وأنّ هناك ممّن يجعل خصومة بين الإسلام والجمال، ويظهر ذلك من خلال السّلوك المتجهم إزاء آيات الجمال والفنون والإبداعات الجماليّة في هذه الحياة .
وعليه حاول نقض الصّورة السّلبيّة من داخل النّص الدّينيّ الإسلاميّ ذاته، فالآيات القرآنيّة تنطلق بالإنسان بداية إلى جمال الكون، والإنسان أمر بالنّظر في هذه الآيات الكونيّة والتّمتع جماليّا بها، واستخدم القرآن عبارات الجمال نحو قوله تعالى: {وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ} ، فلفظة الزّينة هي لفظة جمال .
والقرآن الكريم أمر المسلم بالتّزين والجمال، وفي الوقت نفسه أنكر فيمن شدّد وحرّم ذلك على نفسه، أمّا الأول فيظهر من خلال قوله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} ، وأتبعها مباشرة بقوله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} .
ثمّ عرّج عمارة إلى نماذج عملية للجمال النّبويّ كمثل تسريحه – صلّى الله عليه وسلّم – لشعره، وتزينه وتعطره، وظهوره الجماليّ في لباس وحسن هيئته، واختياره لأصحابه الاسم الحسن، وكان يحب الجميل من الطّعام، بلا تقتير ولا إسراف، وحبّه للصّوت الحسن، وتحببه إلى خَدمه وحسن معشره، وعدم إنكاره على النّاس في لهوهم في أعيادهم، أي ما يسمى اليوم بالفنون الشّعبيّة .
وقد جمع القرآن بين الجمالين الماديّ والقلبيّ، فكما أنّ هناك جمال المادة المتمثلة في الصّورة الحسنة؛ هناك جمال الرّوح والقلب المتمثل في التّواضع والتّسامح والتّعارف والحب للإنسان وعدم الكبر والظّلم، مع العدل والقسط، حتى مع المخالف، يقول سبحانه: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} ، والبر والقسط أعلى درجات الجمال الاجتماعيّ.
والقرآن يؤكد على ذلك مع النّاس جميعا في صورة جماليّة لا تقتصر عند جماليّة حسن الاصطفاف في المسجد، وفنيّة النّقوش، وعمارة البيوت والصّوامع؛ بل ينطلق إلى جماليّة الفنّ الاجتماعيّ مع جميع شرائح المجتمع، كما يتجسد من قوله تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} .
[1] المصدر نفسه، ص: 106 – 107.