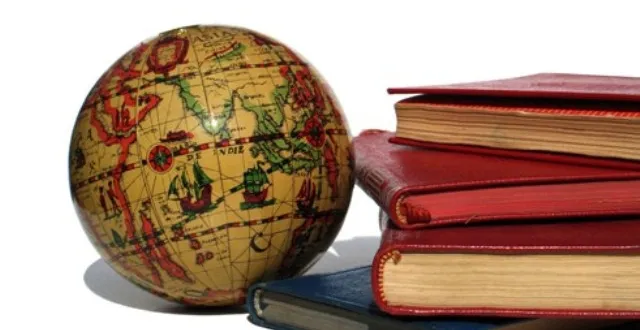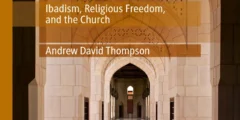جريدة عُمان 1443هـ/ 2022م
لم يعد التّأريخ اليوم من حيث مصادره مقتصرا على الرّوايات والقصص الواردة في الكتب المقدّسة أو الكتب التّراثيّة والأدبيّة والسّيريّة، كانت مسندة أو غير مسندة، فالعلم اليوم بحساباته الرّياضيّة والفيزيائيّة يساهم أيضا في كشف الماضي، كما يساهم في كشف الحاضر، كما لعلم الآثار والإحياء مساهمة كبيرة في قراءة الماضي من جهة، وفي تفكيك ونقد الرّواية التّأريخيّة من جهة ثانيّة.
إلا أنّ علم التّأريخ كغيره من العلوم المعاصرة قد يصطدم في قراءاته ببعض المقدّسات اللّاهوتيّة ظاهرا، مثله كمثل علوم الإحياء والطّب وغيرها، من هنا تحدث بعض الجدليات في القراءات التّأريخيّة، ويمكن أن نميّز ثلاثة اتّجاهات رئيسة يشتغل عليها ممن يدرس هذا الجانب، من حيث لباس العلم وتقاطعه مع لباس المقدّس من حيث النّص اللّاهوتي.
الاتّجاه الأول يمايز بين اللّباسين، كالّذي يدخل في حقل التّجارب العلميّة يدخل بلباس العلم، فهو لا يعني أنّه نزع لباس الدّين من عنقه، أو كان منكرا لمقدّساته اللّاهوتيّة، فالعديد من علماء الطّبّ والتّشريح والفيزياء وغيرهم لاهوتيون، وإن كانوا يمايزون بين اللّباسين وقت البحث والكشف والنّظر في السّير في كشف أغوار العلوم، فكذلك من علماء التّأريخ من يسبر أغوار الماضي، باحثا عن الأساطير والخرافات والرّوايات والقصص والآثار الماديّة والشّفويّة، والّتي العديد من نتائجها ما قد يتعارض ظاهرا عن ما ورد في الكتب المقدّسة، وخصوصا التّوراة والتّناخ؛ لأنّ ما جاء بعدها متقابس منها تصديقا أو هيمنة، وهذا الفريق يمثله العديد من الباحثين التّأريخيين الغربيين، وله حضوره العربيّ كما عند خزعل الماجديّ وفراس السّواح وغيرهم، لهذا يُقرأ هذا الجانب في جوّه العلميّ المعرفيّ، ولا ينبغي إسقاط الأحكام اللّاهوتيّة المسبقة عليه كالتّكفير والرّدة، بل ينبغي تشجيع المجالات العلميّة في جوّها المعرفيّ والسّيري كما أخبر القرآن نفسه: {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [العنكبوت: 20].
والاتّجاه الثّاني هو الاتّجاه الفلسفيّ، فهذا لا يهتم كثيرا بمصدريّة الرّوايّة التّأريخيّة، بقدر ما يهتم بالقيمة الفلسفيّة الكامنة في النّصّ التّأريخيّ، ومثل هذا قيم الحضارة والاجتماع البشريّ، فهو يقرأ النّصّ قراءة فلسفيّة، وقد يحاكمه ويتعامل معه أيضا تعاملا فلسفيّا، كمكر التّأريخ عند هيجل [ت 1831م]، وقد يتجاوز هذا الفريق القراءات القيميّة الفلسفيّة، والتّعامل البنيويّ مع النّصّ التّأريخي، إلى القراءات ما بعد البنيويّة، متمثلة في المناهج التّفكيكيّة والتّقويضيّة كما عند جاك دريدا [ت 2004م]، وكما في الدّراسات الثّقافيّة المعاصرة والسّيميائيّة، ويدخل في القراءات التأريخيّة فلسفيّا أيضا القراءات ذات النّزعة الإنسانيّة أي القريبة من القيميّة، وما بعد الإنسانيّة أو المركزيّة، أو القراءات الكونيّة والسّننيّة للنّصّ التّأريخيّ، ومع تشعب هذا الاتّجاه وتعقده أيضا، إلا أنّه كالفريق الأول، فهناك من اللّاهوتيين ممّن اشتغل عليه قديما، ويشتغلون عليه حديثا.
وأمّا الاتّجاه الثّالث وهو الاتّجاه اللّاهوتي المحض، أي المنطلق من الكتب المقدّسة، والّتي يرى ما ورد فيها حق مطلق، وهي الأساس لقراءة التّأريخ في جانبه السّيريّ، خصوصا ما يتعلق بأصل الخلق، ونشأة الحياة البشريّة من آدم وحتّى اليوم، وما يتبع ذلك من قصص الأنبياء والقدّيسين والصّالحين، فيجعلونها أساسا لما في غيرها، كقصّة الطّوفان في التّوراة والقرآن أصلا لما جاء في ملحمة جلجامشّ، ومن هذا الفريق من يعطي مساحة للمسكوت عنه، أي ما لم يرد في النّصّ المقدّس، أو رد ما يشير إليه وترك تفصيلاته الجزئيّة، ومنهم ينظر إلى ذلك كلّه بريبة، كما أنّ المتأخر من النّصوص المقدّسة ذاتها من تنظر بريبة إلى المتقدّم من ذات لاهوتيّتها، كالقصص الإسرائيلية، ومدى قبولها عند المسلمين مثلا، من هنا كانت نظريّة التّصديق والهيمنة كما عند بعض القرآنيين.
كما توجد اتّجاهات أخرى في التّعامل مع الرّوايات والقصص والأساطير التّأريخيّة متشابكة مع الاتّجاهات السّالف ذكرها، كالرّوايات والمسرحيات والدّراما الأدبيّة، وكما عند الكتابات التّربويّة وقصص الأطفال وغيرها، وهذه ليست بثقل تلك من حيث قراءة التّأريخ وتفكيكه، إلا أنّها مرتبطة به لا يكاد تنفصل عنه.
هذه الاتّجاهات عموما ينبغي التّعامل معها بانشراحة، ولا ينبغي محاكمتها في زاوية لاهوتيّة ضيقة؛ لأنّ العقل المعرفيّ اليوم لم يعد ذلك العقل المنحصر في زاوية معرفيّة معينة، بل أصبح منفتحا على الآخر بحسناته وسيئاته، مدركا عمليّة التّقابس والتّحوير والإضافة والنّقيصة في تمدد الرّواية التّأريخيّة وانتشارها، كما أنّ علم الآثار تطوّر بشكل كبير جدّا، واقترب من القراءات القطعيّة، يقول مثلا عالم الآثار البحرينيّ سلمان المحاريّ أنّ “علم الآثار بشكل عام علم يهتم بدراسة البقايا الماديّة المنقولة وغير المنقولة من عظام وفخار وزجاج وأحجار ومباني وأدوات وغيرها الّتي تركها الإنسان في الفترات السّابقة منذ تكوّن الحضارات وما قبل ذلك، ليدرسها ويعيد تركيب الحياة اليوميّة والأنشطة الّتي كانت تمارس في تلك الفترة”، “وأمّا من حيث الدّقة فهو دقيق؛ لأنّه يستعين في تفسير المواد بجميع العلوم المساعدة له من الهندسة والكيمياء والبيئة والمواد العضويّة”، “لكن ليس بالمطلق أو بالشّريطة أن يكون علم الآثار قرينة لإثبات صحة النّصوص الرّوائيّة والتّأريخيّة أو إثبات بطلانها، فربما الاختلاف يعود إلى أماكن اندثرت وليس لها وجود، أو يعود إلى الوثيقة ذاتها نتيجة النّقولات، وأحيانا الآثار تضيف معلومات غير موجودة في الوثائق التّأريخيّة، وأحيانا تصدّق هذه الوثائق، فبينهما في الجملة تكامل”.
وأمّا من حيث تأثير المجال العلميّ في قراءة التّأريخ يقول عالم الفيزياء العمانيّ حيدر اللّواتيّ مثلا: “كان يعتقد الإنسان أنّ السّفر في الماضي الموغل في القدم، وكشف أحداثه يتمّ من خلال ما ورد من إشارات في الكتب المقدّسة، وتفاصيل وردت في الكتب التّأريخيّة، فهما السّبيلان الوحيدان لمعرفة الماضي السّحيق، لكنّه لم يخطر على باله أن يتعرّف على الماضي السّحيق من خلال الذّرات المشعة، فلقد تبين أنّ غاز ثاني أكسيد الكربون يحتوي على نسبة من الكربون المشع، والّذي يجد طريقه إلى أجسام الكائنات الحيّة، وعندما تموت يثبت تركيز الكربون المشع، ويقل مع مرور الزّمن، وبتحديد تركيز الكربون المشع في عيّنة أخذت من رفاة الكائن الحيّ يمكننا تحديد متى كان ذلك الكائن حيّا، وتعدّ دراسة التّأريخ باستخدام الكربون المشع من أكثر الطّرق موثوقيّة، فهي لا تتأثر بالسّياسات وأيدولوجيّات المؤرخ، ولا تخضع لضغوط اجتماعيّة، ويمكن استخدام الكربون المشع بطريقة مثاليّة لدراسة آخر خمسين ألف سنة، بينما يعدّ التّأريخ باليورانيوم والثّوريوم والرّصاص الطّريقة الأكثر فائدة بالنّسبة لآثار أقدم من ذلك، ويرجع الفضل في هذا الاكتشاف إلى العالم ليبّي [ت 1980م]، والّذي حصل على إثره على جائزة نوبل، وبذلك لم تعد الوثائق التّأريخيّة السّبيل الوحيد لدراسة التّأريخ، فتقدير عمر الأرض مثلا مبنيّ على تحليل عيّنات لصخور في غرب أستراليا تحتوي على بلورات لعنصر الزّرقونيوم ، وبداخلها كميّات من اليورانيوم المشع، وتمّ تقدير عمر هذا الصّخور بأربعة فاصل أربع بليون سنة”.
لهذا قراءة التّأريخ اليوم كما تعددت مناهج ذلك؛ أيضا تعددت مصادره، وزاحمت الرّواية التّأريخيّة التّراثيّة، والّتي ارتبطت عادة بالسّياسة والأيدلوجيا والتّحزبات الاجتماعيّة؛ زاحمتها مناهج علميّة معاصرة، أكثر دقة، وبعيدة عن المؤثرات السّلبيّة في قراءة النّصّ التّأريخيّ، ولم يقتصر فقط عن الرّواية التّأريخيّة؛ بل يمتدّ إلى متعلقات ذلك كنشّأة الكون، وقصّة الخلق، وعمر الإنسان، وقضيّة الأنساب وغيرها.
فلا ينبغي والعلم قد تطوّر أن ينكمش التّأريخ في زاوية ضيقة، ومن يتوسع فيه يواجه لاهوتيّا بدعوى الإلحاد أو الكفر أو التّشكيك في إيمانه، يل يجب فتح الحريّة في ذلك، ليتمكن العقل من السّير والإبداع والنّظر والكشف، مع حريّة وسعة القراءات المختلفة، فلا إبداع بدون حريّة ومساحة معرفيّة واسعة مفتوحة، فإذا حدّت الحريّة في هذا ضاق العلم عن الكشف والإبداع والنّتاج.