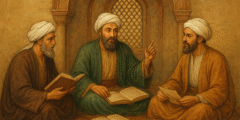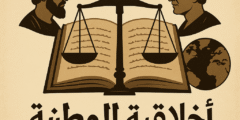جريدة عمان 1443هـ/ 2022م
يتصوّر بعضهم لمّا نتحدّث عن الأنسنة – كما في مقالاتنا السّابقة – أنّها معارضة للأديان، وملغية لها، ومبطلة لشرائعها، وحاكمة عليها، كما يتصوّر بعضهم لمّا نجعل الأديان في خانة الهوّيّة المقابلة للماهيّة باعتبار أساس قيم الأنسنة، كأننا أخرجناها عن دائرتها اللّاهوتيّة من حيث الأصالة، وجعلناها محكومة بالأنسنة من حيث الحاكميّة.
هذا التّصوّر يكون في بعض أجزائه صحيحا حال دراسة القضيّة شموليّا، لكن تعميمه خاطئا، فهناك عشرات من اللّاهوتيين العلماء من كافّة الأديان ممّن يرى ذلك، مع انطلاقته اللّاهوتيّة العلويّة.
صحيح أنّ المسألة ليست بذات البساطة حتّى نختصرها في مقال سريع، ولكن كما أسلفت سابقا في مناسبات مختلفة أنّ الأنسنة – في نظري – لا تخرج عن مدارس ثلاثة: مدرسة الأنسنة من حيث المرجعيّة (الحاكميّة)، ومدرسة الأنسنة من حيث النّصوص الإجرائيّة (الظّرفيّة التّأريخيّة)، ومدرسة الأنسنة من حيث التّاويل (العلليّة).
أمّا مدرسة الأنسنة من حيث المرجعيّة (الحاكميّة) فهذه ترى الحاكميّة – إن صح التّعبير – لما توصل إليه الاجتهاد الإنسانيّ، فبه يدار العالم اليوم، ومن هذه المدرسة العلمويون الّذين يرون المدار للعلم، وخصوصا العلم التّجريبيّ، وهذا الفريق قد يرى الأديان عبارة عن ثقافات وخصوصيّات هوّيّاتيّة لا يتصارع معها، ومنهم من دخل في صراع معها، إلا أنّهم يتفقون جميعا أنّ الشّأن العام لإدارة المجتمع الإنسانيّ من جهة، وإدارة الدّولة من جهة ثانية، هو شأن إنسانيّ مطلق تحت مظلّة الاجتهاد البشريّ.
ولا يعني أنّه لا يوجد لاهوتيون لا يرون هذا الرّأي، فهناك من اللّاهوتيين من يؤمن به، إمّا تغليبا لنزعة القيم الإنسانيّة في التّعامل مع مطلق الأديان (النّصّ الأول، والنّصّ التّأريخيّ، والاجتهاد الزّمكانيّ)، أو لأنّ الأديان في جملتها دربة في إنزال مصاديق القيم حسب تطوّر المجتمع البشريّ، وأمّا اليوم فاستطاع الإنسان (عقليّا وعلميّا) كشف السّنن، ومنها سنن الاجتماع البشريّ، والّتي أودعت في هذا الكون، فهو قادر على إدارة شأن ذاته بنفسه، دون تصارع مع النّاس، وحرّيّاتهم في أديانهم وممارسة طقوسهم، ومن هنا ولدت نظريّات في إدارة الشّأن العام، وعلى رأسها العِلمانيّة، بكسر العين من العلم، أي الفصل بين العلم والاجتهاد الإنسانيّ في إدارة الشّأن العام، وبين حفظ النّاس في تدينهم كخصوصيّات، أو العَلمانيّة بفتح العين من العالم، وهذا لا يختلف عن الأول بكثير من حيث الغاية، وإن كانت هناك مدارس للعلمانيّة سبق الحديث حولها في جريدة عُمان في مقالة “الاتّجاهات الخمس في مفهوم الدّولة العلمانيّة في العالم الإسلاميّ”.
وأمّا مدرسة الأنسنة من حيث النّصوص الإجرائيّة (الظّرفيّة التّأريخيّة)، فهذه ترى في الأديان النّسبة الأكبر فيها إمّا قضايا غيبيّة ماورائيّة (إلهيّة ومستقبليّة: أحداث اليوم الآخر مثلا)، أو قصص وأحداث ماضويّة، أو القيم ومصاديقها (الأخلاق)، أو الشّرائع (النّصوص الإجرائيّة)، والنّصوص الإجرائيّة في الأديان قليلة جدّا من حيث نسبة النّصوص الأخرى.
وهذي المدرسة تلتفت فقط إلى النّصوص الإجرائيّة في الجملة، فترى بعضها ذات نزعة خصوصيّة (الطّقوس وتواصل الإنسان مع خالقه)، وتشترك الأديان جملة في الخطوط العامّة مع بعضها كالصّلاة والدّعاء مع اختلاف طرقها ومصاديقها من دين إلى آخر، كما أنّها متقابسة من بعضها، ومتطوّرة من جهة أخرى أيضا، ومنها نصوص لم تخرج عن مصاديق الأخلاق في التّعامل البشريّ، وتبقى نصوص قليلة متعلقة بالشّأن العام، وعلاقة الإنسان مع الآخر من ذات الجنس.
لهذا مدار هذه المدرسة حول الجزئيّة الأخيرة أي ما يتعلق بالشّأن العام، وعلاقة الإنسان بالآخر، مثل قضايا الحكم والحدود والبيوع ونحوها، بمعنى أنّ النّص الإجرائيّ هنا مرتبط بتاريخيّة النّص، “والقول بتاريخيّة النّص يعني أنّ النّص حادث في زمن معين، ومتعلق ببيئة معينة، وأحداث معينة، فهو يعالج أوضاع تلك المرحلة الزّمنية من عمر التّاريخ وأحداثه، وهو ليس معنيا بالأحداث والأوضاع الّتي بعد تلك المرحلة الزّمنيّة” [النّعيميّ: محمّد سالم؛ القراءة الحداثيّة للنّص القرآنيّ وأثرها في قضايا العقيدة، ص: 108].
ولهذا تغلّب هذه المدرسة القيم الماهيّة (مطلقة ومضافة) من حيث التّعامل مع النّصّ الإجرائيّ، وتنظر إلى الأنسنة من هذه الزّاوية خصوصا، بيد أنّه لا علاقة لها وإلغاء الأديان – كما يصّوّر البعض – من حيث الجملة، فالعديد من اللّاهوتيين يميلون إلى هذه المدرسة من كافّة الأديان، وهي منتشره خصوصا في القراءات اليهوديّة والمسيحيّة، كما لها بعض الانتشار البسيط في القراءات الإسلاميّة.
أمّا مدرسة الأنسنة من حيث التّأويل (العلليّة)، فهذه مدرسة قديمة؛ لأنّ النّصّ بذاته متحرك، وكونه متحركا فهو مفتوح قابل للتّأويل، وبه يدخل الإنسان في التّعامل مع النّصّ حسب فهوماته من جهة، وحسب الزّمكانيّة من جهة ثانية، لهذا نرى التّعدديّة في الاجتهاد الإنساني في تعامله مع النّصّ الدّينيّ، كما نرى التّناقض والاختلاف من حيث الإلزاميّة (الأحكام التّكليفيّة)، أو مع حيث الوضع (الأحكام الوضعيّة)، أو من حيث العلليّة والأقيسة، أو من حيث تأثير الزّمكانيّة، ولهذا ولدت في الدّين الواحد مذاهب متعددة، ولو كان النّص ساكنا وجامدا وشاملا للزّمكانيّة، ومطلقا زمنيّا؛ لما ولدت هذه المذاهب المختلفة، ولما وجدت هذه المصنّفات الفقهيّة المليئة بالاجتهاد الإنسانيّ، وهذا دليل واضح لحضور الأنسنة ليس في الأحكام الإجرائيّة فحسب؛ بل حتى توسع اللّاهوت من حيث الأسماء والصّفات مثلا.
وكما يرى أجنس تسهير [ت 1921م] عند جميع الأديان “كلّ يبحث عن رأيه في هذا الكتاب المقدّس، وكلّ واحد فيه ما يبحث عنه” [المذاهب الإسلاميّة في تفسير القرآن، ص: 9]، ويرى حسن حنفي [معاصر] تأثير حتّى إنسانيّة اللّغة في التّعامل مع النّصّ، “أن تكون اللّغة إنسانيّة لا تعبر إلا عن مقولة إنسانيّة كالنّظر والعمل والظّنّ واليقين والقصد والفعل والزّمان والباعث، فهي كلّها ألفاظ تشير إلى جوانب من السّلوك الإنسانيّ الواقع في الحياة اليوميّة يقابلها كلّ إنسان ويستعملها مهما كانت عقيدته أو مذهبه أو تياره الفكريّ” [التّراث والتّجديد: موقفنا من التّراث القديم، ص: 122].
لهذا في الدّين الإسلاميّ من الابتداء مثلا تشكلت مدرسة أهل الرّأي، وهو توسع في التّعامل مع النّص إنسانيّا بصورة أوسع من المدرسة الأثريّة الحرفيّة الظّاهريّة، ولهذا اضطر المسلمون إلى وضع علم العلل والدّلالات، وحضور عقلنة النّص من فترة مبكرة، كما استفادوا من المنطق الأغريقيّ في الأقيسة لتوسع نوازل الزّمكانيّة ومآلاتها.
فحضور الأنسنة مع النّصّ الدّينيّ حضور قديم؛ لأنّ النّصّ مرتبط بالإنسان، وجاء لغاية الإنسان، ولهذا استخرجت منه مصاديق لم تخرج عن المصالح الخمس: الدّين والنّفس والعقل والنّسل والمال، وهي مقاصد غائيّة إنسانيّة، إلا أنّ العالم اليوم توسع أكبر من قيم الماهيّة، وعلاقتها بالنّص، ولهذا كانت المدرستان الأولى والثّانية في نظري، إلا أنّه لا يمكن حصر الأنسنة في المفهوم الشّيلريّ [ت 1805م] أي ” الإنسان هو المقياس لكلّ الأشياء” أي بالمفهوم الحرفيّ.
ولمّا ندرك تصوّر مدار النّصّ من حيث نزعة الأنسنة من جهة ومصدريته اللّاهوتيّة من جهة ثانية، وما نتج عن ذلك من مدارس؛ ندرك تصوّر جعل الأديان في خانة الهوّيّة المقابلة للماهيّة باعتبار أساس قيم الأنسنة، وليس بالشّريطة هنا نزع المصدريّة اللّاهوتية من حيث النّصّ الأول في الدّين خصوصا كما يصوّره البعض، لأنّ المدار البسيط في هذا أنّ الإنسان يكسب دينه ومذهبه بعد ولادته، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمسلمانه، بيد أنّه يولد على ماهيّة إنسانيّة واحدة (أي الفطرة)، لا يختلف ماهيّا عن غيره من البشر، ويبدأ الاختلاف الكسبيّ بعد الولادة من الأسرة وحتّى المجتمع والبيئة، مرورا بالمعرفة والتّأمل، فيتمايز عن غيره من البشر في لغته ودينه ومذهبه وأعرافه وتقاليده وتوجهه الفكريّ والسّياسيّ والاجتماعيّ مثلا.
وأخلص من هذا أنّ هذا الحدّ قد يكون كافيا لمعرفة زوايا القضيّة من حيث الرّابط بين الأنسنة ولاهوتيّة الأديان، فالنّزعة الإنسانيّة حاضرة في الأديان خصوصا في زواياها الإجرائيّة، وعليه لا ينبغي التّعامل مع مثل هذه المواضيع بحساسيّة مفرطة، خصوصا أصبحت مثل هذه الدّراسات هي الحاضرة اليوم، وآلات التّعامل مع النّص وتفكيكه بذاته متقدّمة أيضا، فمداولتها معرفيّا لا يقل ضرورة أيضا، بيد أنّ الأحكام المسبقة لن تؤثر في المعرفة بقدر ما تتجاوز من ينكمش على نفسه في عالم أصبحت المعرفة تتضاعف وتتطوّر بشكل كبير، ومع حريّة مداولة ذلك؛ إلا أنّه من حق كلّ دين ومسلك وفكر تقديم رؤيته في ذلك، لتتدافع المعرفة وتتهذب في شكلها الإنسانيّ الطّبيعيّ.